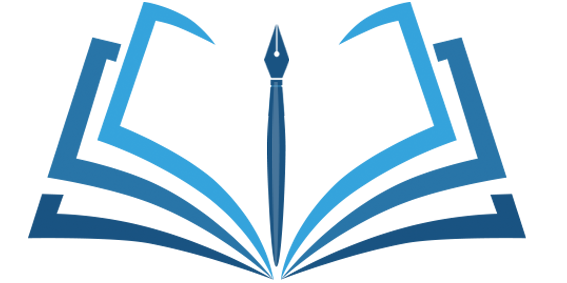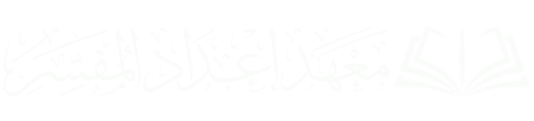أصول التفسير البياني
القسم الثاني
الدرس التاسع: (3) الحذف والذكر
4 May 2020
الدرس التاسع: دلالات تراكيب الجمل
المبحث الثالث: الحذف والذكر
عناصر الدرس:
● أهمية مبحث الحذف والذكر.
● أنواع الحذف وأغراضه:
- النوع الأول: حذف المتعلّق.
- النوع الثاني: حذف جزء من تركيب الجملة.
- النوع الثالث: الاحتباك.
- النوع الرابع: حذف الإيجاز.
● تنبيه.
● أغراض الذكر.
● أمثلة من أقوال العلماء:
- المثال الأول: معنى الحذف في قول الله تعالى: {ولذكر الله أكبر}.
-
المثال الثاني: الحذف في قول الله تعالى: {ولما ورد ماء مدين وجد
عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى
إلى الظل}.
- المثال الثالث: حذف جواب القسم في قول الله تعالى: {ص . والقرآن ذي الذكر}.
- المثال الرابع: الذكر في قول الله تعالى: {قل هو الله أحد . الله الصمد}.
● تطبيقات الدرس التاسع.
عبد العزيز بن داخل المطيري
أهمية مبحث الحذف والذكر
من المباحث المهمة في التفسير البياني مبحث الحذف والذكر، وقد عني به علماء البيان عناية بالغة.
- قال عبد القاهر الجرجاني:
(هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى
به ترك الذكرِ أفصحَ من الذكر، والصمتَ عن الإفادة أزيدَ للإفادة، وتجدك
أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تُبِنْ)ا.هـ.
والأصل في البلاغة حذف ما يدلّ الكلام على ذكره إلا لمرجّح، وللحذف
والذكر أنواع وأغراض يستدلّ بها اللبيب على معانٍ لطيفة، وأوجه بليغة،
تكشف له عن فوائد الإتيان بالذكر والحذف في مواضعهما اللائقة بهما،
والتي لا يحسن فيها غير ذلك.
عبد العزيز بن داخل المطيري
أنواع الحذف وأغراضه
وما يُحذف من الكلام على أنواع:
النوع الأول: حذف المتعلّق
والمتعلّق هو ما تعلّق به الكلام، ولو كانت الجملة تامة فيما يظهر؛
ولذلك فإنّ المتعلق البياني عند البلاغيين أعم من المتعلق الإعرابي عند
النحاة.
فإذا قلت: أكل زيد؛ كانت الجملة تامة إعرابياً، لكن قد يتبادر إلى الذهن سؤال عن المأكول ما هو؟ وهذا هو المراد بمتعلّق الأكل هنا.
وفي قول الله تعالى: {اقرأ باسم ربّك الذي خلق} يتبادر إلى الذهن سؤال عن متعلّق القراءة، ومتعلّق الخلق، أي ماذا يقرأ؟ وخلق ماذا؟
ولعلماء التفسير والبيان عناية بالمتعلقات لأنها معينة على فهم المعنى، وإدراك لطائف الحذف وأغراضه.
ولحذف المتعلّق أغراض منها:
1: الدلالة على العموم؛ كما في قول الله تعالى: {الذي خلق} ليعمّ جميع المخلوقات، وحذف متعلّق الاستعانة في قوله تعالى: {وإياك نستعين} ليعمّ جميع الأمور التي يحتاج العبد فيها إلى عون.
2: وصرف الاشتغال عن المتعلَّق إلى ما سيق الكلام لأجله كما في قول الله تعالى: {وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله} حذف متعلق العلم لأن المقصود نفي العلم النافع عنهم، لا نفي علمهم بشيء مخصوص.
وقوله تعالى: {حتى يُعطوا الجزية عن يد} حذف المفعول الأول لعدم تعلّق المراد به.
وقوله تعالى: {وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنّهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم} حذف المفعول الأول ليسألون لعدم تعلّق المراد به.
وفي قول الله تعالى: {ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان} حذف متعلق السقي والذود لأن الغرض لا يتعلق بهما، ولئلا ينصرف الذهن إليهما.
3: والجهل به كما في قول أصحاب الكهف: {ينشر لكم ربكم من رحمته}
، حذف متعلّق النشر، واكتفى بذكر نوعه وأنه من رحمة الله لجهلهم به مع
إحسان ظنّهم بالله، وهذا الغرض لا يكون في كلام الله تعالى إلا حكاية عن
بعض خلقه.
4: والتعظيم والتفخيم،كما في حذف متعلّق الجزاء في قول الله تعالى: {وسنجزي الشاكرين}.
5: والتشويق، كما في حذف متعلق القراءة في قوله تعالى: {اقرأ} ، وحذف متعلق الشغل في قوله تعالى: {في شغل فاكهون}.
6: والتنزيه، كحذف متعلقّ يطمع في قوله تعالى: {فيطمع الذي في قلبه مرض}
7: والمدح، كما في حذف متعلق السبق في قوله تعالى: {والسابقون السابقون}.
8: والتحقير والتهوين، كحذف متعلّق الصنع في قوله تعالى: {إنما صنعوا كيد ساحر}.
9: وكثرة الاستعمال، كما في حذف متعلق الإيمان والكفر في قوله تعالى: {الذين آمنوا} وقوله: {الذين كفروا} في مواضع كثيرة.
10: والإيجاز لظهور المراد ؛ كما في قوله تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين (23)} حذف متعلق الصدق لدلالة ما قبله عليه، وحذف متعلق الامتراء في قوله تعالى: {فلا تكونن من الممترين}
فهذه أشهر فوائد حذف المتعلق، وله فوائد أخرى، وتأمّل هذه المتعلقات وفوائد حذفها يفتح لطالب العلم باباً من أبواب فهم القرآن.
النوع الثاني: حذف جزء من تركيب الجملة
كحذف المبتدأ، أو الخبر، أو عامل النصب، أو المفعول، أو المضاف، أو المضاف إليه، أو جواب الشرط، أو جواب القسم.
1: فحذف المبتدأ، كما في قول الله تعالى: {صم بكم عمي فهم لا يرجعون} صمّ خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: هم صمّ.
وقوله تعالى: {من عمل صالحاً فلنفسه} أي فعمله لنفسه.
وقوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} أي: فهم إخوانكم.
وقوله تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} أي: فالإساءة لها على أحد القولين في الإعراب.
ويكثر حذف المبتدأ بعد القول كما في قول الله تعالى: {قال فرعون وما ربّ العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين} أي هو ربّ السموات والأرض.
وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} أي هي أساطير الأولين.
وقوله تعالى: {قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض} أي: نحن خصمان.
2: وحذف الخبر، كما في قول الله تعالى: {أفمن زيّن له عمله فرآه حسناً} أي: كمن ليس كذلك.
وقوله تعالى: {أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت}
وقوله تعالى: {أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه}.
3: وحذف العامل كما في قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحاً } أي: أرسلنا، وقوله تعالى: {وامرأته حمالةَ الحطب} لفظ "حمالةَ" منصوب على التخصيص الذي يُراد به الذمّ بفعل محذوف تقديره أعني.
4: وحذف المفعول، وهو كثير شائع.
قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: (ومثال
ذلك قول الناس: "فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع"، وكقولهم:
"هي يعطي ويجزل، ويقري ويضيف"، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في
نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعرض لحديث المفعول،
حتى كأنك قلت: "صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد،
وأمر ونهي، وضر ونفع"، وعلى هذا القياس. وعلى ذلك قوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}
المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى: {هو الذي يحيي ويميت}
وقوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا}
وقوله: {وأنه هو أغنى وأقنى}
المعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة والغَناء والإقناء.
وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت
المعنى في نفسه فعلا للشيء، وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه، أو لا يكون
إلا منه، أو لا يكون منه، فإن الفعل لا يعدى هناك، لأن تعديته تنقُض
الغرَضَ وتغيّر المعنى.
ألا ترى أنك إذا قلت: "هو يعطي الدنانير"،
كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه، أو
أنه يعطيها خصوصا دون غيرها، وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله
الإعطاء، لا الإعطاء في نفسه، ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان
منه إعطاء بوجه من الوجوه، بل مع من أثبت له إعطاء، لكن لم يثبت إعطاء
الدنانير؛ فاعرف ذلك، فإنه أصل كبير عظيم النفع)ا.هـ.
وله أغراض أخرى تقدّم ذكر بعضها.
5: وحذف المضاف، كما في قول الله تعالى: {قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود} ، وقد أخطأ من أعرب النار بدل اشتمال من الأخدود.
- قال أبو القاسم السهيلي: (والعجب كلّ العجب من إمام صنعة النحو في زمانه، وفارس هذا الشأن ومالك عنانه، يقول في كتاب " الإيضاح " في قوله سبحانه: {النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ)} إنها بدل من {الأخدود} بدل الاشتمال، والنار جوهر وليست بعرَض، ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود، وليس فيها شرط من شروط بدل الاشتمال.
وذهل أبو علي عن هذا، وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال: "قتل أصحاب الأخدود، أخدود النار ذات الوقود"؛ فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة)ا.ه.
ومِن النحاة والمعربين مَن توسّع في دعوى حذف المضاف، كما قيل في قول الله تعالى: {ولكن البر من آمن}
قال بعض المفسّرين، التقدير: ولكن البرَّ برّ من آمن، لأن البرّ مصدر
معنوي، ومَن اسم موصول للعاقل؛ والأصل أن يخبر عن المصدر بمصدر مثله.
وهذا التوجيه قد يكون مقبولاً من جهة التفسير الذي يراد به تقريب
المعنى، وأما من جهة صنعة البيان فهو خروج عن قصد البلاغة، وتفويت لغرض
الحذف الذي جيء بهذا التركيب قصداً إليه، وقد اختلف العلماء في توجيه هذا
الحذف، والأظهر أن الإخبار عن المصدر بالاسم الموصول على جهة المبالغة
في الثناء، كما يقال للمرأة العفيفة هي الطهر والعفاف، مبالغة في
الثناء على طُهرها وعفافها.
وقالت الخنساء في وصف حزنها على أخيها صخر، وتشبيه نفسها ببقرة وحش فَقَدَت وَلدَها:
فما عَجولٌ على بوٍّ تطيف به ... لها حنينان: إعلانٌ وإسرارُ
ترتع ما غفلت حتّى إذا ادّكرت ... فإنّما هي إقبالٌ وإدبارُ
يوماً بأوجد منّي حين فارقني ... صخرٌ وللدّهر إحلاءٌ وإمرارُ
فأخبرت عن بقرة الوحش أنها إذا ذكرت ولدها وأخذها الحزن بقولها: (فإنما هي إقبال وإدبار) والإقبال
والإدبار مصدران، وإنما أرادت أنها من شدة حزنها تأخذ في الإقبال
والإدبار لا يقرّ لها قرار حتى يكون هذا الحال منها كأنه سمة بارزة من
سماتها، واسم تستحقّ أن تُسمّى به.
ومن هذا الباب تسمية بعض الأعلام بالمصادر كما يقال: سعد، وبشر، وسَهْل، وحَزن، وهذه أوصاف سموا بها لملاحظة معانيها.
فقول الله تعالى: {ولكن البرّ من آمن بالله ... } الآية
؛ يدلّ المتفكّر فيه على أنّ القائمين بأعمال البرّ المذكورة فيها قد
صاروا كأنهم عنوان البرّ وآيته الدالّة عليه؛ فكأنهم هم البرّ.
وكثيراً مما يُدّعي فيه حذف المضاف يقع في تقديره تقصير عن المعنى البياني الرفيع للقرآن، وإن كان فيه تقريب شيء من المعنى للذهن.
6: وحذف المضاف إليه، كما في قول الله تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} ، وقوله تعالى: {ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} ، وقوله تعالى: {أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}. أي: أي اسم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حذف المضاف إليه يقارنه قرائن؛ فلا بدّ أن يكون مع الكلام قرينة تبيّن ذلك).
7: وحذف جواب الشرط، كما في قول الله تعالى: {ولو أنّ قرآنا سيرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله الأمر جميعاً} أي لكان هذا القرآن.
وقوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنّ الله تواب حكيم}.
وحذف جواب الشرط في مثل هذه المواضع أوقع في النفس، وأعظم أثراً لتذهب النفس في جوابه كلّ مذهب ممكن.
8: وحذف جواب القسم، كما في قول الله تعالى: { والنازعات غرقاً } الآيات، فيكون من صفات المقسم به ما يُعرف به غرض القسَم ويستغنى به عن التصريح بجوابه.
- قال ابن القيم رحمه الله: (وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيراً كقوله تعالى:{كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ} وقوله: {وَلَوْ
أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ
الْأَرْضُ} {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة} {ولو ترى إذا فزعوا
فلا فوت} {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ}.
ومثل هذا حذفه من
أحسن الكلام؛ لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولاً عظيماً؛ فليس في
ذكر الجواب زيادة على ما دلَّ عليه الشرط، وهذه عادة الناس في كلامهم
إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم:
لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا، ومنه قوله تعالى {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} فالمعنى في أظهر الوجهين لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة والجواب محذوف ثم قال {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} كما قال تعالى {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ} {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ} أي لو ترى ذلك الوقت وما فيه)ا.هـ.
النوع الثالث: الاحتباك
وهو حذف جزء من الجملة يدلّ عليه الجزء المذكور في الجملة المقابلة، مع العكس، وقد شرحته في كتاب "طرق التفسير" وقلت فيه: (هو
افتعال من الحبك، وهو شدّة الإحكام في حسن وبهاء، وكلّ ما أُجيد عمله
فهو: محبوك، وتقول العرب: فرس محبوكة إذا كانت تامّة الخلق شديدة
الأسر، ومنه يقال: لشدّ الإزار وإحكامه: الاحتباك.
والمراد بالاحتباك عند أهل البديع أن
يقابَل بين جملتين مقابلة غير متطابقة؛ فيحذف من الجملة الأولى ما
يقابل الثانية، ويحذف من الثانية ما يقابل الأولى، فتدلّ بما ذكرتَ على
ما حذفتَ، ويحتبك اللفظ والمعنى بإيجاز بديع.
ولذلك سمّاه بدر الدين الزركشي (ت:795 هـ) "الحذف المقابَلي"، وهو من أجود أنواع البديع المعنوي، وله أمثلة كثيرة في القرآن:
منها: قول الله تعالى: {أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ}،
فدلّ على الاحتباكِ في هذهِ الآيةِ المقابلةُ بين جزاء وحال،
والمتبادر إلى الذهن أن يُقابَل بين جزاء وجزاء، وأن يقابل بين حال
وحال؛ فالخروج عن المتبادر لا يكون إلا لفائدة بلاغية؛ فكان تقدير
الكلام على هذا المعنى: أفمن يأتي خائفاً يوم القيامة ويلقى في النار
خير أمّ من يأتي آمناً ويدخل الجنّة.
والناظر في أمثلة الاحتباك التي يذكرها بعض المفسّرين وأهل البديع يتبيّن له إمكان تقسيم الاحتباك إلى درجتين:
- احتباك ثنائي التركيب، ومثاله ما تقدّم.
- واحتباك ثلاثي التركيب، وهو بديع جداً، ومن أمثلته قول الله تعالى في سورة الفاتحة: {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}
ففي هذه الآية نوع عزيز من أنواع الاحتباك أشار إليه ابن عاشور رحمه الله.
وشَرْحُ كلامِه: أنّ التقابلَ في هذه الآية ثلاثي التركيب ففيه:
1. مقابلة بين الإنعام والحرمان.
2. ومقابلة بين الرضا والغضب.
3. ومقابلة بين الهدى والضلال.
وتقدير الكلام بما يتّضح به هذا المعنى: {اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم} فهديتَهم ورضيت عنهم {غير المغضوب عليهم} الذين حُرموا نعمتك وضلّوا، {ولا الضالّين} الذين حُرموا نعمتك وغضبت عليهم.
وقد اعتنى
بهذا النوع جماعة من العلماء كبدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في
علوم القرآن، وبرهان الدين البقاعي في "نظم الدرر"، وجلال الدين السيوطي
في "التحبير" و"الإتقان" و"معترك الأقران"، والألوسي في "روح
المعاني"، وابن عاشور في "التحرير والتنوير"؛ وأفرده البقاعي بمؤلّف
سمّاه "الإدارك لفنّ الاحتباك"، وأُفردت فيه رسائل علمية في هذا العصر)ا.هـ.
ومن أمثلته أيضاً: قول الله تعالى: {قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة}
والتقدير: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت.
النوع الرابع: حذف الإيجاز
وهو حذف بعض المفردات أو الجمل لدلالة ما ذكر عليها من غير أن يقع خلل
في بيان المعنى، بل يزيده الحذف حسناً وبهاءً، وقوّة سبكٍ، ولذلك
أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها:
1: قول الله تعالى: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا} أي: يقولان: ربنا تقبل منا.
2: وقوله تعالى: { وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا}
3: وقوله تعالى: { فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } ، أي: فيقال لهم.
4: وقوله تعالى:
{ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا} أي فضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً.
5: وقوله تعالى: { فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36)} أي: فذهبا إليهم؛ فبلغاهم رسالة الله؛ فكذبوهما فدمرهم الله تدميراً.
عبد العزيز بن داخل المطيري
تنبيه:
وقد ذكر بعض العلماء أنواعاً أخرى من الحذف سموها: الاكتفاء والاقتطاع والاختزال، ولم
أذكرها لأن كثيراً من الأمثلة التي ذكرت فيها لا تُسلّم، وتوجيه ما
ادّعي فيه الحذف يحتاج إلى بسط وتطويل أخشى أن يخرجنا عن المقصود.
ومما ينبغي أن يُنبَّه عليه أيضاً أن بعض المفسرين والبلاغيين توسّعوا
في دعوى الحذف حتى ذكروا أمثلة كثيرة توّهموها من الحذف وليست منه،
ومن ذلك:
1: قول ابن قتيبة في قول الله تعالى: {إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه} قال: (أي: يخوّفكم بأوليائه كما قال سبحانه: {لينذر بأساً شديداً من لدنه}أي: لينذركم ببأس شديد}).
وما ذكره إنما هو تفسير ببعض لازم المعنى،
وليس هو المعنى نفسه، بل فيه قصر للمعنى البياني للآية، ومعنى الآية
أوسع مما ذكر، وتقرير ذلك:أن فعل التخويف قد يُعدّى بمفعول واحد وقد
يعدّى بمفعولين:
- فتعديته بمفعول واحد كقولك: خوّفتُ زيداً فخاف.
- وتعديته بمفعولين كقولك: خوّفتُ زيداً الأعداءَ فخافهم.
فالمفعول الثاني بيان للمخوف منه.
والآية فيها حذف للمفعول الأوّل، ويصحّ أن يقدّر في الإعراب: يخوّف الناسَ أولياءَه.
وهذا التخويف إنما يكون بتعظيم شأن أوليائه وتهويل شدّة بطشهم حتى يخافوهم.
ومن التصريح بذكر المفعولين للتخويف قول عروة بن الورد:
أرى أمَّ حسان الغداة تلومني … تخوفني الأعداءَ والنفس أخوف
وقول عنترة: بكَرتْ تخوفني الحتوفَ كأنني … أَصْبحْتُ عن غَرَض الحتوفِ بِمَعْزِل
ويصحّ أن يحذف المفعول الأول فيقال: أتى زيدٌ يخوّف الأعداءَ ؛ أي يُعظّم شأنهم وخطرَهم حتى يخافهم الناس.
وهذا هو معنى قول الله تعالى: {إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه} أي يعظّم شأنهم وخطرهم حتى تخافوهم {فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}، فحذف المفعول الأوّل، ولحذف المفعول لطائف بيانية:
منها: أنّ ذلك لإرادة العموم فيدخل فيه تقدير:
"يخوّفكم أولياءه" كما قدّره بعض المفسرين، ويدخل فيه غير المؤمنين من
المنافقين واليهود ومشركي العرب؛ فالشيطان مجتهد في تخويف شأن أوليائه
ليخافهم المؤمنون ويخافهم المستضعفون من المشركين فيطيعوهم؛ ويخافهم
غيرهم فيتبعوا خطواته؛ فكان في حذف المفعول زيادة في المعنى.
ومنها: أن المقام مقام بيان غرض الشيطان في التخويف من أوليائه وتعظيم شأنهم بغضّ النظر عمّن يصيبه هذا التخويف.
ومنها: أنّ حذف المفعول الذي يشار فيه إلى
المؤمنين فيه تحقير لكيد الشيطان، وأنّ مقصوده الأعظم تخويف المؤمنين، ومن
كان مؤمناً قويّ الإيمان فلن يخافَ كيده، ولذلك قال تعالى: {فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين} فمقتضى الإيمان الصحيح أن ينتفي خوف المؤمن من الشيطان.
والمقصود أن معنى الآية على ما تقرر هو أن الشيطان يخوّف المؤمنين وغيرهم
شأنَ أوليائه، وهذا التخويف إنما يكون بتعظيم خطرهم في أعين المؤمنين
وتهويل كيدهم كما قال أبو مالك الغفاري رحمه الله: (يعظّم أولياءه في أعينكم) رواه ابن أبي حاتم.
ومن قال من المفسرين: المعنى (يخوّفكم بأوليائه)
فهو تفسير بلازم المعنى؛ لأن المعنى يفضي إلى هذا اللازم؛ فالشيطان
إنما يخوّف بأوليائه؛ فأوقع أولياءه موقع الأداة التي يخوّف بها، وهذا
التفسير رواه ابن جرير عن سالم الأفطس، وهو من أصحاب سعيد بن جبير
رحمهما الله.
فهذه الآية فيها حذف لكنه على غير ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله، وإنما المحذوف فيها المفعول الأول ليخوّف.
2: وقول ابن قتيبة في قول الله تعالى: {من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً} قال: (أي: يعلم أنّ العزة لمن هي).
3: وقول أبي الفتح ابن جني في قول الله تعالى: {واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه} أي: جزاء ما أترفوا فيه.
4: وقول العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في قول الله تعالى: {حرّمت عليكم أمهاتكم} معناه نكاح أمهاتكم.
وقد توسع جداً في كتابه الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز في ذكر أمثلة من هذا النوع في القرآن ورتّبها على السور والآيات، وعد ذلك كلّه من المجاز.
وقال أبو الفتح ابن جني: (وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع؛ وذلك أنه على حذف المضاف لا غير).
- قال ابن القيّم رحمه الله: (الحذف
الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة فإن قوة الكلام تعطيه، ولو صرّح
المتكلم بذكره كان عيّاً وتطويلاً مخلاً بالفصاحة كقوله: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى}
قالوا: هذا مجاز تقديره: ما أفاء الله من
أموال القرى، وهذا غلط وليس بمجاز، ولا يحتاج إلى هذا التقدير،
والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير، فالقائل: "اتصل إليَّ من فلان ألف"
يصح كلامه لفظاً ومعنى بدون تقدير، فإنَّ "مِنْ" للابتداء في الغاية،
فابتداء الحصول من المجرور بمن، وكذلك في الآية.
يوضحه أن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه، فأما إذا
استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير
غير مفيد ولا يحتاج إليه، وهو على خلاف الأصل.
فالحذف المتعيّن تقديرُه كقوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} وقوله: {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى} ونحو ذلك.
وأما نحو قوله: {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق}
فليس هناك تقدير أصلاً، إذ الكلام مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقدير،
فإنَّ الذي يُدَّعى تقديره قد دلَّ اللفظ عليه باللزوم فكأنَّه مذكور؛
لأن اللفظ يدل بلازمه كما يدل بحروفه، ولا يقال لما دل عليه دلالة
التزام إنه محذوف، فتأمله فإنه منشأ غلط هؤلاء في كثير مما يدعون فيه
الحذف)ا.هـ.
ومن أشهر الأمثلة التي ادّعي فيها حذف المضاف قول الله تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها}
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: {واسأل القرية}.
قالوا: المراد به أهلها فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه.
فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب؛ وأمثال هذه الأمور
التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم، ثم قد يعود الحكم على
الحالّ، وهو السكان وتارة على المحلّ وهو المكان.
وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحلّ، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت الميزاب وهو المحلّ، وجرى الميزاب وهو الماء.
وكذلك القرية قال تعالى: {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة}، وقوله: {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين} ، وقال في آية أخرى: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون} ؛ فجعل القرى هم السكان.
وقال: {وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم}، وهم السكان، وكذلك قوله تعالى {وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا}.
وقال تعالى: {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها}؛
فهذا المكان لا السكان لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا؛ فلا يسمَّى
قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع، ومنه قولهم:
قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه.
ونظير ذلك لفظ " الإنسان " يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا
خربت كان عذابا لأهلها؛ فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر؛ كما ينال
البدن والروح ما يصيب أحدهما.
فقوله: {واسأل القرية} مثل قوله: {قرية كانت آمنة مطمئنة}؛ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف)ا.هـ.
- وقال ابن القيّم رحمه الله: (أكثر المواضع التي ادعي فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف، ولا دليل على صحّة دعواه كقوله: {وكم من قرية أهلكناها} ، {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله}
إلى أمثال ذلك، فادّعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف، وأنَّ
التقدير في ذلك كلّه أهل القرية، وهذا غير لازم، فإن القرية اسم للقوم
المجتمعين في مكان واحد، فإذا نسب إلى القرية فعل أو حكم عليها بحكم أو
أخبر عنها بخبر كان في الكلام ما يدل على إرادة المتكلم من نسبة ذلك
إلى الساكن أو المسكن، أو هو حقيقة في هذا وهذا، وليس ذلك من باب
الاشتراك اللفظي، بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحد، فإذا
أطلقت تناولت الساكن والمسكن، وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت
فيما قُيِّدَت به، فقوله تعالى: {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة}
حقيقة في الساكن، وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن إنما يراد بها
الساكن فتأمله، وقد يراد بها المسكن خاصة، فيكون في السياق ما يعيّنه
كقوله تعالى: {أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها} أي ساقطة على سقوفها، وهذا التركيب يعطي المراد، فدعوى أن هذا حقيقة القرية، وأن قوله: {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله} ونحوه مجاز، تحكّم باردٌ لا معنى له)ا.هـ.
عبد العزيز بن داخل المطيري
أغراض الذكر
وفي مقابل الحذف يقع أحيانا تصريح بذكر ما لو حذف لعُرف؛ فيكون الذكر أوقع في السمع وأبين للمراد وأحسن تأثيراً على المخاطب.
وللذكر في المواضع التي يمكن فيها الحذف أغراض منها:
1: دفع اللبس بالتصريح بالذكر، كما في قول الله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38)}
ولو قيل فما متاعها؛ لوقع اللبس بعود الضمير إلى أقرب مذكور، مع ما في
التصريح بالذكر من زيادة تصوير الموازنة بين متاع الحياة الدنيا
والآخرة.
2: زيادة التقرير والإيضاح كما في قول الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فأعاد ذكر اسم الإشارة {أولئك} مع ما تشعر به هذه الزيادة من المدح والثناء.
3: زيادة المعنى بإعادة الذكر مع إضافة وصف أو حكم؛ كما في قول الله تعالى: {أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا} فكان في ذكرهم بوصف الظلم بدل الضمير زيادة معنى، مع ما يدلّ عليه الالتفات من الإعراض عنهم.
وكذلك قول الله تعالى: {وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل}.
4: التأثير على المخاطب تخويفاً أو تسكيناً أو تشويقاً أو تشنيعاً أو تهويلاً.
- فمثال التخويف: قول الله تعالى:
{أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بياتا وَهُمْ
نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القرى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى
وَهُمْ يَلْعَبُونَ}
- ومثال التسكين وزيادة الاطمئنان قول الله تعالى: {لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين . ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا} ففي
ذكر اسم الله صريحاً غير مضمر ما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والسكينة،
ولو قال: ليكفّر عنهم ؛ لكان المعنى مفهوماً، لكن الاسم الظاهر أوقع في
النفس من الضمير.
ومثاله أيضاً قوله تعالى: { إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ
رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18)}
- ومثال التشويق: قول الله تعالى: {
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ
مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى}، فكرر ذكر الأنهار في مواضع لو أضمرت لفهم المعنى، لكن النصّ على ذكر الأنهار يفيد من التشويق ما لا يفيده العطف المجرد عن الذكر.
- ومثال التشنيع: قول الله تعالى: {
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
(90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي
لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)}.
وقد يجتمع التشنيع والتخويف كما في قول الله تعالى: {وَإِنْ
تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي
خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (5) }
- ومثال التهويل: قول الله تعالى: {إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها }
5: التعظيم، كما في قول الله تعالى:
{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)}
فكرر ذكر {هو الله} ثلاث مرات تعظيماً لشأنه جلّ وعلا.
وقال الله تعالى: {فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين} ولا يخفى ما في تكرار الذكر من معنى التعظيم.
وكذلك في قول الله تعالى: {لا أقسم بهذا البلد . وأنت حلّ بهذا البلد} فيه تعظيم للبلد الحرام.
6: التوسّل بتكرار ذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته كما في قول الله تعالى:
{ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)}
7: التلطّف بتكرار ذكر المخاطَب، كما في قول الله تعالى:
{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَاأَبَتِ
إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي
أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَاأَبَتِ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
وَلِيًّا (45)}
فكرر الخليل عليه السلام ذكر {يا أبت} تلطّفاً بأبيه وتودداً إليه بذكر ما يُحبّ أن يُنادى به.
عبد العزيز بن داخل المطيري
وقال ابن زيد وقتادة: (معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء).
وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟
قال: أما تقرأ القرآن {ولذكر الله أكبر}.
ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» الحديث.
وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: (الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر).
وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر.
وفي السنن عن عائشة عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح).
فيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى: "وجد عليه أمة من الناس يسقون" أغنامهم أو مواشيهم و "امرأتين تذودان" غنمهما و "قالتا لا نسقي" غنمنا "فسقى لهما" غنمهما.
ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سَقْي، فأما ما كان المسقي؟ أغنما أم إبلا أم غير ذلك، فخارج عن الغرض، وموهم خلافه.
وذاك أنه لو قيل: "وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما"، جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود، بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود كما أنك إذا قلت:"ما لك تمنع أخاك؟ "، كنت منكرا المنع، لا من حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت، إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض لا يصح إلا على تركه).
وكمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ونعوت جلاله؛ فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الأول الآخر، الظاهر الباطن.
وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال: والذي استوى على عرشه، فوق سمواته، يصعد إليه الكلم الطيب، وترفع إليه الأيدي، وتعرج الملائكة والروح إليه، ونحو ذلك.
وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه فقال: والذي ملأ قلبي من محبتك وإجلالك ومهابتك، ونظائر ذلك، لم يحتج إلى جواب القسم، وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه.
فمن هذا قوله تعالى: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، وللشرف والقدر، ما يدل على المقسم عليه، وكونه حقاً من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون.
وهذا معنى قول كثير من المفسرين متقدميهم ومتأخريهم: إن الجواب محذوف تقديره إن القرآن لحق.
وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك.
وأما قول بعضهم: إن الجواب قوله تعالى: {كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ} فاعترض بين القسم وجوابه بقوله: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} فبعيد؛ لأن كم لا يُتلقى بها القسم فلا تقول: والله كم أنفقت مالاً، وبالله كم أعتقت عبداً.
وهؤلاء لمَّا لم يخفَ عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا ما يُتلقى بها الجواب: أي لكم أهلكنا.
وأبعد من هذا قول من قال: الجواب في قوله: {إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُل}.
وأبعد منه قول من قال: الجواب {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ}.
وأبعد منه قول من قال: الجواب قوله: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ}.
وأقرب ما قيل في الجواب لفظاً وإن كان بعيداً معنى، عن قتاده وغيره إنه في قوله: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا} كما قال: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ}
وشرح صاحب النظم هذا القول؛ فقال: معنى "بل" توكيد الخبر الذي بعده؛ فصار كإن الشديدة في تثبيت ما بعدها، و"بل" ههنا بمنزلة إن لأنه يؤكد ما بعده من الخبر، وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم؛ فكأنه عزَّ وجل قال: {ص والقرآن ذي الذكر} [إن الذين كفروا في عزة وشقاق] كما تقول: والله إن زيداً لقائم.
قال: واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وإن لم يكن للعربية فيه أصل ولا لها رسم؛ فيُحتمل أن يكون نظماً أحدثه الله عز وجل لما بينا من احتمال أن تكون "بل" بمعنى "إن"ا.هـ
وقال أبو القاسم الزجاج قال النحويون إن بل تقع في جواب القسم كما تقع إن لأن المراد بها توكيد الخبر وهذا القول اختيار أبي حاتم وحكاه الأخفش عن الكوفيين وقرره بعضهم بأن قال أصل الكلام {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} {وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} فلما قدم القسم ترك على حاله قال الأخفش وهذا يقوله الكوفيون وليس يجيد في العربية لو قلت والله قام وأنت تريد قام والله لم يحسن وقال النحاس هذا خطأ على مذهب النحويين لأنه إذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بد من الجواب وأجمعوا أنه لا يجوز والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله لأن الكلام يعتمد على القسم وذكر الأخفش وجهاً آخر في جواب القسم فقال يجوز ن يكون لصاد معنى يقع عليه القسم لا ندري نحن ما هو كأنه يقول الحق والله قال أبو الحسن الواحدي وهذا الذي قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول ص الصادق الله أو صدق محمد وذكر الفراء هذا الوجه أيضاً فقال ص جواب القسم وقال هو كقولك وجب والله وترك والله فهي جواب لقوله والقرآن وذكر النحاس وغيره وجهاً آخر في الجواب وهو أنه محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر فالأمر كما يقوله هؤلاء الكفار ودل على المحذوف قوله تعالى {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا} وهذا اختيار ابن جرير وهو مخرج من قول قتادة وشرحه الجرجاني فقال بل رافع لخبر قبله ومثبت لخبر بعده فقد ظهر ما قبله وما بعده دليل على ما قبله فالظاهر يدل على الباطن فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} مخالفاً لهذا المضمر فكأنه قيل والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق أو كل ما في هذا المعنى فهذه ستة أوجه سوى ما بدأنا به في جواب القسم والله أعلم
ونظير هذا قوله تعالى {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا} قيل جواب القسم قد علمنا وقال الفراء محذوف دل عليه قوله أإذا متنا أي لتبعثن وقيل قوله بل عجبوا كما تقدم بيانه).
عبد العزيز بن داخل المطيري
تطبيقات الدرس التاسع
بيّن أغراض الحذف والذكر في في الآيات التاليات:
(1) قول الله تعالى: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)}
(2) قول الله تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ
آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96)}
(3) قول الله تعالى: { وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}
(4) قول الله تعالى: {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ
عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ}
(5) قول الله تعالى: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}