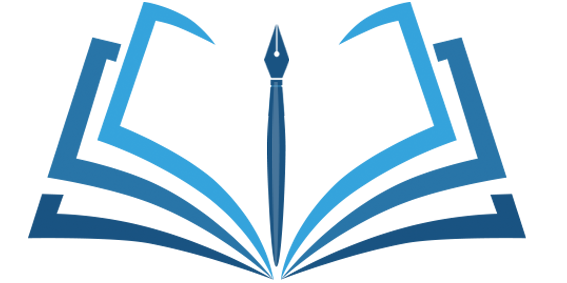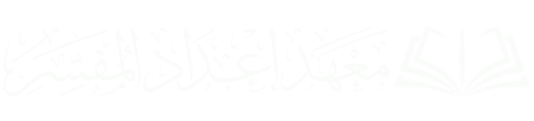تفسير سورة النساء
القسم التاسع
تفسير سورة النساء [ من الآية (114) إلى الآية (115) ]

تفسير سورة النساء
القسم التاسع
تفسير سورة النساء [ من الآية (114) إلى الآية (115) ]
18 Nov 2018
تفسير قوله تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله
تعالى: لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلاّ من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو
إصلاحٍ بين النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجراً
عظيماً (114) ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل
المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيراً (115) إنّ اللّه لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضلّ
ضلالاً بعيداً (116) الضمير
في نجواهم عائد على الناس أجمع، وجاءت هذه الآيات عامة التناول، وفي
عمومها يندرج أصحاب النازلة، وهذا عن الفصاحة والإيجاز المضمن الماضي
والغابر في عبارة واحدة، والنجوى: المسارّة،
مصدر، وقد تسمى به الجماعة، كما يقال: قوم عدل ورضا، وتحتمل اللفظة في
هذه الآية أن تكون الجماعة وأن تكون المصدر نفسه، فإن قدرناها الجماعة
فالاستثناء متصل، كأنه قال: لا خير في كثير من جماعاتهم المنفردة المتسارة
إلا من، وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه، كأنه قال: لا خير في كثير من
تناجيهم، فالاستثناء منقطع بحكم اللفظ، ويقدر اتصاله على حذف مضاف، كأنه
قال: إلا نجوى من، قال بعض المفسرين: النجوى كلام الجماعة المنفردة كان ذلك
سرا أو جهرا. قال
القاضي أبو محمد رحمه الله: انفراد الجماعة من الاستسرار، والغرض المقصود
أن النجوى ليست بمقصورة على الهمس في الأذن ونحوه، و «المعروف»: لفظ يعم
الصدقة والإصلاح، ولكن خصّا بالذكر اهتماما بهما، إذ هما عظيما الغناء في
مصالح العباد، ثم وعد تعالى «بالأجر العظيم» على فعل هذه الخيرات بنية
وقصد لرضا الله تعالى. وابتغاء نصب على المصدر، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم
والكسائي فسوف نؤتيه بالنون وقرأ أبو عمرو وحمزة «يؤتيه» بالياء
والقراءتان حسنتان). [المحرر الوجيز: 3/22-23] قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله
تعالى: ومن يشاقق الرّسول الآية، لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق، لأنه
ارتد وسار إلى مكة، فاندرج الإنحاء عليه في طي هذا العموم المتناول لمن
اتصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة، وقوله ما تولّى وعيد بأن يترك مع فاسد
اختياره في تولي الطاغوت، وقرأ ابن أبي عبلة «يوله» و «يصله» بالياء
فيهما). [المحرر الوجيز: 3/23]
تفسير
قوله تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا (114)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ):
(وقوله: (لا خير في كثير من نجواهم إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح
بين النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما
(114)
النجوي في الكلام ما تنفرد به الجماعة أو الاثنان سرا كان أو ظاهرا.
ومعنى نجوت الشيء في اللغة خلّصته وألقيته، يقال نجوت الجلد إذا ألقيته عن البعير وغيره.
قال الشاعر:
فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه... سيرضيكما منها سنام وغاربه
وقد نجوت فلانا إذا استنكهته.
قال الشاعر:
نجوت مجالدا فوجدت منه... كريح الكلب مات حديث عهد
ونجوت الوبر واستنجيته إذا خلصته.
قال الشاعر:
فتبازت فتبازخت لها... جلسة الأعسر يستنجي الوتر
وأصله كله من النجوة، وهو ما ارتفع من الأرض
قال الشاعر:
فمن بنجوته كمن بعقوته... والمستكنّ كمن يمشي بقرواح
ويقال: ما أنجى فلان شيئا وما نجا شيئا منذ أيام، أي لم يدخل الغائط.
والمعنى واللّه أعلم: لا خير في كثير من نجواهم، أي مما يدبرونه بينهم من الكلام.
(إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس).
فيجوز أن يكون موضع " من "
خفضا، المعنى إلا في نجوى من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويجوز
أن يكون - واللّه أعلم - استثناء ليس من الأول ويكون موضعها نصبا، ويكون
على معنى لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير. وأعلم الله عزّ وجلّ
أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند اللّه فقال:
(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما).
ومعنى (ابتغاء مرضات اللّه) طلب مرضاة اللّه.
ونصب (ابتغاء مرضات اللّه) لأنه مفعول له.
المعنى ومن يفعل ذلك لابتغاء مرضاة اللّه، وهو راجع إلى تأويل المصدر، كأنه قال: ومن يبتغ ابتغاء مرضاة اللّه). [معاني القرآن: 2/104-106]
يقول تعالى: {لا خير في كثيرٍ من
نجواهم} يعني: كلام النّاس {إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين
النّاس} أي: إلّا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الّذي رواه ابن
مردويه:
حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن إبراهيم،
حدّثنا محمّد بن سليمان بن الحارث، حدّثنا محمّد بن يزيد بن خنيس قال:
دخلنا على سفيان الثّوريّ نعوده -وأومأ إلى دار العطّارين -فدخل عليه سعيد
بن حسّان المخزوميّ فقال له سفيان الثّوريّ: الحديث الّذي كنت حدّثتني به
عن أمّ صالحٍ اردده عليّ. فقال: حدّثتني أمّ صالحٍ، عن صفية بنت شيبة، عن
أمّ حبيبة قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كلام ابن آدم
كلّه عليه لا له ما خلا أمرًا بمعروفٍ أو نهيًا عن منكرٍ [أو ذكر اللّه
عزّ وجلّ"، قال سفيان: فناشدته] فقال محمّد بن يزيد: ما أشدّ هذا الحديث؟
فقال سفيان: وما شدّة هذا الحديث؟ إنّما جاءت به امرأةٌ عن امرأةٍ، هذا في
كتاب اللّه الّذي أرسل به نبيّكم صلّى اللّه عليه وسلّم أو ما سمعت اللّه
يقول في كتابه: {لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ
أو إصلاحٍ بين النّاس} فهو هذا بعينه، أو ما سمعت اللّه يقول: {يوم يقوم
الرّوح والملائكة صفًّا لا يتكلّمون إلا من أذن له الرّحمن وقال صوابًا}
[النّبأ: 38] فهو هذا بعينه، أو ما سمعت اللّه يقول في كتابه: {والعصر. إنّ
الإنسان لفي خسرٍ. [إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحقّ
وتواصوا بالصّبر]} [سورة العصر]، فهو هذا بعينه.
وقد روى هذا الحديث التّرمذيّ وابن ماجه
من حديث محمّد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسّان، به. ولم يذكرا أقوال
الثّوريّ إلى آخرها، ثمّ قال التّرمذيّ: غريبٌ لا نعرفه إلّا من حديث ابن
خنيس.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا يعقوب، حدّثنا
أبي، حدّثنا صالح بن كيسان، حدّثنا محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه بن
شهابٍ: أنّ حميد بن عبد الرّحمن بن عوفٍ أخبره، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة
أخبرته: أنّها سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "ليس الكذّاب
الّذي يصلح بين النّاس فينمي خيرًا -أو يقول خيرًا" وقالت: لم أسمعه يرخّص
في شيءٍ ممّا يقوله النّاس إلّا في ثلاثٍ: في الحرب، والإصلاح بين
النّاس، وحديث الرّجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أمّ كلثومٍ
بنت عقبة من المهاجرات اللّاتي بايعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
وقد رواه الجماعة، سوى ابن ماجه، من طرقٍ، عن الزّهريّ، به نحوه.
قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية، عن
الأعمش، عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد، عن أمّ الدّرداء، عن أبي
الدّرداء قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ألا أخبركم بأفضل من
درجة الصّلاة، والصّيام والصّدقة؟ " قالوا: بلى. قال: "إصلاح ذات البين"
قال: "وفساد ذات البين هي الحالقة".
ورواه أبو داود والتّرمذيّ، من حديث أبي معاوية، وقال التّرمذيّ: حسنٌ صحيحٌ.
وقال الحافظ أبو بكرٍ البزّار: حدّثنا
محمّد بن عبد الرّحيم، حدّثنا سريج بن يونس، حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد
اللّه بن عمر، حدّثنا أبي، عن حميدٍ، عن أنسٍ؛ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه
وسلّم قال لأبي أيّوب: "ألا أدلّك على تجارةٍ؟ " قال: بلى: قال: "تسعى في
صلحٍ بين النّاس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا" ثمّ قال
البزّار: وعبد الرّحمن بن عبد اللّه العمري ليّن، وقد حدّث بأحاديث لم
يتابع عليها.
ولهذا قال: {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات
الله} أي: مخلصًا في ذلك محتسبًا ثواب ذلك عند اللّه عزّ وجلّ {فسوف نؤتيه
أجرًا عظيمًا} أي: ثوابًا كثيرًا واسعًا). [تفسير القرآن العظيم: 2/411-412]
تفسير قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ
الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (ثم عاد الأمر إلى ذكر طعمة هذا ومن أشبهه فقال:
(ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيرا (115)
لأن طعمة هذا كان قد تبين
لصه ما أوحى اللّه إلى نبيه في أمره، وأظهر من سرقته في الآية ما فيه
بلاغ، فعادى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصار إلى مكة، وأقام مع
المشركين.
ومعنى (نولّه ما تولّى)
ندعة وما اختار لنفسه في الدنيا لأن اللّه جلّ وعزّ وعد بالعذاب في الآخرة،
وأعلم تعالى أنه لا يغفر الشرك، وذكر قبل هذه الآية: (ومن يعمل سوءا أو
يظلم نفسه ثمّ يستغفر اللّه يجد اللّه غفورا رحيما (110).
وأعلم بعدها أن الشرك لا
يجوز أن يغفره ما أقام المشرك عليه، فإن قال قائل فإنما قال: (إنّ اللّه
لا يغفر أن يشرك به) فإن سمّي رجل كافرا ولم يشرك مع اللّه غيره فهو خارج
عن قوله: (إنّ اللّه لا يغفر أن يشرك به)؟
فالجواب في هذا أن كل كافر
مشرك باللّه لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد زعم أن الآيات التي أتى بها
ليست من عند اللّه، فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير اللّه فيصير مشركا. فكل
كافر مشرك.
فالمعنى أن الله لا يغفر كفر من كفر به وبنبيّ من أنبيائه لأن كفره بنبيه كفر به.
(ومن يشرك باللّه فقد ضلّ ضلالا بعيدا).
لأن جعله مع اللّه غيره من أبعد الضلال والعمى، وهذا أكثر ما جرى ههنا من أجل الذين عبدوا الأصنام.
والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ بعقب هذا:
(إن يدعون من دونه إلّا إناثا)
فأمّا (نولّه ما تولّى ونصله جهنّم).
ففيها أوجه، يجوز فيها
نولهي - بإثبات الياء، ويجوز نولهو بإثبات الواو: ويجوز " نوله " بكسر
الهاء، فأما " نوله " - بإسكان الهاء و " نصله جهنم "، فلا يجوز إسكان
الهاء لأن الهاء حقها أن يكون معها - ياء، وأما حذف الياء فضعيف فيها، ولا
يجوز حذف الياء ولا تبقى الكسرة التي تدل عليها). [معاني القرآن: 2/106-107]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى} أي: ومن سلك غير طريق
الشّريعة الّتي جاء بها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، فصار في شقٍّ
والشّرع في شقٍّ، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحقّ وتبيّن له واتّضح له.
وقوله: {ويتّبع غير سبيل المؤمنين} هذا ملازمٌ للصّفة الأولى، ولكن قد
تكون المخالفة لنصّ الشّارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة المحمّديّة،
فيما علم اتّفاقهم عليه تحقيقًا، فإنّه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من
الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم [صلّى اللّه عليه وسلّم]. وقد وردت في
ذلك أحاديث صحيحةٌ كثيرةٌ، قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب "أحاديث
الأصول"، ومن العلماء من ادّعى تواتر معناها، والّذي عوّل عليه الشّافعيّ،
رحمه اللّه، في الاحتجاج على كون الإجماع حجّةً تحرم مخالفته هذه الآية
الكريمة، بعد التّروّي والفكر الطّويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها،
وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدّلالة منها على ذلك.
ولهذا توعّد تعالى على ذلك بقوله:
{نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيرًا} أي: إذا سلك هذه الطّريق
جازيناه على ذلك، بأن نحسّنها في صدره ونزيّنها له -استدراجًا له -كما قال
تعالى: {فذرني ومن يكذّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} [القلم:
44]. وقال تعالى: {فلمّا زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم} [الصّفّ:5]. وقوله
{ونذرهم في طغيانهم يعمهون} [الأنعام: 110].
وجعل النّار مصيره في الآخرة، لأنّ من
خرج عن الهدى لم يكن له طريقٌ إلّا إلى النّار يوم القيامة، كما قال تعالى:
{احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم [وما كانوا يعبدون. من دون الله فاهدوهم
إلى صراط الجحيم]} [الصّافّات: 22، 23]. وقال: {ورأى المجرمون النّار
فظنّوا أنّهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفًا} [الكهف:53] ). [تفسير القرآن العظيم: 2/412-413]
* للاستزادة ينظر: هنا