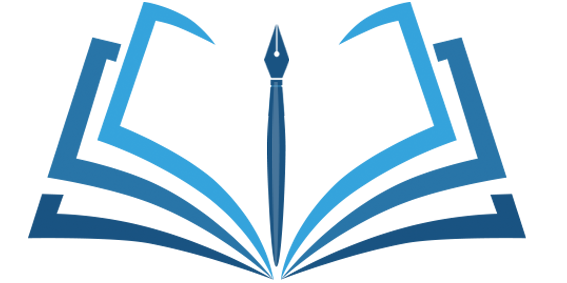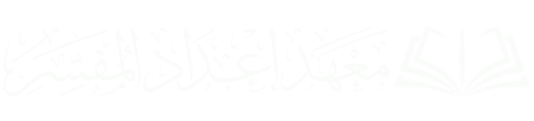قواعد التحديث
القسم الرابع
الدرس الثامن عشر: الاجتهاد في الحديث
11 Oct 2022
الدرس الثامن عشر: الاجتهاد في الحديث
قال محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332هـ): (29- القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلاف:
قال حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره في القسطاس المستقيم تحت هذا العنوان: فقال كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات؟ قلت: إن أصغوا إلي رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى، ولكن لا حيلة في إصغائهم؛ فإنهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء، ولا إلى إمامك، وكيف يصغون إلي؟ وكيف يجتمعون على الإصغاء، وقد حكم عليهم في الأزل بأنهم {ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} [هود: 118-119].
فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟
قلت: كنت أعاملهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى إذ قال: {وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد} الآية [الحديد: 25].
وإنما أنزل هذه الثلاث، لأن الناس ثلاثة أصناف: وكل واحد من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم.
فقال: فمن هم؟ وكيف علاجهم؟
قلت: الناس ثلاثة أصناف؛ عوام: وهم أهل السلامة، والبله: وهم أهل الجنة، وخواص: وهم أهل الذكاء والبصيرة، ويتولد بينهم طائفة هم (أهل الجدل والشغب فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة.
أما الخواص فإني أعالجهم بأن أعلمهم الموازين القسط، وكيفية الوزن بها فيرتفع الخلاف بينهم على قرب، وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال:
أحدها: القريحة النافذة والفطنة القوية، وهذه عطية فطرية وغريزة جبلية، لا يمكن كسبها.
والثانية: خلو باطنهم من تقليد وتعصب موروث ومسموع، فإن المقلد لا يصغي، والبليد –وإن أصغى- فلا يفهم.
والثالثة: أن يعتقد في أني من أهل البصيرة بالميزان، ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك.
والصنف الثاني: البله: وهم جميع العوام، وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق، وإن كانت لهم فطنة، فليس لهم داعية الطلب، بل شغلتهم الصناعات والحرف، وليس فيهم أيضا داعية الجدل بخلاف المتكايسين في العلم مع قصور الفهم عنه، فهؤلاء لا يختلفون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين، فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة، كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة، وأدعو أهل الشغب بالمجادلة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة.
فأقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاءه فقال: علمني من غرائب العلم؟ فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس أهلا لذلك، فقال: وماذا علمت في رأس العلم؟ أي: الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة. اذهب فأحكم رأس العلم، ثم ارجع لأعلمك من غرائبه.
فأقول للعامي: ليس الخوض في الاختلافات من غشك فادرج ليس لك فيه حق فامض، فإياك أن تخوض فيه، أو تصغي إليه فتهلك، فإنك إذا صرفت عمرك في غير العلم فكيف تكون من أهل العلم، ومن أهل الخوض فيه، فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك؛ فكل كبيرة تجري على العامي أهون من أن يخوض في العلم فيكفر من حيث لا يدري، فإن قال: لا بد من دين أعتقده وأعمل به لأصل به إلى المغفرة، والناس مختلفون في الأديان، فبأي دين تأمرني أن آخذ أو أعول عليه؟
فأقول له: للدين أصول وفروع، والاختلاف إنما يقع فيهما؛ أما الأصول: فليس عليك أن تعتقد فيها إلا ما في القرآن، فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه. فعليك أن تعتقد أن لا إله إلا الله، وأن الله حي عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس، ليس كمثله شيء إلى جميع ما ورد في القرآن، واتفق عليه الأئمة فذلك كاف في صحة الدين، وإن تشابه عليك شيء فقل: آمنا كل من عند ربنا. واعتقد كل ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس، مع نفي المماثلة، واعتقاد أنه ليس كمثله شيء، وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال، فإنك غير مأمور به، ولا هو على حد طاقتك، فإن أخذ يتحذلق ويقول: قد علمت أنه عالم من القرآن، ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات، أو بعلم زائد عليه.
وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة، فقد خرج بهذا عن حد العوام؛ إذ العامي لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجهل، فإن الله تعالى لا يهلك قوما إلا يؤتيهم الجدل. كذلك ورد الخبر، وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم، هذا ما أعظ به في الأصول وهو الحوالة على كتاب الله؛ فإن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان والحديد، وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب.
وأما الفروع فأقول: لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه، فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام، والمال الحرام، والغيبة والنميمة والزنا والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام، والفرائض كلها واجبة، فإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف، فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله، فهو جدلي وليس بعامي، ومتى تفرغ العامي من هذا إلى مواضع الخلاف؟
أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا، ثم أخذ أشكال الخلاف بمخنقهم؟ هيهات ما أشبه ضعف عقولهم في خلافهم إلا بعقل مريض، به مرض أشرف على الموت، وله علاج متفق عليه بين الأطباء وهو يقول: قد اختلف الأطباء في بعض الأدوية أنها حارة أو باردة، وربما افتقرت إليه يوما فأنا لا أعالج نفسي حتى أجد من يعلمني رفع الخلاف فيه، نعم لو رأيتم صالحا قد فرغ من حدود التقوى كلها، وقال: ها أنا تشكل علي مسائل؛ فإني لا أدري، أتوضأ من اللمس والقيء والرعاف، وأنوي الصوم بالليل في رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك؟
فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط، وخذ بما يتفق عليه الجميع فتوضأ من كل ما فيه خلاف، فإن كل من لا يوجبه يستحبه، وانو الصيام بالليل في رمضان، فإن من لا يوجبه يستحبه.
فإن قال: هو ذا يثقل علي الاحتياط، ويعرض لي مسائل تدور بين النفي والإثبات، وقال: لا أدري أقنت في الصبح أم لا. وأجهر بالتسمية أم لا؟ فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك، وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك، وصوابه أغلب على قلبك، كما لو كنت مريضا وفي البلد أطباء، فإنك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك، فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه، فإن أصاب فيما قال عند الله فله في ذلك أجران، وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد، وقال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83].
وارتضى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي.
قال ذلك قبل أن أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله. ففهم من ذلك أنه مرضي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره.
كما قال الأعرابي: إني هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان! فقال: أعتق رقبة.
ففهم أن التركي أو الهندي لو جامع أيضا لزمه الإعتاق، وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله تعالى؛ فإن ذلك غير مقدور عليه، ولا تكليف بما لا يطاق، بل كلفوا ما يظنونه صوابا، كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر، بل بثوب يظنونه أنه طاهر، فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء؛ إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة لما أنبأه جبريل أن عليه قذرا، ولم يعد الصلاة ولم يستأنف، وكذلك لم يكلف أن يصلي إلى القبلة، بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس، فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد، ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير، بل إلى من ظنوا فقره؛ لأن ذلك لا يعرف باطنه، ولم يكلف القضاة في سفك الدماء، وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم، بل من يظنون صدقه.
وإذا جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ –وهو ظن صدق الشهود- فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد؟!
وليت شعري! ماذا يقال رفقاؤك في هذا؟ يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة: يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله، أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها، أو يقول: اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد، إذ لا يعرف أدلة القبلة، وكيفية الاستدلال بالكواكب والجبال والرياح؟
قال: لا أشك في أنه يأذن له في الاجتهاد، ثم لا يؤثمه إذا بذل كنه مجهوده وإن أخطأ وصلى إلى غير القبلة؟
قلت: فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذورا مأجورا، فلا يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذورا؛ فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون؛ بعضهم مصيبون ما عند الله، وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، فمناصبهم متقاربة، وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم من بعض، لا سيما والمصيب لا يتعين، وكل واحد منهم يظن أنه مصيب، كما لو اجتهد مسافران في القبلة، فاختلفا في الاجتهاد، فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه، وأن يكف إنكاره وإعراضه، واعتراضه على صاحبه، لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه، أما استقبال عين القبلة فلا يقدر عليه.
وكذلك كان معاذ في اليمن، يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ، لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذورا، وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي لا يتصور أن تختلف بها الشرائع، يقرب فيها الشيء من نقيضه بعد كونه مظنونا في سر الاستبصار، وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف.
وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل، فإني أدعوهم بالتلطف إلى الحق، وأعني بالتلطف: أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم، لكن أرفق وأجادل بالتي هي أحسن، وكذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى المجادلة بالأحسن: أن آخذ الأصول التي يسلمها الجدلي، وأستنتج منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وإلى ذلك الجد، فإن لم يقنعه ذلك، لتشوفه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليم الموازين، فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجة وعناده عالجته بالحديد؛ فإن الله سبحانه جعل الحديد والميزان قريني الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث؛ فالكتاب للعوام، والميزان للخواص، والحديد الذي فيه بأس شديد: للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم دون أهل الجدل، وأعني بأهل الجدل: طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام، ولكن كياستهم ناقصة؛ إذ كانت الفطرة فيهم كاملة، لكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد، فذلك يمنعهم عن إدراك الحق، وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، لكن لن تهلكهم إلا كياستهم الناقصة، فإن الفطنة البتراء، والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير. وفي الخبر: أن أكثر أهل الجنة البله، وأن عليين لذوي الألباب.
ويخرج من جملة الفريقين: الذي يجادلون في آيات الله، وأولئك أصحاب النار، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من الجدال بالسيف والسنان كما فعل عمر رضي الله عنه برجل، إذ سأله عن آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى، فعلاه بالدرة، وكما قال مالك رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء على العرش، فقال: الاستواء حق، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة.
وحسم بذلك باب الجدال، وكذلك فعل السلف كلهم، وفي فتح باب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تعالى، فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق، وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق. انتهى). [قواعد التحديث: 607-616]

هيئة الإشراف
قال محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332هـ): (30- بيان أن من المصالح هذه المذاهب المدونة وفوائد مهمة من أصل التخريج على كلام الفقهاء وغير ذلك:
قال الإمام ولي الله الدهلوي قدس سره في الحجة البالغة: "ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام، وزلت الأقدام وطغت الأقلام، منها: أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة، أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدًّا، وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال: "التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلا برهان لقوله تعالى: {اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء} وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا} وقال مادحًا لمن لم يقلد: {فبشّر عباد، الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الّذين هداهم اللّه وأولئك هم أولو الألباب} وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى اللّه والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة، وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قوله قائل لأنه غير القرآن والسنة، وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم، وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع، والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد -رضي الله عنهم- ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا يجد لنفسه سلفًا ولا إنسانًا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة، وأيضًا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم، وأيضًا فما الذي جعل رجلًا من هؤلاء أو من غيرهم أولى أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنهم- فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره". اهـ. إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن ظهر عليه ظهورًا بينًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بكذا ونهى عن كذا وأنه ليس بمنسوخ إما بأن يتتبع الأحاديث، وأقوال المخالف والموافق في المسألة فلا يجد لها نسخًا، أو بأن يرى جمًّا غفيرًا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا نفاق خفي أو حمق جلي، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: "ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودًا على تقليد إمامه بل بتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مقلدة" وقال: "لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب، ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدًا لهم فيما قال كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب" وقال الإمام أبو شامة: "ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فإنها مضيعة للزمان، ولصفوه مكدرة فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره، قال صاحبه المزني في أول مختصره: "اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله لأقر به على من أراد مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهى الشافعي عن تقليده، وتقليد غيره". اهـ. وفيمن يكون عاميًّا، ويقلد رجلًا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ، وأن ما قاله هو الصواب البتة وأضمر في قلبه أن لا يترك تقليده، وإن ظهر الدليل على خلافه، وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه} قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه، وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلًا فقيهًا شافعيًّا وبالعكس ولا يجوز أن يقتدى الحنفي بإمام شافعي مثلًا، فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعتقد حلالًا إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرامًا إلا ما حرمه الله ورسوله، لكنه لما لم يكن له علم بما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالمًا راشدًا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرًا متبع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار، فهذا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا فرق بين أن يستفتى هذا دائمًا أو يستفتى هذا حينًا، وذلك حينًا بعد أن يكون مجمعًا على ما ذكرناه كيف لا، ولم نؤمن بفقيه أيًّا كان أنه أوحى الله إليه الفقه، وفرض علينا طاعته وأنه معصوم فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطًا منهما بنحو من الاستنباط، أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا، واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول: ظننت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا، والمقيس مندرج في هذا العموم.
فهذا أيضا معزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في طريقة ظنون، ولولا ذلك لما قلد مؤمن مجتهدًا فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه، وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا؟ وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟.
"ومنها: أن التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل في الدين، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما، فمنهم من يقل من ذا، ويكثر من ذاك، ومنهم من يكثر من ذا، ويقل من ذاك فلا ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين، وإنما الحق البحث أن يطابق أحدهما بالآخر، وأن يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصري: "سنتكم، والله الذي لا إله إلا هو بينهما" بين الغالي والجافي، فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره، وذهب إليه على رأي المجتهدين من التابعين، ومن كان من أهل التخريج له أن يجعل من السنن ما يحترز به من مخالفة الصريح الصحيح، ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو يقدر الطاقة، ولا ينبغي لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه وليست منا نص عليه الشارع فيرد به حديثًا أو قياسًا صحيحًا كرد ما فيه أدنى شائبة الإرسال والانقطاع كما فعله ابن حزم رد حديث تحريم المعازف لشائبة الانقطاع في رواية البخاري على أنه في نفسه متصل صحيح فإن مثله إنما يصار إليه عند التعارض، وكقولهم فلان أحفظ لحديث فلان من غيره فيرجحون حديثه على حديث غيره لذلك وإن كان في الآخر ألف رجه من الرجحان، وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برءوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وتقديم كلمة وتأخيرها، ونحو ذلك من التعمق وكثيرًا ما يعبر الراوي الآخر عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر، والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه، ولا ينبغي لمخرج أن يخرج قولًا لا يفيده نفس كلام أصحابه، ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة ويكون بناء على تخريج مناط أو حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض فيه الآراء، ولو أن أصحابه مثلوا عن تلك المسألة ربما يحملون النظير على النظير لمانع، وربما ذكروا علة غير ما خرجه هو، وإنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد ولا يتم إلا فيما يفهم من كلامه، ولا ينبغي أن يرد حديثًا أو أثر تطابق عليه القوم لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه كرد حديث المصراة. وكإسقاط سنهم ذوي القربى، فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال: "مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فبلغ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف ما قلت فالقول ما قاله -صلى الله عليه وسلم".
"ومنها: أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبًا بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه، وتخص "أي هذه المعرفة" باسم الاجتهاد، وهذا الاستعداد يحصل تارة بالإمعان في جمع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها، كما أشار إليه أحمد بن حنبل مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام، وصاحب العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات، وترتيب الاستدلالات ونحو ذلك، وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه من معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها، وترجيح بعض الأقوال على بعض، ونقد التخريجات، ومعرفة الجيد والزيف، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما، وعلم أن قوله ليس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ولا يجري فيه فتوى المفتين، وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها، ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج يتجزأ، وإنما المقصود تحصيل الظن وعليه مدار التكليف، فما الذي يستبعد من ذلك؟ وأما ما دون ذلك من الناس، فمذهبه فيما يرد عليه كثيرًا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم القاضي، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قديمًا وحديثًا، وهو الذي أوصى به أئمة المذاهب أصحابهم".
ثم قال الدهلوي رحمه الله: "قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه نظر: إن كملت له آله الاجتهاد مطلقًا، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل له آلة الاجتهاد وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالف جوابًا شافيًا عنه فله العمل به، إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه ها هنا وحسنة النووي.
"ومنها: أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن مسعود، والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفاع، والإيثار في الإقامة، ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد القولين، وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة، وقد عللوا كثيرًا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون، وأنهم جميعًا على الهدى ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية، ويسلمون قضاء القضاة ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول ويبينون الخلاف يقول أحدهم: هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي ويقول: ما بلغنا إلا ذلك، وهذا كثير في المبسوط وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعي رحمه الله ثم خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم فقووا الخلاف، وثبتوا على مختار أئمتهم، والذي يروى من السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم، وأن لا يخرج منها بحال فإن ذلك إما لأمر جبلي، فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم، أو لصوله ناشئة من ملاحظة الدليل، أو لنحو ذلك من الأسباب فظن البعض تعصبًا دينيًّا، حاشاهم من ذلك. وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت في الفجر ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم -رضي الله عنهم- يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا جهرًا وصلى الرشيد إمامًا وقد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد، وكان أفتاه الإمام مالك بأنه لا وضوء عليه، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ وروي أن أبا يوسف ومحمدًا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس لأن هارون الرشيد كان يحب تكبير جده، وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبًا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدبًا معه، وقال أيضًا: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق وقال مالك رحمه الله للمنصور وهارون الرشيد ما ذكرنا عنه سابقا، وفي البزازية عن الإمام الثاني، وهو أبو يوسف رحمه الله أنه صلى يوم الجمعة مغتسلًا من الحمام، وصلى بالناس وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام فقال إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا". اهـ.
ثم قال الدهلوي قدس سره: "ومنها: أني وجدت بعضهم يزعم أن هنالك فرقتين لا ثالث لهما: أهل الظاهر وأهل الرأي، وأن كل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأي. كلا والله بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل، فإن ذلك لا ينفك من أحد من العلماء، ولا الرأي الذي لا يعتمد على سنة أصلًا فإنه لا ينتحله مسلم البتة، ولا القدرة على الاستنباط والقياس فإن أحمد وإسحاق بل الشافعي أيضًا ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق، وهم يستنبطون ويقيسون، بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين، فكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير، والرد إلى أصل من الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار. والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعين كداود وابن حزم وبينهما المحقون من أهل السنة كأحمد وإسحاق". اهـ). [قواعد التحديث: 617-627]

هيئة الإشراف
قال محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332هـ): (31- بيان أن جميع المجتهدين على هدى من ربهم:
قال العارف الشعراني قدس سره في كتابه الجواهر والدرر في: المبحث التاسع والأربعون في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم من حيث وجوب العمل بكل ما أدى إليه اجتهادهم، وإثبات الأجر لهم من الشارع وإن أخطؤوا: «سمعت عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: اعملوا على الجمع بين أقوال العلماء جهدكم، فإن إعمال القولين أولى من إلغاء أحدهما، وبذلك يقل تناقض أقوال العلماء، ومن وصل إلى مقام الكشف وجد جميع الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من أقوالهم، وشهدها كلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة، لأنهم على آثار الرسل سلكوا».
قال الشعراني: وقد تتبعت بحمد الله أدلة المجتهدين، فلم أجد فرعا من فروع مذاهبهم إلا وهو مستند إلى دليل، إما آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح على أصل صحيح، لكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلا، ومنه ما هو مأخوذ من المفهوم، أو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلا، ومنه ما هو مأخوذ من المفهوم، أو مأخوذ من ذلك المأخوذ، وهكذا ... فمن أقوالهم قريب وأقرب، وبعيد وأبعد، وكلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة التي هي الأصل، ومحال أن يوجد فرع من غير أصل.
وإيضاح ذلك: أن نور الشريعة المطهرة هو النور الوضاح، ولكن كلما قرب الشخص منه يجده أضوء من غيره، وكلما بعد عنه في سلسلة التقليد يجده أقل نورا بالنسبة لما هو أقرب من عين الشريعة، وهذا هو سبب تفاوت أقوال علماء المذاهب وتضعيف بعضهم كلام بعض إلى عصرنا هذا.
ثم نقل الشعراني عن الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال في الباب التاسع والستين من فتوحاته بعد كلام طويل في مدح المجتهدين: فعلم أن المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة؛ لأنهم في منازل الأنبياء والرسل من حيث الاجتهاد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم الاجتهاد في الأحكام، وذلك تشريع عن أمر الشارع، فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعه بالاجتهاد.
وقال قدس سره في موضوع آخر: إنه تعالى جعل وحي المجتهدين في اجتهادهم، إذ المجتهد لم يحكم إلا بما أراه الله تعالى في اجتهاد، ولذلك حرم الله على المجتهد، أن يخالف ما أدى إليه الاجتهاد كما حرم على الرسل أن تخالف ما أوحى به إليهم، فعلم أن الاجتهاد نفحة من نفحات التشريع ما هو عين التشريع. اهـ). [قواعد التحديث: 627-628]