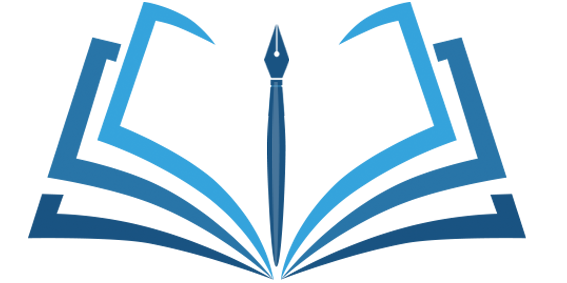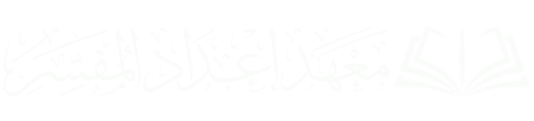تفسير سورة البقرة
القسم الخامس عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (213) إلى الآية (215) ]

تفسير سورة البقرة
القسم الخامس عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (213) إلى الآية (215) ]
17 Sep 2014
تفسير قول الله تعالى: {كَانَ
النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
اللَّهِ قَرِيبٌ (214) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) }
تفسير
قوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (قوله عزّ وجلّ: {كان
النّاس أمّة واحدة فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم
الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلّا
الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيا بينهم فهدى اللّه الّذين
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم} أي: على دين واحد، والأمة في اللغة أشياء،
فمنها الأمة الدين، وهو هذا،
والأمة القامة يقال فلان حسن الأمّة، أي حسن القامة.
قال الشاعر:
وأن معاوية الأكرمين
حسان الوجوه طوال الأمم أي طوال القامات، والأمة القرن من الناس، يقولون قد
مضت أمم أي قرون، والأمة الرجل الذي لا نظير له.
ومنه قوله عزّ وجلّ - {إنّ إبراهيم كان أمّة قانتا للّه حنيفا}
قال أبو عبيدة: معنى {كان أمّة} كان إماما، والأمة في اللغة النعمة والخير.
قال عدي بن زيد.
ثم بعد الفلاح والرشد والأمّة وارتهم هناك القبور.
أي: بعد النعمة والخير، وذكر أبو عمرو الشيباني أن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة فلان بأمّة، ومعناه
راجع إلى الخير والنعمة، لأن بقاء قوته من أعظم النعمة، وأصل هذا كله من
القصد، يقال أممت الشيء إذا قصدته، فمعنى الأمة في الدين أن مقصدهم مقصد
واحد، ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير له، أن قصده منفرد من قصد
سائر الناس.
ويروى أن زيد بن عدي
بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده وإنما ذلك لأنه أسلم في الجاهلية قبل
مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات موحدا فهذا أمة في وقته لانفراده،
وبيت النابغة:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة... وهل يأثمن ذو أمّة وهو طائع
ويروى ذو أمة، وذو إمة، ويحتمل ضربين من التفسير: ذو أمة: ذو دين وذو أمة: ذو نعمة أسديت إليه، ومعنى الأمة القامة: سائر مقصد الجسد.
فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممت أي قصدت، ويقال إمامنا هذا حسن الأمة أي يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك.
وقالوا في معنى الآية غير قول:
1- قالوا كان الناس فيما بين آدم ونوح عليهما السلام - كفارا، فبعث الله النبيين يبشرون من أطاع بالجنة، وينذرون من عصي بالنار،
2- وقال قوم: معنى كان الناس أمّة واحدة، كان كل من بعث إليه الأنبياء كفارا: {فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين}
ونصب (مبشّرين
ومنذرين) على الحال، فالمعنى أن أمم الأنبياء الذين بعث إليهم الأنبياء
كانوا كفارا - كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم.
وقوله عزّ وجلّ: {ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه}أي: ليفصل بينهم بالحكمة.
وقوله عزّ وجلّ: ({وما اختلف فيه إلّا الّذين أوتوه} أي: ما اختلف في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الذين أعطوا علم حقيقته.
وقوله: {بغيا بينهم} نصب (بغيا) على معنى مفعول له، المعنى لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي، لأنهم عالمون حقيقة أمره في كتبهم.
وقوله عزّ وجلّ: {فهدى اللّه الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ}أي: للحق الذي اختلف فيه أهل الزيغ.
وقوله عزّ وجلّ: {بإذنه}أي: بعلمه، أي: من الحق الذي أمر به.
وقوله عزّ وجلّ: {يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}أي: إلى طريق الدين الواضح، ومعنى (يهدي من يشاء): يدله على طريق الهدى إذا طلبه غير متعنت ولا باغ). [معاني القرآن: 1/282-285]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله
عز وجل: كان النّاس أمّةً واحدةً فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه
إلاّ الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم فهدى اللّه
الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى
صراطٍ مستقيمٍ (213) أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الّذين
خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضّرّاء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والّذين
آمنوا معه متى نصر اللّه ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ (214)
قال أبي بن كعب وابن زيد: المراد ب النّاس بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم، أي كانوا على الفطرة.
وقال مجاهد: «الناس آدم وحده».
وقال قوم: «آدم وحواء».
وقال ابن عباس وقتادة: النّاس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة، كانوا على الحق حتى اختلفوا فبعث الله تعالى نوحا فمن بعده.
وقال قوم: الناس نوح ومن في سفينته، كانوا مسلمين ثم بعد ذلك اختلفوا.
وقال ابن عباس أيضا:
كان الناس أمة واحدة كفارا، يريد في مدة نوح حين بعثه الله، وكان على هذه
الأقوال هي على بابها من المضي المنقضي، وتحتمل الآية معنى سابعا وهو أن
يخبر عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع
وجهلهم بالحقائق. لولا منّ الله عليهم وتفضله بالرسل إليهم، ف كان على هذا
الثبوت لا تختص بالمضي فقط، وذلك كقوله تعالى: وكان اللّه غفوراً رحيماً
[النساء: 96- 99- 100- 152، الفرقان: 70، الأحزاب: 5- 59، الفتح: 14]،
والأمة الجماعة على المقصد الواحد، ويسمى الواحد أمة إذا كان منفردا بمقصد،
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قس بن ساعدة: «يحشر يوم القيامة أمة
وحده»، وقرأ أبي بن كعب «كان البشر أمة واحدة»، وقرأ ابن مسعود «كان الناس
أمة واحدة فاختلفوا فبعث»، وكل من قدر النّاس في الآية مؤمنين قدر في
الكلام فاختلفوا، وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النّبيّين إليهم، وأول
الرسل على ما ورد في الصحيح في حديث الشفاعة نوح، لأن الناس يقولون له: أنت
أول الرسل، والمعنى إلى قوم كفار وإلا فآدم مرسل إلى بنيه يعلمهم الدين
والإيمان، ومبشّرين معناه بالثواب على الطاعة، ومنذرين معناه من العقاب على
المعاصي، ونصب اللفظتين على الحال، والكتاب اسم الجنس، والمعنى جميع
الكتب.
وقال الطبري: «الألف واللام في الكتاب للعهد، والمراد التوراة»، وليحكم مسند إلى الكتاب في قول الجمهور.
وقال قوم: المعنى ليحكم الله، وقرأ الجحدري «ليحكم» على بناء الفعل للمفعول، وحكى عنه مكي «لنحكم».
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وأظنه تصحيفا لأنه لم يحك عنه البناء للمفعول كما حكى الناس،
والضمير في فيه عائد على ما من قوله: فيما، والضمير في فيه الثانية يحتمل
العود على الكتاب ويحتمل على الضمير الذي قبله، والذين أوتوه أرباب العلم
به والدراسة له، وخصهم بالذكر تنبيها منه تعالى على الشنعة في فعلهم والقبح
الذي واقعوه. والبيّنات الدلالات والحجج، وبغياً منصوب على المفعول له،
والبغي التعدي بالباطل، و «هدى» معناه أرشد، وذلك خلق الإيمان في قلوبهم،
وقد تقدم ذكر وجوه الهدى في سورة الحمد، والمراد ب الّذين آمنوا. من آمن
بمحمد صلى الله عليه وسلم.
فقالت طائفة: معنى الآية: أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض فهدى الله أمة محمد التصديق بجميعها.
وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قولهم: إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا.
وقال ابن زيد: من
قبلتهم، فإن قبلة اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق، ومن يوم
الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيه
فهدانا الله له، فلليهود غد، وللنصارى بعد غد»، ومن صيامهم وجميع ما
اختلفوا فيه.
وقال الفراء: في
الكلام قلب، واختاره الطبري، قال: وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق مما
اختلفوا فيه. ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في
الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه، نحا
إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء.
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز
وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه، لأن قوله فهدى يقتضي أنهم
أصابوا الحق، وتم المعنى في قوله فيه، وتبين بقوله من الحقّ جنس ما وقع
الخلاف فيه.
قال المهدوي: «وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماما، إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وليس هذا عندي بقوي، وفي قراءة عبد الله بن مسعود «لما اختلفوا عنه من الحق» أي عن الإسلام.
وبإذنه قال الزجّاج:
معناه بعلمه، وقيل: بأمره، والإذن هو العلم والتمكين، فإن اقترن بذلك أمر
صار أقوى من الإذن بمزية، وفي قوله تعالى: واللّه يهدي من يشاء رد على
المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه). [المحرر الوجيز: 1/511-515]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({كان
النّاس أمّةً واحدةً فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم
الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الّذين
أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيًا بينهم فهدى اللّه الّذين آمنوا لما
اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ (213)}
قال ابن جريرٍ:
حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا أبو داود، أخبرنا همّام، عن قتادة، عن
عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان بين نوحٍ وآدم عشرة قرونٍ، كلّهم على
شريعةٍ من الحقّ. فاختلفوا، فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين. قال:
وكذلك هي في قراءة عبد اللّه: "كان النّاس أمّةً واحدةً فاختلفوا".
ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث بندار عن محمّد بن بشّارٍ. ثمّ قال: صحيحٌ ولم يخرّجاه.
وكذا روى أبو جعفرٍ
الرّازيّ، عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعبٍ: أنّه كان يقرؤها: "كان النّاس
أمّةً واحدةً فاختلفوا فبعث اللّه النّبيّيّن مبشّرين ومنذرين".
وقال عبد الرّزّاق:
أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: {كان النّاس أمّةً واحدةً} قال: كانوا على
الهدى جميعًا، "فاختلفوا فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين منذرين" فكان أوّل
نبي بعث نوحًا. وهكذا قال مجاهدٌ، كما قال ابن عبّاسٍ أوّلًا.
وقال العوفيّ، عن ابن عبّاسٍ: {كان النّاس أمّةً واحدةً} يقول: كانوا كفّارًا، {فبعث اللّه النّبيّين مبشّرين ومنذرين}
والقول الأوّل عن ابن
عبّاسٍ أصحّ سندًا ومعنًى؛ لأنّ النّاس كانوا على ملّة آدم، عليه السّلام،
حتّى عبدوا الأصنام، فبعث اللّه إليهم نوحًا، عليه السّلام، فكان أوّل
رسولٍ بعثه اللّه إلى أهل الأرض.
ولهذا قال: {وأنزل
معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا
الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيًا بينهم} أي: من بعد ما قامت
عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلّا البغي من بعضهم على بعضٍ، {فهدى اللّه
الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى
صراطٍ مستقيمٍ}
وقال عبد الرّزّاق:
حدّثنا معمر، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة في قوله: {فهدى
اللّه الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه} قال: قال النّبيّ
صلّى اللّه عليه وسلّم: "نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة، نحن أوّل
النّاس دخولًا الجنّة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم،
فهدانا اللّه لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه،
فهدانا له فالنّاس لنا فيه تبعٌ، فغدًا لليهود، وبعد غدٍ للنّصارى".
ثمّ رواه عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقال ابن وهبٍ، عن
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه في قوله: {فهدى اللّه الّذين آمنوا
لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه} فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتّخذ اليهود
يوم السّبت، والنّصارى يوم الأحد. فهدى اللّه أمّة محمّدٍ ليوم الجمعة.
واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النّصارى المشرق، واليهود بيت المقدس، فهدى
اللّه أمّة محمّدٍ للقبلة. واختلفوا في الصّلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد،
ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلّي وهو يتكلّم، ومنهم من يصلّي وهو
يمشي، فهدى اللّه أمّة محمّدٍ للحقّ من ذلك. واختلفوا في الصّيام، فمنهم من
يصوم بعض النّهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطّعام، فهدى اللّه أمّة محمّدٍ
للحقّ من ذلك. واختلفوا في إبراهيم، عليه السّلام، فقالت اليهود: كان
يهوديًّا، وقالت النّصارى: كان نصرانيًّا، وجعله اللّه حنيفًا مسلمًا، فهدى
اللّه أمّة محمّدٍ للحقّ من ذلك. واختلفوا في عيسى، عليه السّلام، فكذّبت
به اليهود، وقالوا لأمّه بهتانًا عظيمًا، وجعلته النّصارى إلهًا وولدًا،
وجعله اللّه روحه، وكلمته، فهدى اللّه أمّة محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم
للحقّ من ذلك.
وقال الرّبيع بن أنسٍ
في قوله: {فهدى اللّه الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه} أي:
عند الاختلاف أنّهم كانوا على ما جاءت به الرّسل قبل الاختلاف، أقاموا على
الإخلاص للّه عزّ وجلّ وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصّلاة وإيتاء
الزّكاة، فأقاموا على الأمر الأوّل الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا
الاختلاف، وكانوا شهداء على النّاس يوم القيامة شهودًا على قوم نوحٍ، وقوم
هودٍ، وقوم صالحٍ، وقوم شعيبٍ، وآل فرعون، أنّ رسلهم قد بلّغوهم، وأنّهم قد
كذّبوا رسلهم.
وفي قراءة أبيّ بن
كعبٍ: "وليكونوا شهداء على النّاس يوم القيامة، واللّه يهدي من يشاء إلى
صراطٍ مستقيمٍ"، وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشّبهات
والضّلالات والفتن.
وقوله: {بإذنه} أي:
بعلمه، بما هداهم له. قاله ابن جريرٍ: {واللّه يهدي من يشاء} أي: من خلقه
{إلى صراطٍ مستقيمٍ} أي: وله الحكم والحجّة البالغة. وفي صحيح البخاريّ
ومسلمٍ عن عائشة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا قام من
اللّيل يصلّي يقول: "اللّهمّ، ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات
والأرض، عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ
مستقيمٍ". وفي الدّعاء المأثور: اللّهمّ، أرنا الحقّ حقّا وارزقنا اتّباعه،
وأرنا الباطل باطلًا ووفّقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضلّ،
واجعلنا للمتّقين إمامًا). [تفسير ابن كثير: 1/569-571]
تفسير
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
اللَّهِ قَرِيبٌ (214)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ:
{أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم مسّتهم
البأساء والضّرّاء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى نصر
اللّه ألا إنّ نصر اللّه قريب}
معناه: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة.
وقوله عزّ وجلّ: {ولمّا يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم}.
معنى{مثل الذين}أي: صفة الذين، أي ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خلوا من قبلكم، و{خلوا} - مضوا.
{مسّتهم البأساء والضّرّاء} البأساء والضراء: القتل والفقر.
و {زلزلوا} معنى {زلزلوا} - خوّفوا وحركوا بما يؤذي،.
وأصل الزلزلة في اللغة:
من زل الشيء عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه، وكل
ما فيه ترجع كررت فيه فاء التفعيل، تقول أقل فلان الشيء إذا رفعه من مكانه
فإذا كرر رفعه ورده قيل قلقله، وكذا صل، وصلصل وصر وصرصر، فعلى هذا قياس
هذا الباب.
فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف.
وقوله عزّ وجلّ: {حتى يقول الرسول}. قرئت حتى يقول الرسول - بالنصب - ويقول - بالرفع.
وإذا نصبت بحتى فقلت سرت حتى أدخلها.
فزعم سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق بعلمهم أن هذا ينتصب على وجهين:
فأحد الوجهين:
أن يكون الدخول غاية السير، والسير والدخول قد نصبا جميعا، فالمعنى: سرت
إلى دخولها، وقد مضى الدخول، فعلى هذا نصبت الآية: المعنى وزلزلوا إلى أن
يقول الرسول. وكأنه حتى قول الرسول.
ووجهها الآخر: في النصب أعني سرت حتى أدخلها أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع، ويكون المعنى سرت كي أدخلها - وليس هذا وجه نصب الآية.
ورفع ما بعد حتى على وجهين، فأحد الوجهين هو وجه الرفع في الآية.
والمعنى سرت حتى
أدخلها، وقد مضى السير والدخول كأنّه بمنزلة قولك سرت فأدخلها. بمنزلة:
(سرت) فدخلتها، وصارت حتى ههنا مما لا يعمل في الفعل شيئا، لأنها تلي
الجمل، تقول سرت حتى أني داخل – وقول الشاعر:
فيا عجبا حتى كليب تسبّني... كأنّ أباها نهشل أو مجاشع
فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها.
والتأويل سرت حتى دخولها وعلى هذا وجه الآية.
ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد انقطع السير، تقول سرت حتى أدخلها الآن ما أمنع فهذه جملة باب حتى..
ومعنى الآية: أن الجهد قد بلغ بالأمم التي قبل هذه الأمة حتى استبطأوا النصر، فقال الله عزّ وجلّ: {ألا إنّ نصر اللّه قريب}.
فأعلم أولياءه أنّه ناصرهم لا محالة، وأن ذلك قريب منهم كما قال: {فإنّ حزب اللّه هم الغالبون}). [معاني القرآن: 1/285-287]
وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أموالهم بعدهم في بلادهم وفتنوا هم قبل ذلك، ومثل معناه شبه، فالتقدير شبه آتى الذين خلوا، والزلزلة شدة التحريك، تكون في الأشخاص وفي الأحوال، ومذهب سيبوية أن «زلزل» رباعي ك «دحرج».
وقال الزجّاج: «هو تضعيف في زل» فيجيء التضعيف على هذا في الفاء، وقرأ الأعمش «وزلزلوا ويقول الرسول» بالواو بدل حتى، وفي مصحف ابن مسعود «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول الرسول»، وقرأ نافع «يقول» بالرفع، وقرأ الباقون «يقول» بالنصب، ف حتّى غاية مجردة تنصب الفعل بتقدير إلى أن، وعلى قراءة نافع كأنها اقترن بها تسبيب فهي حرف ابتداء ترفع الفعل، وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين، ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك ولا ارتياب، والرّسول اسم الجنس، وذكره الله تعظيما للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا القول، وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ، فقدم الرسول في الرتبة لمكانته ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا تحكم، وحمل الكلام على وجهه غير متعذر، ويحتمل أن يكون ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول). [المحرر الوجيز: 1/515-517]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضّرّاء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى نصر اللّه ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ (214)}
يقول تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة} قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا، كما فعل بالّذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: {ولمّا يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضّرّاء} وهي: الأمراض؛ والأسقام، والآلام، والمصائب والنّوائب.
قال ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وأبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، ومرّة الهمداني، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع، والسّدّيّ، ومقاتل بن حيّان: {البأساء} الفقر. قال ابن عبّاسٍ: {والضّرّاء} السّقم.
{وزلزلوا} خوفًا من الأعداء زلزالا شديدًا، وامتحنوا امتحانًا عظيمًا، كما جاء في الحديث الصّحيح عن خبّاب بن الأرتّ قال: قلنا: يا رسول اللّه، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو اللّه لنا؟ فقال: "إنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه". ثمّ قال: "واللّه ليتمّنّ اللّه هذا الأمر حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلّا اللّه والذّئب على غنمه، ولكنّكم قومٌ تستعجلون".
وقال اللّه تعالى: {الم* أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون* ولقد فتنّا الّذين من قبلهم فليعلمنّ اللّه الّذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين} [العنكبوت: 1 -3].
وقد حصل من هذا جانبٌ عظيمٌ للصّحابة، رضي اللّه عنهم، في يوم الأحزاب، كما قال اللّه تعالى: {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنّون باللّه الظّنونا* هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدًا* وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا اللّه ورسوله إلا غرورًا} الآيات [الأحزاب: 10 -12].
ولمّا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرّسل تبتلى، ثمّ تكون لها العاقبة .
وقوله: {مثل الّذين خلوا من قبلكم} أي: سنّتهم. كما قال تعالى: {فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا ومضى مثل الأوّلين} [الزّخرف: 8].
وقوله: {وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى نصر اللّه} أي: يستفتحون على أعدائهم، ويدعون بقرب الفرج والمخرج، عند ضيق الحال والشّدّة. قال اللّه تعالى: {ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ} كما قال: {فإنّ مع العسر يسرًا إنّ مع العسر يسرًا} [الشّرح: 5، 6].
وكما تكون الشّدّة ينزل من النّصر مثلها؛ ولهذا قال تعالى: {ألا إنّ نصر اللّه قريبٌ} وفي حديث أبي رزين: "عجب ربّك من قنوط عباده، وقرب غيثه فينظر إليهم قنطين، فيظلّ يضحك، يعلم أنّ فرجهم قريبٌ" الحديث). [تفسير ابن كثير: 1/571-572]
تفسير
قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {يسألونك
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين
وابن السّبيل وما تفعلوا من خير فإنّ اللّه به عليم}
قيل إنهم كانوا سألوا: على من ينبغي أن يفضلوا - فأعلم اللّه عزّ وجل أن أول من تفضّل عليه الوالدان والأقربون، فقال: {قل ما أنفقتم من خير} أي: من مال: {فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السّبيل وما تفعلوا من خير فإنّ اللّه به عليم} أي: يحصيه، وإذا أحصاه جازى عليه، كما قال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} أي: يرى المجازاة عليه، لأن رؤية فعله الماضي لا فائدة فيه.
ولا يرى لأنه قد مضى.
ومعنى " ماذا " في اللغة على ضربين:
فأحدهما:
أن يكون " ذا " في معنى الذي، ويكون ينفقون من صلته، المعنى يسألونك أي
شيء الذي ينفقون كأنه أي شيء وجه الذي ينفقون، لأنهم يعلمون ما المنفق
ولكنهم أرادوا علم اللّه وجهه.
ومثل جعلهم " ذا " في معنى الذي قول الشاعر:
عدس ما لعبّاد عليك إمارة... أمنت وهذا تحملين طليق
والمعنى: والذي تحملينه طليق، فيكون ما رفعا بالابتداء، ويكون ذا خبرها.
وجائز أن يكون: " ما " " مع " " ذا " بمنزلة اسم واحد، ويكون الموضع نصبا بـ (ينفقون).
المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون، وهذا إجماع النحويين، وكذلك الوجه الأول إجماع أيضا، ومثل جعلهم ذا بمنزلة اسم واحد، قول
الشاعر:
دعي ماذا علمت سأتقيه... ولكن بالمغيب فنبئيني
كأنه بمنزلة: دعي الذي علمت.
وجزم (وما تفعلوا) بالشرط، واسم الشرط " ما " والجواب (فإنّ اللّه به عليم) وموضع " ما " نصب بقوله (تفعلوا) ). [معاني القرآن: 1/287-288]
السائلون هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لزم إنفاقه، و «ما» يصح أن تكون في موضع رفع على الابتداء، و «ذا» خبرها، فهي بمعنى الذي، وينفقون صلة، وفيه عائد على «ذا» تقديره ينفقونه، ويصح أن تكون ماذا اسما واحدا مركبا في موضع نصب ب ينفقون، فيعرى من الضمير، ومتى كانت اسما مركبا فهي في موضع نصب لا ما جاء من قول الشاعر: [الطويل].
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا = سوى أن يقولوا إنّني لك عاشق
فإن عسى لا تعمل، فماذا في موضع رفع وهو مركب إذ لا صلة لذا.
قال قوم: هذه الآية في الزكاة المفروضة، وعلى هذا نسخ منها الوالدان ومن جرى مجراهما من الأقربين.
وقال السدي: «نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة، ثم نسختها الزكاة المفروضة»، ووهم المهدوي على السدي في هذا فنسب إليه أنه قال إن الآية في الزكاة المفروضة، ثم نسخ منها الوالدان، وقال ابن جريج وغيره: هي ندب، والزكاة غير هذا الإنفاق، فعلى هذا لا نسخ فيها، واليتم فقد الأب قبل البلوغ، وتقدم القول في المسكين وابن السّبيل، وما تفعلوا جزم بالشرط، والجواب في الفاء، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب، وظاهر الآية الخبر، وهي تتضمن الوعد بالمجازاة). [المحرر الوجيز: 1/517-518]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السّبيل وما تفعلوا من خيرٍ فإنّ اللّه به عليمٌ (215)}
قال مقاتل بن حيّان: هذه الآية في نفقة التّطوّع. وقال السّدّيّ: نسختها الزّكاة. وفيه نظرٌ. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عبّاسٍ ومجاهدٌ، فبيّن لهم تعالى ذلك، فقال: {قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السّبيل} أي: اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث: "أمّك وأباك، وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك". وتلا ميمون بن مهران هذه الآية، ثمّ قال: هذه مواضع النّفقة ما ذكر فيها طبلًا ولا مزمارًا، ولا تصاوير الخشب، ولا كسوة الحيطان.
ثمّ قال تعالى: {وما تفعلوا من خيرٍ فإنّ اللّه به عليمٌ} أي: مهما صدر منكم من فعل معروفٍ، فإنّ اللّه يعلمه، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ فإنّه لا يظلم أحدًا مثقال ذرّة). [تفسير ابن كثير: 1/572]
* للاستزادة ينظر: هنا