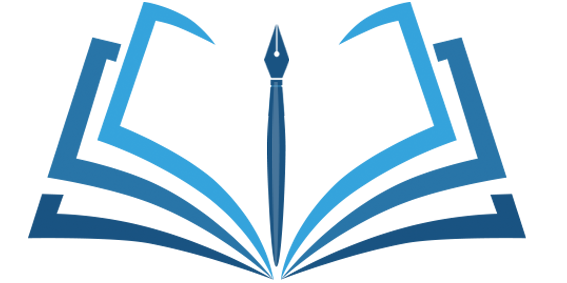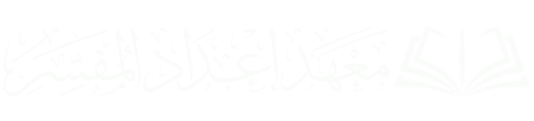الصفحة الرئيسة
/
الدورات
/
المهارات المتقدمة في التفسير
/
الدرس الثالث: استخلاص المسائل التفسيرية من الآيات القرآنية
الصفحة الرئيسة
/
الدورات
/
المهارات المتقدمة في التفسير
/
الدرس الثالث: استخلاص المسائل التفسيرية من الآيات القرآنية

المهارات المتقدمة في التفسير
القسم الأول
الدرس الثالث: استخلاص المسائل التفسيرية من الآيات القرآنية

المهارات المتقدمة في التفسير
القسم الأول
الدرس الثالث: استخلاص المسائل التفسيرية من الآيات القرآنية
9 Oct 2017
أتتـنـا من لتبيينٍ، وبَعْضٍ ... وتعـــــليــــــــــــــــــل، وبدء، وانتهاء
عناصر الدرس:
1. تمهيد
2. التحصيل العلمي قائم على استخلاص المسائل وعقل أجوبتها
3. فوائد استخراج المسائل من الآيات مباشرة
4. أدوات استخراج المسائل التفسيرية
5. أقسام الأدوات المعرفية التي يستعان بها على استخراج المسائل
6. الأمثلة
7. التطبيقات
1. تمهيد
من المهارات التي ينبغي لطالب علم التفسير أن يجتهد في تحصيلها مهارة استخلاص المسائل التفسيرية من الآيات القرآنية مباشرة، وهي
من المهارات المهمّة التي تفتح لطالب العلم أبواباً عظيمة النفع في فهم
القرآن، وإدراك معاني كلام المفسّرين، وطرقهم في استخراج المسائل والبيان
عنها.
وإذا
بلغ الطالب مرتبة يتمكن بها من استخراجٍ شِبْه وافٍ لمسائل الآيات التي
يفسّرها قبل أن يطّلع على كلام المفسّرين فيها فقد أوتي ملكَة عظيمة النفع
في دراسة مسائل التفسير.
وبلوغ هذه المرتبة يتطلّب
تمريناً وتدرّجاً وطول نفس حتى يتهيأ للطالب اكتساب هذه المهارة
والبراعة فيها، ثمّ إذا حذقها احتاج إلى المحافظة عليها وتنميتها بالمداومة
على استعمالها في دراسة مسائل التفسير.
وأصل هذه المهارة مَلَكة ذهنيّة تقود صاحبها إلى إدراك دلائل المسائل
العلمية وطرق استخراجها، وتُبَصّره بأنواعها ومراتبها، ثمّ ينمّيها
بالتدريب، ويهذّبها إشرافُ المعلّم وتوجيهُه، ولا يزال الطالب يزداد بها
علماً وفهماً حتى تتقوّى ملكتُه وتنضج معرفتُه إلى أن يبلغ بعون الله
تعالى وتوفيقه مرتبةَ الرسوخ في هذا العلم.
ومن دلائل إتقان الطالب لهذه المهارة حسن معرفته بسؤال أهل العلم؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت: فقيه هو أو غير فقيه) رواه ابن أبي شيبة.
فالسؤال قبل أن يجري
على اللسان أصله في القلب، وهو مترجِمٌ عن فَهْمِ المرء ومَبْلَغ علمه؛
فسؤال الفقيه يدلّ على فقهه وفهمه؛ فيسأل حين يسأل وهو يعرف سبب السؤال
وفائدته ويدرك حاجته لمعرفة جوابه، ويصيب بسؤاله المحزّ ويطبّق المفصَل،
ويستدلّ بجواب المسألة على معرفة نظائرها وأشباهها؛ فإذا سأل عن مسألة
وعرف جوابها لم يحتج إلى السؤال عن نظائرها.
وقد يَطرح الطالبُ
السؤالَ على عالم ليفيده بجوابه، وقد يسأل نفسه ليبحث عن جواب سؤاله حتى
يجده بالنظر والتأمّل وقراءة كتب أهل العلم.
ومن جمع بين حسن السؤال وحسن الفهم والضبط وداوم على ذلك فإنه يصيب علماً كثيراً يصل به إلى مرتبة العلماء بإذن الله تعالى.
وهذه كانت طريقة كبار الأئمة وحذّاق العلماء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كان لي لسان سَؤول وقَلب عَقُول، وما نزلت آية إلا علمت فيم نزلت، وبم نزلت، وعلى من نزلت). رواه ابن سعد في الطبقات والبيهقي في القضاء والقدر واللفظ له وأبو نعيم في حلية الأولياء.
وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن مغيرة بن مقسم قال: قيل لابن عباس: كيف أصبت هذا العلم؟
قال: (بلسان سؤول وقلب عقول).
وفي البداية والنهاية لابن كثير أن مغيرة روى هذا الخبر عن الشعبي.
وفي التدوين في أخبار قزوين للرافعي: مغيرة عن إبراهيم النخعي.
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعوا ابن عبّاس!
قال: ( ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول ).
وقال ابن أبي حاتم: سمعت البخاريّ يقول: (لم تكن
كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء؛ كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته
ونسبته وحَمْلَه الحديثَ إن كان الرجل فَهِما؛ فإن لم يكن سألته أن يخرج
إليَّ أصلَه ونسخته، فأمّا الآخرون لا يبالون ما يكتبون، وكيف يكتبون).
وهذا من دلائل فقه البخاري؛ ومن أسباب تقدّمه في معرفة الحديث، وتمييز صحيحه من ضعيفه، وبَصَرِه بطرقه وعلله ورجاله وأحوالهم.
وهذه الملكة تتنوّع آثارها بتنوّع العلوم التي يطلبها الطالب، وأصلها واحد،
وهو أن يستخلص الطالب المسائل في ذلك العلم، ويعرف مأخذ كلّ مسألة،
والحاجة إلى فقهها، وتمييز دلائلها.
2. التحصيل العلمي قائم على استخلاص المسائل وعقل أجوبتها:
ومن جمع قلباً يعي مسائل العلم ويعقلها، ولساناً سؤولاً فإنّه يحصّل علماً غزيراً مباركاً بإذن الله تعالى، وبيان ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن
اللسان السؤول هو الذي يكون صاحبه كثير السؤال، لأنّ هذه الصيغة تفيد
المبالغة، لكنّها كثرة على فقه وتفهّم؛ فهي مداومة على الأسئلة الحسنة وعلى
ضبط جواباتها بالعقل والفهم والتقييد، وهذا سبب عظيم لكثرة العلم وبركته؛
فإنّ أحبَّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ، وطلب العلم من أحبّ الأعمال
إلى الله؛ فمن داوم عليه فقد داوم على عمل من أحبّ الأعمال إلى الله،
فيرجى له البركة في علمه؛ فهو كمثل مَن يريد أن يبني بناء كبيراً ، فينجز
كلّ يوم مرحلة منه ؛ ويداوم على ذلك فإنّه يتمّ بنيانه بإذن الله ويجمد
عاقبة عمله ومداومته عليه.
والوجه الثاني:
أنّ من يعقل أنواع المسائل ويحسن ترتيبها وتصنيفها ومعرفة أوجه التناسب
بينها، تتوسّع مداركه، وتنمو قوّته الذهنية بسبب كثرة تمرّنه على استثارة
المسائل، وتيقّظه لما يستجدّ له من أنواع المسائل، فيعرف أحكامها بنظائرها
وأشباهها، ويعرف أحكام ما يضادّها وينافيها، ويعرف كيف يُرجع المسائل إلى
أصولها، وكيف يستدل لها، ويُبصر مآخذ أقوال العلماء، ومن أين يستخرجها؛
وهذه المعارف الجليلة هي أبواب عظيمة النفع للتحصيل العلمي الغزير المبارك؛
فلا يحصر الطالب تحصيله العلمي فيما يدرسه بالتلقين أو بالتلخيص من الكتب.
وقد سبق ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما: (ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت: فقيه هو أو غير فقيه) لأنّ الفقيه يعرف متى يسأل، ولمَ يسأل، وكيف يسأل، ثمّ
إذا سأل عن مسألة ضبط جوابها، وعرف وجهه، واستفاد منه في نظائر تلك
المسألة، فتظهر له مسائل تدل على فقهه، وتفتح له أبواباً من العلم والفهم.
وإذا
جمع الدارس هذين الأمرين فإنّه يرجى له أن يُرزق غزارة العلم وحسن الفهم
مع ما يُرجى له من البركة العظيمة في العلم بالمداومة والتفهّم.
ولو أحسن الطالب دراسة مسألتين في اليوم؛ فإنّه لا يمضي عليه ثلاث سنوات حتى يتقن أكثر من ألفي مسألة!!
وبعض العلوم يكفي لضبطها أقلّ من ألف مسألة.
وهذا في المسائل المنصوصة التي درسها نصّاً؛ وقد يتضاعف العدد أضعافاً إذا ألحق بهذه المسائل أشباهها ونظائرها، ولوازمها وآثارها.
وقد يجد من دراسته لبعض
المسائل حاجته لدراسة بعض العلوم لكثرة ما يرى من اعتماد الدراسة عليها
في عدد كبير من المسائل؛ فيعتني بضبط مختصر في ذلك العلم ليعرف أصوله
وقواعده وطريقة دراسة مسائله فينفتح له بذلك أبواب من العلم النافع.
3. فوائد استخراج المسائل من الآيات مباشرة:
وحديثنا في هذا الدرس
عن مهارة مهمّة من مهارات التفسير، وهي مهارة استخلاص مسائل التفسير من
الآيات القرآنية قبل الاطلاع على كلام المفسّرين، ومعرفة الأدوات التي
يستعملها المفسّرون لاستخراج تلك المسائل، وبيان فائدة ذلك لطالب العلم من جانبين:
الجانب الأول: أنّها تعينه على حسن تدبّر القرآن واستخراج علومه وفهم معانيه، وقد صحّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أراد العلم فليثوّر القرآن فإنّ فيه علم الأوّلين والآخرين). رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الكبير.
قال ابن الأثير: (أي لينقّر عنه ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته).
والجانب الآخر:
أنها تكمّل له النقص الذي يلحظه في المسائل التي يتناولها بعض المفسرين
عند تفسير الآية اختصاراً؛ فيكتسب علماً يضيفه إلى ما استخلصه من كلام
المفسّرين في الآية؛ فيكتمل له بنيان تفسير الآية اكتمالاً حسناً بإذن الله
تعالى.
ذلك أنّه إذا اجتهد في
استخراج المسائل المتعلّقة بالآية ثم قرأ كلام المفسّرين في تفسيرها فإنّه
قد يجد في كلام المفسّرين مسائل لم تكن قد خطرت على باله عند تأمّله
للآية، فيضيفها إلى المسائل التي استخرجها ويضعها في موضعها المناسب.
ثمّ قد تذكّره هذه
المسائل بمسائل أُخَر كانت غائبة عنه، ولا يزال يتدرّب على هذه المهارة حتى
يتيسّر له معرفة كثير من المسائل التفسيرية بإذن الله.
ثمّ إذا أحسن التمرّن على هذه المهارة فإنّه قد يستخرج مسائل مهمّة قد لا
يذكرها عدد من المفسّرين في ذلك الموضع، فيبحث عنها في مظانّها، وتكتمل له
مسائل الآية بإذن الله.
4. أدوات استخراج المسائل التفسيرية:
للمفسّرين أدوات علمية
يستعملونها لاستخراج المسائل التفسيرية على تفاوت بينهم في استعمالها
بتفاوت معارفهم وعناياتهم العلمية، وبتفاوت غرضهم من التفصيل في تفاسيرهم.
وقد حرصت على التعرّف تلك الأدوات العلمية وتصنيفها وتقريبها لطلاب العلم
وشرحها بالأمثلة في دورة علمية نشرتها في موقع معهد آفاق التيسير بعنوان
"السبيل إلى فهم القرآن" وأرجو أن تخرج في كتاب قريباً إن شاء الله تعالى.
وسأذكر هنا أهمّ تلك الأدوات بشيء من التلخيص والتفصيل المقتضب ليتدرّب
الطالب على استعمال ما يتيسّر له منها ، ويعرف مصادر استمدادها وكيف
يستزيد منها.
فمن تلك الأدوات:
1: بيان معاني المفردات؛ وهو من أظهر الأدوات في التفسير؛ كتفسير الغريب وتعيين المراد بالمشترك اللفظي.
2: بيان معاني الأساليب والتراكيب؛ فمعنى الكلمة عند الإفراد قد يختلف عن
معناها إذا رُكّبت في جملة، والجمل قد يختلف معناها باختلاف الأساليب، وقد
يقع بين بعض الأساليب اشتباه فيختلف المفسرون في المراد من الجملة؛ كما
اختلفوا في قوله تعالى: {فما أصبرهم على النار} هل هي على الاستفهام أو التعجب؟ على قولين؛ مع أنّ هذه الجملة ليس فيها كلمة تحتاج إلى تفسير عند الإفراد.
ومعرفة الأساليب ومعانيها من المعارف المهمّة لطالب العلم، وسبيل معرفتها دراسة علم المعاني وهو من فروع علم البلاغة.
وخلاصة ما يحصل به تصوّر المراد بالأساليب أنها تنقسم إلى أساليب خبرية
وأساليب إنشائية؛ فالأساليب الخبرية ترد لمعانٍ كثيرة كالتقرير والتحقيق
والتحذير والإغراء والتلطّف والتوبيخ والفخر والاسترحام وغيرها من الأساليب
التي يُفهم معناها بدلالة تركيب الجملة وليس لمجرّد الدلالة المفردة
للألفاظ.
والأساليب الإنشائية تنقسم إلى قسمين:
- أساليب إنشائية طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني.
- وأساليب إنشائية غير طلبية كالتعجب والقَسم والمدح والذم.
ومعرفة هذه الأساليب ومعانيها تفيد طالب العلم في استخراج أنواع كثيرة من
المسائل، وتبيّن له عدداً من الأوجه البلاغية التي لا يدركها إلا بدراسة
علم المعاني من علوم البلاغة.
3: بيان معاني الحروف، وهو من الأدوات المعرفية المهمّة في التفسير، وقد
أفرده بعض أهل العلم بالتأليف لأهميّته ، فالحرف الواحد قد يرد لمعانٍ
متعددة؛ فيختلف المراد باختلاف معنى الحرف، فالباء – مثلاً - قد تأتي
للسببية والمصاحبة والملابسة والظرفية والبدل والحال والقسم والتعدية
وغيرها.
و(مِن) قد تكون بيانية أو تبعيضية أو سببية أو استغراقية أو بدلية أو ابتدائية أو لانتهاء الغاية، أوغير ذلك من المعاني.
وقد نظم معانيها ابن أمّ قاسم المرادي في كتابه الجنى الداني بقوله:
وإبدال، وزائدة، وفصل ... ومعنى عن، وفي، وعلى، وباء
ومعرفة معاني الحروف وأثرها في بيان معنى الآية وتوجيه بعض الأقوال فيها نافعة جداً لطالب علم التفسير.
ولذلك يوصى الطالب بدراسة كتاب في معاني الحروف كالجنى الداني للمرادي، أو
رصف المباني للمالقي، أو مغني اللبيب لابن هشام، ومن أراد الاختصار فليقرأ
منظومة "كفاية المُعاني" للبيتوشي وشرحها.
وقد جمعنا في موقع "جمهرة العلوم" معاني الحروف من نحو عشرين كتاباً،
ورتّبناها على الحروف، ثمّ رتّبنا أقوال العلماء على التسلسل التاريخي،
ووضعنا لهذا العملِ دليلاً تجدونه ( هنا ) فيمكن الاستفادة منه.
ثمّ يحسن بطالب العلم الجادّ أن يكون له اطلاع متكرر على القسم المختص
بمعاني الحروف من كتاب "دراسات في أسلوب القرآن الكريم" للأستاذ محمّد عبد
الخالق عضيمة، وهو ( هنا ) منظّما ومرتّباً؛
فإنّه قدّم لدراسة كلّ حرف من الحروف الواردة في القرآن الكريم مقدّمة ذكر
فيها خلاصة بحثه عن معاني ذلك الحرف في القرآن الكريم.
4: بيان مرجع الضمير واسم الإشارة ونحوهما إن وجدا في الآية.
5: بيان المراد بالاسم المبهم إن وجد.
6: بيان مقصد الآية.
7: بيان دلالة منطوق الخطاب.
8: بيان دلالة المفهوم، وهو على نوعين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
9: بيان لوازم المعنى وآثاره.
10: بيان معنى الإضافة إن وجدت.
11: بيان متعلّق الفعل؛ فإذا كان في الآية فعل؛ اجتهد في معرفة نوع هذا
الفعل هل هو لازم أو متعدٍّ؟ ، وإذا كان متعدّيا فما هو مفعوله؟ ، وما هو
فاعله إذا لم يسمّ في الآية؟
12: معرفة دواعي الذكر والحذف، والإضمار في موضع الإظهار، والإظهار في موضع الإضمار.
13: معرفة أسباب التقديم والتأخير.
14: معرفة أسباب التعريف والتنكير.
15: معرفة أسباب الإطلاق والتقييد.
16: معرفة معاني الاختصاص والقصر.
17: معرفة معنى الاستثناء وهل هو متصل أو منقطع؟
18: معرفة معاني صيغ الأمر والنهي والاستفهام.
19: معرفة معاني أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.
20: معرفة أوجه التناسب كمناسبة الآية لما قبلها أو مناسبة أول السورة لآخرها وغير ذلك من أوجه التناسب.
5. أقسام الأدوات المعرفية التي يستعان بها على استخراج المسائل:
وهذه الأدوات المعرفية التي يستعان بها على استخراج المسائل والمعاني يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام:
القسم الأول:
يُعرف بدراسة أصول التفسير وعلوم القرآن ، ثم التدرّب على تطبيق أصول
التفسير عند دراسة مسائل الآية، وكذلك التدرّب على معرفة ما يتعلّق ببعض
أنواع علوم القرآن من مسائل الآية.
والقسم الثاني: يُعرف بدراسة أصول الفقه، ومن المفيد للطالب أن يدرس كتاباً مختصراً في أصول الفقه كالورقات للجويني، ثمّ يدرس كتاباً أوسع منه كجمع الجوامع للسبكي أو روضة الناظر لابن قدامة المقدسي.
والقسم الثالث: يُعرف بدراسة علم البلاغة، ويوصى الطالب أن يدرس في البلاغة كتاباً مختصراً، ومن أجمع الكتب المختصرة وأجودها كتاب "دروس البلاغة"؛ ثمّ يقرأ كتابي عبد القاهر الجرجاني "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز".
والقسم الرابع: يعرف بدراسة بعض العلوم اللغوية كالنحو والصرف ومعاني الحروف والاشتقاق.
والقسم الخامس: يدرك بحسن النظر والتأمّل والاستنتاج وإعمال القواعد العقلية التي تُدرك بها المعاني.
6. الأمثلة
المثال الأول: مسائل تفسير قول الله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}
· من المخاطب في الآية؟
· ما مقصد الآية؟
· معنى القراءة
· كيف يُؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة وهو أميّ؟
· ما متعلّق القراءة؟ [أي: يقرأ ماذا؟]
· معنى الباء في قوله: {باسم}
· كيف تكون القراءة باسم الله؟
· معنى الإضافة في قوله تعالى: {ربّك}
· معنى الربوبية
· معنى الاسم الموصول في الآية
· الحكمة من الاقتصار على ذكر الخلق وهو أحد أفراد الربوبية
· الحكمة من التعبير عن الخلق بالفعل الماضي (خلق) دون غيره من الصيغ.
المثال الثاني: مسائل تفسير قول الله تعالى: {تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير}
· معنى قوله تعالى: {تبارك}
· ما تفيده صيغة "تفاعل" في الآية.
· معنى البركة
· معنى الاسم الموصول في الآية
· إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله
· معنى الباء في قوله: {بيده}
· ما يفيده تقديم الجار والمجرور في قوله: {بيده الملك}
· معنى التعريف في قوله: {الملك}
· معنى الواو في قوله: {وهو }
· ما يفيده حرف الاستعلاء {على}
· دلالة لفظ "كل" على العموم.
· معنى "شيء"
· معنى "قدير"
· ما يفيده الجمع بين صفتي الملك والقدرة
· مقصد الآية
المثال الثالث: مسائل تفسير قول الله تعالى: {ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون}.
· معنى الواو
· معنى اللام وقد
· سبب التعبير بضمير الجمع في قوله: {أنزلنا}
· دلالة لفظ الإنزال على علوّ الله تعالى
· سبب تعدية فعل الإنزال بـ{إلى} دون {على}
· مرجع الضمير في قوله: {إليك}
· سبب الالتفات إلى الخطاب في هذه الآية
· المراد بالآيات البيّنات
· معنى كون الآيات بيّنات
· معنى الكفر بالآيات
· معنى الواو في قوله: {وما يكفر بها إلا الفاسقون}
· معنى الحصر في قوله: {وما يكفر بها إلا الفاسقون}
· المراد بالفسق في الآية
· دلالة الآية على سبيل السلامة من الفسق
· مقصد الآية
7. التطبيقات
اختر تطبيقاً من التطبيقات التالية واستخرج مسائله:
التطبيق الأول: مسائل تفسير قول الله تعالى: {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم}
التطبيق الثاني: مسائل تفسير قول الله تعالى: {قل إن الله يضلّ من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب}
التطبيق الثالث: مسائل تفسير قول
الله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل
عليكم من خير من ربّكم والله يختصّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم}
تعليمات:
1: على الطالب أن
يستخرج المسائل من الآيات مباشرة دون الاطلاع على أي مرجع آخر، ثم يدوّن
تلك المسائل، ثمّ يرجع إلى بعض التفاسير لينظر في ما فاته من المسائل وما
خطر له بعد اطّلاعه على كلام المفسّرين؛ ثم يدوّن المسائل تامة بعد ذلك.
2: من التفاسير التي أوصي بالاطلاع عليها: تفسير ابن جرير، وتفسير ابن عطيّة، وتفسير ابن كثير، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وأضواء البيان للشنقيطي، وروح المعاني للألوسي.