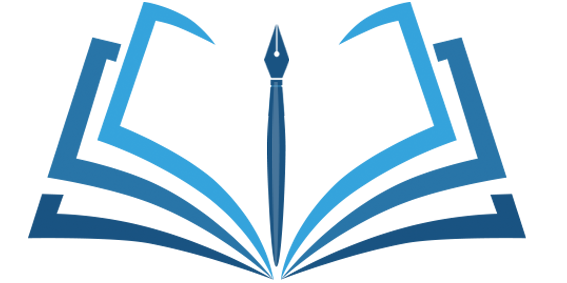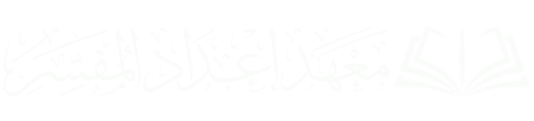تفسير سورة النساء
القسم التاسع
تفسير سورة النساء [ من الآية (102) إلى الآية (104) ]

تفسير سورة النساء
القسم التاسع
تفسير سورة النساء [ من الآية (102) إلى الآية (104) ]
18 Nov 2018
تفسير
قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ
فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً
وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
(102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ
الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَّوْقُوتًا (103) وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن
تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا (104)}
تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم
مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ
مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ
فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ
الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم
مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (102)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ):
(وقوله: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم
يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنّ اللّه
أعدّ للكافرين عذابا مهينا (102)
(وإذا كنت فيهم) هذه الهاء والميم يعودان على المؤمنين. أي وإذا كنت أيها النبي في المؤمنين في غزواتهم وخوفهم.
(فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا).
أي فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك.
(فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم).
جائز أن يكون - واللّه أعلم - ولتأخذ الجماعة حذرهم وأسلحتهم.
ويجوز أن يكون الذين هم
وجاه العدو يأخذون أسلحتهم، لأن من في الصلاة غير مقاتل، وجائز أن تكون
الجماعة أمرت بحمل السلاح وإن كان بعضها لا يقاتل لأنه أرهب للعدو وأحرى
ألا يقدم على الحذرين المتيقظين المتاهبين للحرب في كل حال.
وقد اختلف الناس في صلاة
الخوف فزعم مالك بن أنس أن أحب ما روي فيها إليه أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قام يصلي وقامت خلفه طائفة من المؤمنين وطائفة وجاه العدو، فصلى
بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى وسلّمت، وهو -
صلى الله عليه وسلم - واقف، ثم انصرفت وقامت وجاه العدو، والنبي - صلى
الله عليه وسلم – واقف في
الصلاة، وأتت الطائفة التي كانت وجاه العدو، فصلّى بهم ركعة ثانية له،
وهي الأولى لهذه الطائفة الأخرى - وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم -
وقاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو - صلى الله عليه وسلم - قاعد، وقعدوا
في الثانية فسلم وسلموا بتسليمه، فصلت كل طائفة منهم ركعتين، وصلّى النبي -
صلى الله عليه وسلم - ركعتين.
وقال مالك: هذا أحب ما روي في صلاة الخوف إليّ.
وأمّا أسلحة فجمع سلاح مثل
حمار وأحمرة. وسلاح اسم لجملة ما يدفع الناس به عن أنفسهم في الحروب مما
يقاتل به خاصّة، لا يقال للدواب وما أشبهها سلاح.
فأمّا (وليأخذوا) فالقراءة على سكون اللام -.. (وليأخذوا)
و(وليأخذوا) هو الأصل بالكسر إلا أن الكسر استثقل فيحذف استخفافا.
وحكى الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك ليجلس.
فقالوا لنجلس ففتحوا، وهذا خطأ،. لا يجوز فتح لام الأمر لئلا تشبه لام التوكيد.
وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك: المال لزيد.
تقول: المال لزيد وهذه
الحكاية في الشذوذ كالأولى، لأن الإجماع والروايات الصحيحة كسر لام الجر
ولام الأمر، ولا يلتفت إلى الشذوذ، خاصة إذا لم يروه النحويون القدماء
الذين هم أصل الرواية، وجميع من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا
صادقون في الرواية، إلا أن الذي سمع منهم مخطئ.
وقوله: (ولا جناح عليكم) الجناح
الإثم، وتأويله من جنحت إذا عدلت عن المكان أي أخذت جانبا عن القصد،
فتأويل لا جناح عليكم أي لا تعدلون عن الحق إن وضعتم أسلحتكم.
(إن كان بكم أذى من مطر).
و (أذى) مقصورة، تقول أذى يأذى أذى، مثل فزع يفزع فزعا.
وموضع (أن تضعوا) نصب. أي لا إثم عليكم في أن تضعوا، فلما سقطت " في " عمل ما قبل (أن) فيها، ويجوز أن يكون موضعها جرا بمعنى في).
[معاني القرآن: 2/97-99]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم الآية قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي عليه السلام، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة، وقال أبو يوسف وإسماعيل بن علية: الآية خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة بإمامة النبي عليه السلام لا عوض منها، وغيره من الأمراء منه العوض، فيصلي الناس بإمامين، طائفة بعد طائفة، ولا يحتاج إلى غير ذلك.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلى في الحضر إذا نزل الخوف، وقال قوم: لا صلاة خوف في حضر، وقاله في المذهب عبد الملك بن الماجشون، وقال الطبري: فأقمت لهم معناه: حدودها وهيئتها، ولم تقصر على ما أبيح قبل في حال المسايفة، وقوله فلتقم طائفةٌ منهم معك، أمر بالانقسام، أي وسائرهم وجاه العدو حذرا وتوقع حملته، وأعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب وخصفة، وفي بعض الروايات: أنها نزلت في ناحية عسفان وضجنان، والعدو: خيل قريش، عليها خالد بن الوليد، واختلف من المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل الطائفة المصلية، وقيل: بل الحارسة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولفظ الآية يتناول الكل، ولكن سلاح المصلين ما خف، واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي عليه السلام بأصحابه صلاة الخوف، وبحسب ذلك اختلف الفقهاء، فروى يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، وروى القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل هذا الحديث بعينه، إلا أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلّى بالطائفة الأخيرة ركعة، سلم، ثم قضت هي بعد سلامه، وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله في صلاة الخوف، كان أولا يميل إلى رواية يزيد بن رومان، ثم رجع إلى رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر، وروى مجاهد وغيره عن ابن عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت على خلاف فيه: أن النبي عليه السلام صلّى صلاة الخوف بعسفان والعدو في قبلته، قال: فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، فقالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بين الظهر والعصر بهذه الآيات، وأخبره خبرهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف العسكر خلفه صفين، ثم كبر فكبروا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم، ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي فسجد الصف الذي يليه، فلما رفع سجد الآخرون، ثم سلم فسلموا جميعا، ثم انصرفوا، قال عبد الرزاق بن همام في مصنفه: وروى الثوري عن هشام مثل هذا، إلا أنه قال: ينكص الصف المقدم القهقرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود، ويتقدم الآخرون فيسجدون في مصاف الأولين، قال عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال: لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف إلا مرتين، مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم، ومرة بعسفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وظاهر اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه صلى صلاة الخوف في غير هذين الموطنين، وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة خوف، وروى عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي عليه السلام ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في حين واحد، وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ أشهب رحمه الله، ومشى على الأصل في أن لا يقضي أحد قبل زوال حكم الإمام، فكذلك لا يبني، ذكر هذا عن أشهب جماعة منهم ابن عبد البر وابن يونس وغيرهما، وحكى اللخمي عنه: أن مذهبه أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتقوم التي معه تقضي، فإذا فرغوا منه صاروا تجاه العدو، وقضت الأخرى. وهذه سنة رويت عن ابن مسعود، ورجح ابن عبد البر القول بما روي عن ابن عمر، وروي أن سهل بن أبي حثمة قد روي عنه مثل ما روي عن ابن عمر سواء، وروى حذيفة حين حكى صلاة النبي عليه السلام في الخوف: أنه صلى بكل طائفة ركعة، ولم يقض أحد من الطائفتين شيئا زائدا على ركعة، وذكر ابن عبد البر وغيره عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فكانت لرسول الله أربع، ولكل رجل ركعتان، وبهذه كان يفتي الحسن بن أبي الحسن، وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وقال أصحاب الرأي: إذا كانت صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة ومعه طائفة، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالتي معه ركعتين، ثم يصيرون إلى إزاء العدو، وتأتي الأخرى فيدخلون مع الإمام، فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وحده، ثم يقومون إلى إزاء العدو، وتأتي الطائفة التي صلت مع الإمام ركعتين إلى مقامهم الأول في الصلاة، فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا ويسلمون، ثم يجيئون إلى إزاء العدو، وتنصرف الطائفة الأخرى إلى مقام الصلاة، فيقضون ركعتين بقراءة وحدانا ويسلمون، وكملت صلاتهم.
قال القاضي أبو محمد- رحمه الله-: وهذا طرد قول أصحاب الرأي في سائر الصلوات، سأل مروان بن الحكم أبا هريرة، هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة:
نعم، قال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله وكبروا جميعا الذين معه والذين بإزاء العدو ثم ركع رسول الله وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت الطائفة التي كانت معه إلى إزاء العدو وأقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ركعة أخرى وركعوا معه وسجد فسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قاعد ثم كان السلام فسلم رسول الله وسلموا جميعا. وأسند أبو داود في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها صفة في صلاة النبي صلاة الخوف تقرب مما روي عن أبي هريرة وتخالفها في أشياء إلا أنها صفة صلاة الخوف من لدن قول أبي يوسف وابن علية أحد عشر قولا منع صلاة الخوف لكونها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وعشر صفات على القول الشهير فإنها باقية للأمراء.
قوله تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً (102)
الضمير في سجدوا للطائفة المصلية والمعنى: فإذا سجدوا معك الركعة الأولى فلينصرفوا، هذا على بعض الهيئات المروية والمعنى: فإذا سجدوا ركعة القضاء وهذا على هيئة سهل بن أبي حثمة، والضمير في قوله: فليكونوا يحتمل أن يكون للذين سجدوا ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو ويجيء الكلام وصاة في حال الحذر والحرب، وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق «فلتقم» بكسر اللام، وقرأ الجمهور ولتأت طائفةٌ بالتاء، وقرأ أبو حيوة «وليأت» بالياء،
وقوله تعالى: ودّ الّذين كفروا الآية إخبار عن معتقد القوم وتحذير من الغفلة، لئلا ينال العدو أمله. وأسلحة جمع سلاح، وفي قوله تعالى: ميلةً واحدةً بناء مبالغة أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية، وقوله تعالى: ولا جناح عليكم الآية ترخيص، قال ابن عباس: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف، كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوب، فرخص الله تعالى في هاتين الحالتين، وينقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت، ثم قوى الله تعالى نفوس المؤمنين بقوله إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً). [المحرر الوجيز: 3/9-14]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذًى من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا (102)}صلاة الخوف أنواعٌ كثيرةٌ، فإنّ العدوّ تارةً يكون تجاه القبلة، وتارةً يكون في غير صوبها، والصّلاة تارةً تكون رباعيّةً، وتارةً ثلاثيّةً كالمغرب، وتارةً ثنائيّةً، كالصّبح وصلاة السّفر، ثمّ تارةً يصلّون جماعةً، وتارةً يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة، بل يصلّون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ورجالًا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضّرب المتتابع في متن الصّلاة.
ومن العلماء من قال: يصلّون والحالة هذه ركعةً واحدةً؛ لحديث ابن عبّاسٍ المتقدّم، وبه قال أحمد بن حنبلٍ. قال المنذريّ في الحواشي: وبه قال عطاءٌ، وجابرٌ، والحسن، ومجاهدٌ، والحكم، وقتادة، وحمّادٌ. وإليه ذهب طاوسٌ والضّحّاك.
وقد حكى أبو عاصمٍ العبّادي عن محمّد بن نصرٍ المروزيّ؛ أنّه يرى ردّ الصّبح إلى ركعةٍ في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضًا.
وقال إسحاق بن راهويه: أمّا عند المسايفة فيجزيك ركعةٌ واحدةٌ، تومئ بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدةٌ واحدةٌ؛ لأنّها ذكر اللّه.
وقال آخرون: تكفي تكبيرةٌ واحدةٌ. فلعلّه أراد ركعةً واحدةً، كما قاله أحمد بن حنبلٍ وأصحابه، ولكن الّذين حكوه إنّما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة، كما هو مذهب إسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الأمير عبد الوهّاب بن بخت المكّيّ، حتّى قال: فإن لم يقدر على التّكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنّيّة، رواه سعيد بن منصورٍ في سننه عن إسماعيل بن عيّاش، عن شعيب بن دينارٍ، عنه، فاللّه أعلم.
ومن العلماء من أباح تأخير الصّلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخّر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الأحزاب صلاة العصر، قيل: والظّهر، فصلّاهما بعد الغروب، ثمّ صلّى بعدهما المغرب ثمّ العشاء. وكما قال بعدها -يوم بني قريظة، حين جهّز إليهم الجيش -: "لا يصلّينّ أحدٌ منكم العصر إلّا في بني قريظة"، فأدركتهم الصّلاة في أثناء الطّريق، فقال منهم قائلون: لم يرد منّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ألا تعجيل المسير، ولم يرد منّا تأخير الصّلاة عن وقتها، فصلّوا الصّلاة لوقتها في الطّريق. وأخّر آخرون منهم العصر، فصلّوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنّف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أحدًا من الفريقين وقد تكلّمنا على هذا في كتاب السّيرة، وبيّنا أنّ الّذين صلّوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحقّ في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضًا، والحجّة هاهنا في عذرهم في تأخير الصّلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار النّاكثين للعهد من الطّائفة الملعونة اليهود. وأمّا الجمهور فقالوا: هذا كلّه منسوخٌ بصلاة الخوف، فإنّها لم تكن نزلت بعد، فلمّا نزلت نسخ تأخير الصّلاة لذلك، وهذا بيّنٌ في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ، الّذي رواه الشّافعيّ وأهل السّنن، ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاريّ رحمه اللّه، في صحيحه، حيث قال:
"باب الصّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوّ": قال الأوزاعيّ: إن كان تهيّأ الفتح ولم يقدروا على الصّلاة، صلّوا إيماءً، كلّ امرئٍ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصّلاة حتّى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلّوا ركعةً وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التّكبير، ويؤخّرونها حتّى يأمنوا. وبه قال مكحولٌ، وقال أنس بن مالكٍ: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتدّ اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصّلاة، فلم نصلّ إلّا بعد ارتفاع النّهار، فصلّيناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا، قال أنسٌ: وما يسرّني بتلك الصّلاة الدّنيا وما فيها.
انتهى ما ذكره، ثمّ أتبعه بحديث تأخير الصّلاة يوم الأحزاب، ثمّ بحديث أمره إيّاهم ألّا يصلّوا العصر إلّا في بني قريظة، وكأنّه كالمختار لذلك، واللّه أعلم.
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتجّ بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنّه يشتهر غالبًا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطّاب، ولم ينقل أنّه أنكر عليهم، ولا أحدٌ من الصّحابة، واللّه أعلم.
[و] قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعةً في الخندق؛ لأنّ ذات الرّقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السّير والمغازي. وممّن نصّ على ذلك محمّد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، والواقديّ، ومحمّد بن سعدٍ كاتبه، وخليفة بن خيّاط وغيرهم وقال البخاريّ وغيره: كانت ذات الرّقاع بعد الخندق، لحديث أبي موسى وما قدم إلّا في خيبر، واللّه أعلم. والعجب -كل العجب - أنّ المزني، وأبا يوسف القاضي، وإبراهيم بن إسماعيل بن عليّة ذهبوا إلى أنّ صلاة الخوف منسوخةٌ بتأخيره، عليه السّلام، الصّلاة يوم الخندق. وهذا غريبٌ جدًّا، وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصّلاة يومئذٍ على ما قاله مكحولٌ والأوزاعيّ أقوى وأقرب، واللّه أعلم.
فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة} أي: إذا صلّيت بهم إمامًا في صلاة الخوف، وهذه حالةٌ غير الأولى، فإنّ تلك قصرها إلى ركعةٍ، كما دلّ عليه الحديث، فرادى ورجالًا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ثمّ ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمامٍ واحدٍ. وما أحسن ما استدلّ به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعالٌ كثيرةٌ لأجل الجماعة، فلولا أنّها واجبةٌ لما ساغ ذلك، وأمّا من استدلّ بهذه الآية على أنّ صلاة الخوف منسوخةٌ بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لقوله: {وإذا كنت فيهم} فبعده تفوت هذه الصّفة، فإنّه استدلالٌ ضعيفٌ، ويردّ عليه مثل قول مانعي الزّكاة، الّذين احتجّوا بقوله: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم} [التّوبة: 103] قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أحدٍ، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلى من صلاته، أي: دعاؤه، سكنٌ لنا، ومع هذا ردّ عليهم الصّحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزّكاة، وقاتلوا من منعها منهم.
ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أوّلًا قبل ذكر صفتها:
قال ابن جريرٍ: حدّثني المثنّى، حدّثنا إسحاق، حدّثنا عبد اللّه بن هاشمٍ، أنبأنا سيفٌ عن أبي روق، عن أبي أيّوب، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه، قال: سأل قومٌ من بني النّجّار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا نضرب في الأرض، فكيف نصلّي؟ فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة} ثمّ انقطع الوحيّ، فلمّا كان بعد ذلك بحولٍ غزا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فصلّى الظّهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّدٌ وأصحابه من ظهورهم، هلّا شددتم عليهم؟ فقال قائلٌ منهم: إنّ لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل اللّه عزّ وجلّ بين الصّلاتين: {إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا [إنّ الكافرين كانوا لكم عدوًّا مبينًا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك} إلى قوله: {أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا}] فنزلت صلاة الخوف.
وهذا سياقٌ غريبٌ جدًّا ولكن لبعضه شاهدٌ من رواية أبي عيّاشٍ الزّرقي، واسمه زيد بن الصّامت، رضي اللّه عنه، قال الإمام أحمد:
حدّثنا عبد الرّزّاق، حدّثنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن أبي عيّاشٍ قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعسفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلّى بنا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم الظّهر، فقالوا: لقد كانوا على حالٍ لو أصبنا غرّتهم. ثمّ قالوا: تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظّهر والعصر: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة} قال: فحضرت، فأمرهم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فأخذوا السّلاح، [قال] فصفنا خلفه صفّين، قال: ثمّ ركع فركعنا جميعًا، ثمّ رفع فرفعنا جميعًا، ثمّ سجد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالصّفّ الّذي يليه والآخرون قيامٌ يحرسونهم، فلمّا سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثمّ تقدّم هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء، ثمّ ركع فركعوا جميعًا، ثمّ رفع فرفعوا جميعًا، ثمّ سجد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم والصّفّ الّذي يليه، والآخرون قيامٌ يحرسونهم، فلمّا جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثمّ سلّم عليهم، ثمّ انصرف. قال: فصلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مرّتين: مرّةً بعسفان، ومرّةً بأرض بني سليمٍ.
ثمّ رواه أحمد، عن غندر، عن شعبة، عن منصورٍ، به نحوه. وهكذا رواه أبو داود، عن سعيد بن منصورٍ، عن جرير بن عبد الحميد، والنّسائيّ من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصّمد، كلّهم عن منصورٍ، به.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وله شواهد كثيرةٌ، فمن ذلك ما رواه البخاريّ حيث قال: حدّثنا حيوة بن شريح، حدّثنا محمّد بن حربٍ، عن الزّبيدي، عن الزّهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ قال: قام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وقام النّاس معه، فكبّر وكبروا معه، وركع وركع ناسٌ منهم، ثمّ سجد وسجدوا معه، ثمّ قام الثّانية فقام الّذين سجدوا، وحرسوا إخوانهم، وأتت الطّائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والنّاس كلّهم في الصّلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا.
وقال ابن جريرٍ: حدّثنا ابن بشّارٍ، حدّثنا معاذ بن هشامٍ، حدّثني أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري: أنّه سأل جابر بن عبد اللّه عن إقصار الصّلاة: أيّ يومٍ أنزل؟ أو: أيّ يومٍ هو؟ فقال جابرٌ: انطلقنا نتلقى عير قريشٍ آتيةً من الشّام، حتّى إذا كنّا بنخلٍ، جاء رجلٌ من القوم إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: يا محمّد. قال: "نعم"، قال: هل تخافني؟ قال: "لا". قال: فما يمنعك منّي؟ قال: "اللّه يمنعني منك". قال: فسلّ السّيف ثمّ تهدّده وأوعده، ثمّ نادى بالتّرحّل وأخذ السّلاح، ثمّ نودي بالصّلاة، فصلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بطائفةٍ من القوم وطائفةٌ أخرى تحرسهم. فصلّى بالّذين يلونه ركعتين، ثمّ تأخّر الّذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصافّ أصحابهم، ثمّ جاء الآخرون فصلّى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثمّ سلّم. فكانت للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أربع ركعاتٍ، والقوم ركعتين ركعتين، فيومئذٍ أنزل اللّه في إقصار الصّلاة وأمر المؤمنين بأخذ السّلاح.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا سريج حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بشرٍ، عن سليمان بن قيسٍ اليشكري، عن جابر بن عبد اللّه قال: قاتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم محارب خصفة فجاء رجلٌ منهم يقال له: "غورث بن الحارث" حتّى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسّيف فقال: من يمنعك منّي؟ قال: "اللّه"، فسقط السّيف من يده، فأخذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: "ومن يمنعك منّي"؟ قال: كن خير آخذٍ. قال: "أتشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّي رسول اللّه؟ " قال: لا ولكنّي أعاهدك ألّا أقاتلك ولا أكون مع قومٍ يقاتلونك. فخلّى سبيله، فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفةٌ صلّوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فصلّى بالطّائفة الّذين معه ركعتين، وانصرفوا، فكانوا بمكان أولئك الّذين بإزاء عدوّهم. وانصرف الّذين بإزاء عدوّهم فصّلوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين، فكان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أربع ركعاتٍ، وللقوم ركعتين ركعتين.
تفرّد به من هذا الوجه.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أحمد بن سنان، حدّثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم، حدّثنا المسعوديّ، عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد اللّه عن الرّكعتين في السّفر: أقصرهما؟ قال: الرّكعتان في السّفر تمامٌ، إنّما القصر واحدةٌ عند القتال، بينما نحن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في قتالٍ إذ أقيمت الصّلاة، فقام رسول اللّه صلّى فصفّ طائفةً، وطائفةٌ وجهها قبل العدوّ، فصلّى بهم ركعةً وسجد بهم سجدتين، ثمّ الّذين خلّفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فصلّى بهم ركعةً وسجد بهم سجدتين، ثمّ إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم جلس وسلّم، وسلّم الّذين خلفه، وسلّم أولئك، فكانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين، وللقوم ركعةً ركعةً، ثمّ قرأ: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة}.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد اللّه؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى بهم صلاة الخوف، فقام صفٌّ بين يديه، وصفٌّ خلفه، فصلّى بالّذي خلفه ركعةً وسجدتين، ثمّ تقدّم هؤلاء حتّى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتّى قاموا مقام هؤلاء، فصلّى بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ركعةً وسجدتين، ثمّ سلّم. فكانت للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين ولهم ركعةٌ.
ورواه النّسائيّ من حديث شعبة، ولهذا الحديث طرقٌ عن جابرٍ وهو في صحيح مسلمٍ من وجهٍ آخر بلفظٍ آخر وقد رواه عن جابرٍ جماعةٌ كثيرون في الصّحيح والسّنن والمساند.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أبي، حدّثنا نعيم بن حمّاد، حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، أنبأنا معمر، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة} قال: هي صلاة الخوف، صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بإحدى الطّائفتين ركعةً، والطّائفة الأخرى مقبلةٌ على العدوّ، وأقبلت الطّائفة الأخرى الّتي كانت مقبلةً على العدوّ فصلّى بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ركعةً أخرى، ثمّ سلّم بهم، ثمّ قامت كلّ طائفةٍ منهم فصلت ركعةً ركعةً. وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرٍ، به ولهذا الحديث طرقٌ كثيرةٌ عن جماعةٍ من الصّحابة، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جريرٍ، ولنحرّره في كتاب "الأحكام الكبير" إن شاء اللّه، وبه الثقة.
وأمّا الأمر بحمل السّلاح في صلاة الخوف، فمحمولٌ عند طائفةٍ من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشّافعيّ ويدلّ عليه قوله: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذًى من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم} أي: بحيث تكونون على أهبةٍ إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفةٍ: {إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا} ). [تفسير القرآن العظيم: 2/398-403]
تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله: (فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)
يعني به صلاة الخوف هذه.
(فاذكروا الله قياما وقعودا).
أي أذكروه بتوحيده وشكره وتسبيحه، وكل ما يمكن أن يتقرب به منه.
وقوله جلّ وعزّ: (فإذا اطمأننتم).
أي إذا سكنت قلوبكم، ويقال اطمأن الشيء إذا سكن وطأمنته وطمأنته إذا سكنته، وقد روي " اطبان " بالباء ولكن لا تقرأ بها لأن المصحف لا يخالف ألبتّة.
وقوله: (فأقيموا الصّلاة).
أي فأتموا، لأنهم جعل لهم في الخوف قصرها، وأمروا في الأمن بإتمامها.
وقوله: (إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
أي مفروضا مؤقتا فرضه). [معاني القرآن: 2/99]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً (103) ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليماً حكيماً (104)
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف، على حد ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر الله، فهو ذكر باللسان، وذهب قوم إلى أن قضيتم بمعنى فعلتم، أي إذا تلبستم بالصلاة فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات: المرض، وغيره، وبحسب هذه الآية رتب ابن المواز صلاة المريض فقال: يصلي قاعدا فإن لم يطق فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يطق فعلى الأيسر، فإن لم يطق فعلى الظهر، ومذهب مالك في المدونة التخيير، لأنه قال: فعلى جنبه أو على ظهره، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه قال: يبتدئ بالظهر ثم بالجنب، قال ابن حبيب: وهو وهم، قال اللخمي: وليس بوهم، بل هو أحكم في استقبال القبلة، وقال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن كما يجعل في قبره، فإن لم يقدر فعلى ظهره، و «الطمأنينة» في الآية: سكون النفس من الخوف، وقال بعض المتأولين: المعنى: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر فأقيموها تامة أربعا، وقوله تعالى: كتاباً موقوتاً معناه: منجما في أوقات، هذا ظاهر اللفظ، وروي عن ابن عباس: أن المعنى فرضا مفروضا، فهما لفظان بمعنى واحد كرر مبالغة). [المحرر الوجيز: 3/14-15]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا (103) ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليمًا حكيمًا (104)}يأمر اللّه تعالى بكثرة الذّكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعًا مرغّبًا فيه أيضًا بعد غيرها، ولكنّ هاهنا آكد لما وقع فيها من التّخفيف في أركانها، ومن الرّخصة في الذّهاب فيها والإياب وغير ذلك، ممّا ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: {فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم} [التّوبة: 36]، وإن كان هذا منهيًّا عنه في غيرها، ولكنّ فيها آكد لشدّة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال تعالى: {فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم} أي في سائر أحوالكم.
ثمّ قال: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة} أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف، وحصلت الطّمأنينة {فأقيموا الصّلاة} أي: فأتمّوها وأقيموها كما أمرتم بحدودها، وخشوعها، وسجودها وركوعها، وجميع شئونها.
وقوله: {إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} قال ابن عبّاسٍ: أي مفروضًا. وكذا روي عن مجاهدٍ، وسالم بن عبد اللّه، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليٍّ، والحسن، ومقاتلٍ، والسّدّيّ، وعطيّة العوفيّ.
وقال عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن قتادة: {إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} قال ابن مسعودٍ: إنّ للصّلاة وقتًا كوقت الحجّ.
وقال زيد بن أسلم: {إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} قال: منجّمًا، كلّما مضى نجمٌ، جاءتهم يعني: كلّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ). [تفسير القرآن العظيم: 2/403]
تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليما حكيما (104)
هذا خطاب للمؤمنين، والقوم ههنا الكفار الذين هم حرب المؤمنين.
وتأويل: (لا تهنوا) في اللغة لا تضعفوا، يقال وهن الرجل يهن إذا ضعف فهو وهن. ومعنى (ابتغاء القوم): طلب القوم بالحرب.
وقوله: (إن تكونوا تألمون فإنّهم).
أي إن تكونوا توجعون فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والتعب كما تجدون، وأنتم مع ذلك (ترجون من الله ما لا يرجون).
أي أنتم ترجون النصر الذي وعدكم الله به، وإظهار دينكم على سائر أديان أهل الملل المخالفة لأهل الإسلام وترجون مع ذلك الجنة، وهم – أعني المشركين – لا يرجون الجنة لأنهم كانوا غير مقرين بالبعث فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون.
قال بعض أهل التفسير: معنى " ترجون " ههنا تخافون، وأجمع أهل اللغة الموثوق بعلمهم: أن الرجاء ههنا على معنى الأمل لا على تصريح الخوف.
وقال بعضهم: الرجاء لا يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحد.
قال الشاعر:
لا ترتجى حين تلاقي الذّائدا... أسبعة لاقت معا أم واحدا
معناه لا تخاف.
وكذلك قوله عزّ وجلّ: (ما لكم لا ترجون للّه وقارا (13).
أي لا تخافون للّه عظمة ولا عظة.
وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف لأن الرجاء أمل قد يخاف ألّا يتمّ). [معاني القرآن: 2/100]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم يبين أن القضاء المشار إليه قبل، إنما هو قضاء صلاة الخوف، وتهنوا معناه تلينوا وتضعفوا، حبل واهن أي ضعيف، ومنه: وهن العظم [مريم: 4]، وابتغاء القوم: طلبهم، وقرأ عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الألف، وقرأ يحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر «تيلمون» في الثلاثة وهي لغة، وهذا تشجيع لنفوس المؤمنين، وتحقير لأمر الكفرة، ومن نحو هذا المعنى قول الشاعر [الشداخ بن يعمر الكناني]: [المنسرح]
القوم أمثالكم لهم شعر = في الرّأس لا ينشرون إن قتلوا
ثم
تأكد التشجيع بقوله تعالى: وترجون من اللّه ما لا يرجون وهذا برهان بيّن،
ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين، وباقي الآية بيّن). [المحرر الوجيز: 3/15]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{ولا تهنوا في ابتغاء القوم} أي: لا تضعفوا في طلب عدّوّكم، بل جدّوا
فيهم وقاتلوهم، واقعدوا لهم كلّ مرصدٍ: {إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون
كما تألمون} أي: كما يصيبكم الجراح والقتل، كذلك يحصل لهم، كما قال {إن
يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحٌ مثله} [آل عمران: 140].
ثمّ قال: {وترجون من اللّه ما لا يرجون}
أي: أنتم وإيّاهم سواءٌ فيما يصيبكم وإيّاهم من الجراح والآلام، ولكن
أنتم ترجون من اللّه المثوبة والنّصر والتّأييد، وهم لا يرجون شيئًا من
ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشدّ رغبةً في إقامة كلمة اللّه وإعلائها.
{وكان اللّه عليمًا حكيمًا} أي: هو أعلم
وأحكم فيما يقدّره ويقضيه، وينفّذه ويمضيه، من أحكامه الكونيّة
والشّرعيّة، وهو المحمود على كلّ حالٍ). [تفسير القرآن العظيم: 2/403-404]
* للاستزادة ينظر: هنا