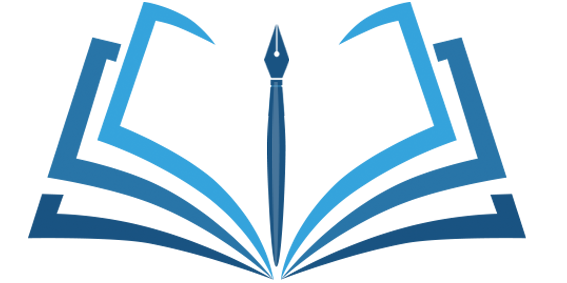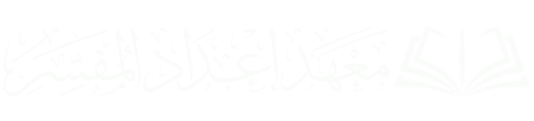تفسير سورة النساء
القسم الثاني عشر
تفسير سورة النساء [ من الآية (148) إلى الآية (152) ]

تفسير سورة النساء
القسم الثاني عشر
تفسير سورة النساء [ من الآية (148) إلى الآية (152) ]
18 Nov 2018
تفسير
قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ
إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِن
تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ
اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ
وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (150) أُوْلَئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (152)}
تفسير قوله تعالى:
{لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن
ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلّا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما (148)
وإلّا من ظلم، يقرأ بهما جميعا.
فالمعنى أن المظلوم جائز
أن يظهر بظلامته تشكيا، والظالم يجهر بالسوء من القول ظلما واعتداء، وموضع "
من " نصب بالوجهين جميعا، لأنه استثناء ليس من الأول
المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن المظلوم يظهر بظلامته تشكيا، ولكن الظالم يجهر بذلك ظلما.
ويجوز أن يكون موضع " من "
رفعا على معنى لا يحب اللّه أن يجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم فيكون "
من " بدلا من معنى أحد، المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول
إلا المظلوم.
وفيها وجه آخر لا أعلم
النحويين ذكروه، وهو أن يكون " إلا من ظلم " على معنى لكن الظالم اجهروا له
بالسوء من القول، وهذا بعد استثناء ليس من الأول. وهو وجه حسن، وموضعه
نصب.
وقد روي أن هذا ورد في الضيف إذا أسيء إليه، فله أن يشكو لك.
وحقيقته ما قلناه. واللّه أعلم). [معاني القرآن: 2/125-126]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم وكان اللّه سميعاً عليماً (148) إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوءٍ فإنّ اللّه كان عفوًّا قديراً (149) إنّ الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلاً (150) أولئك هم الكافرون حقًّا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً (151)
المحبة في الشاهد إرادة يقترن بها استحسان وميل اعتقاد، فتكون الأفعال الظاهرة من المحب بحسب ذلك، والجهر بالسّوء من القول لا يكون من الله تعالى فيه شيء من ذلك، أما أنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه. والجهر: كشف الشيء، ومنه الجهرة في قول الله تعالى أرنا اللّه جهرةً [النساء: 53] ومنه قولهم: جهرت البير، إذا حفرت حتى أخرجت ماءها، واختلف القراء في قوله تعالى إلّا من ظلم وقراءة جمهور الناس بضم الظاء وكسر اللام، وقرأ ابن أبي إسحاق وزيد بن أسلم والضحاك بن مزاحم وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار ومسلم بن يسار وغيرهم «إلا من ظلم» بفتح الظاء واللام، واختلف المتأولون على القراءة بضم الظاء، فقالت فرقة: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول «إلا من ظلم» فلا يكره له الجهر به، ثم اختلفت هذه الفرقة في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك، فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل: اللهم أعنّي عليه، اللهم استخرج لي حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي، وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو أحسن له، وقال مجاهد وغيره: هو في الضيف المحول رحله، فإنه يجهر الذي لم يكرمه بالسوء من القول، فقد رخص له أن يقول فيه: وفي هذا نزلت الآية، ومقتضاها ذكر الظلم وتبيين الظلامة في ضيافة وغيرها، وقال ابن عباس والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه، ويجهر له بالسوء من القول.
قال القاضي رحمه الله: فهذه الأقوال على أربع مراتب:
قول الحسن دعاء في المدافعة، وتلك أقل منازل السوء من القول.
وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء.
وقول مجاهد، ذكر الظلامة والظلم.
وقول السدي الانتصار بما يوازي الظلامة.
وقال ابن المستنير: إلّا من ظلم معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفرا أو نحوه، فذلك مباح، والآية في الإكراه، واختلف المتأولون على القراءة بفتح الضاد واللام، فقال ابن زيد: المعنى «إلا من ظلم» في قول أو في فعل، فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله والتوبيخ والرد عليه، قال: وذلك أنه لما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، كان ذلك جهرا بالسوء من القول. ثم قال لهم بعد ذلك ما يفعل اللّه بعذابكم [النساء: 147] الآية، على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان، ثم قال للمؤمنين: «ولا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن ظلم» في إقامته على النفاق، فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل؟
ونحو هذا من الأقوال، وقال قوم معنى الكلام: «ولا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول»، ثم استثنى استثناء منقطعا، تقديره: لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك وإعراب من يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب، ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر، و «سميع عليم»: صفتان لائقتان بالجهر بالسوء وبالظلم أيضا، فإنه يعلمه ويجازي عليه). [المحرر الوجيز: 3/54-55]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعًا عليمًا (148) إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوءٍ فإنّ اللّه كان عفوًّا قديرًا (149)}قال [عليّ] بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول} يقول: لا يحبّ اللّه أن يدعو أحدٌ على أحدٍ، إلّا أن يكون مظلومًا، فإنّه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: {إلا من ظلم} وإن صبر فهو خيرٌ له.
وقال أبو داود: حدّثنا عبيد اللّه بن معاذٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا سفيان، عن حبيبٍ، عن عطاءٍ، عن عائشة قالت: سرق لها شيءٌ، فجعلت تدعو عليه، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم "لا تسبّخي عنه".
وقال الحسن البصريّ: لا يدع عليه، وليقل: اللّهمّ أعنّي عليه، واستخرج حقّي منه. وفي روايةٍ عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه.
وقال عبد الكريم بن مالكٍ الجزريّ في هذه الآية: هو الرّجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلٍ} [الشّورى: 41].
وقال أبو داود: حدّثنا القعنبيّ، حدّثنا عبد العزيز بن محمّدٍ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "المستبّان ما قالا فعلى البادئ منهما، ما لم يعتد المظلوم".
وقال عبد الرّزّاق: أنبأنا المثنّى بن الصّبّاح، عن مجاهدٍ في قوله: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم} قال: ضاف رجلٌ رجلًا فلم يؤدّ إليه حقّ ضيافته، فلمّا خرج أخبر النّاس، فقال: "ضفت فلانًا فلم يؤدّ إليّ حقّ ضيافتي". فذلك الجهر بالسّوء من القول إلّا من ظلم، حين لم يؤدّ الآخر إليه حقّ ضيافته.
وقال محمّد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدٍ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم} قال: قال هو الرّجل ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فيخرج فيقول: "أساء ضيافتي، ولم يحسن". وفي روايةٍ هو الضّيف المحوّل رحله، فإنّه يجهر لصاحبه بالسّوء من القول.
وكذا روي عن غير واحدٍ، عن مجاهدٍ، نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النّسائيّ والتّرمذيّ، من طريق اللّيث بن سعدٍ -والتّرمذيّ من حديث ابن لهيعة-كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامرٍ قال: قلنا يا رسول اللّه، إنّك تبعثنا فننزل بقومٍ فلا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ قال: "إذا نزلتم بقومٍ فأمروا لكم بما ينبغي للضّيف، فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضّيف الّذي ينبغي لهم".
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، سمعت أبا الجوديّ يحدّث، عن سعيد بن المهاجر، عن المقدام أبي كريمة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: "أيّما مسلمٍ ضاف قومًا، فأصبح الضّيف محرومًا، فإنّ حقًا على كلّ مسلمٍ نصره حتّى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله".
تفرّد به أحمد من هذا الوجه وقال أحمد أيضًا: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدّثنا شعبة، حدّثني منصورٌ، عن الشّعبي عن المقدام أبي كريمة، سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "ليلة الضّيف واجبةٌ على كلّ مسلمٍ، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه".
ثمّ رواه أيضًا عن غندر عن شعبة. وعن زياد بن عبد اللّه البكّائي. عن وكيع، وأبي نعيم، عن سفيان الثّوريّ -ثلاثتهم عن منصورٍ، به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة، عن منصورٍ، به.
ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضّيافة، ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكرٍ البزّار.
حدّثنا عمرو بن عليٍّ، حدّثنا صفوان بن عيسى، حدّثنا محمّد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنّ رجلًا أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إن لي جارًا يؤذيني، فقال له: "أخرج متاعك فضعه على الطّريق". فأخذ الرّجل متاعه فطرحه على الطّريق، فجعل كلّ من مرّ به قال: مالك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللّهمّ العنه، اللّهمّ أخزه! قال: فقال الرّجل: ارجع إلى منزلك، وقال لا أوذيك أبدًا".
وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب، عن أبي توبة الرّبيع بن نافعٍ، عن سليمان بن حيّان أبي خالدٍ الأحمر، عن محمّد بن عجلان به.
ثمّ قال البزّار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلّا بهذا الإسناد، ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد اللّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ويوسف بن عبد اللّه بن سلامٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم). [تفسير القرآن العظيم: 2/442-444]
تفسير قوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في أن يجهر بالسوء لظالمه، أتبع ذلك عرض إبداء الخير وإخفائه، والعفو عن السوء، ثم وعد عليه بقوله فإنّ اللّه كان عفوًّا قديراً وعدا خفيا تقتضيه البلاغة ورغب في العفو إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقام، ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها). [المحرر الوجيز: 3/56]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله: {إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوءٍ فإنّ اللّه كان عفوًّا قديرًا} أي: إن تظهروا -أيّها النّاس-خيرًا، أو أخفيتموه، أو عفوتم عمّن أساء إليكم، فإنّ ذلك ممّا يقرّبكم عند اللّه ويجزل ثوابكم لديه، فإنّ من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا قال: {إنّ اللّه كان عفوًّا قديرًا}؛ ولهذا ورد في الأثر: أنّ حملة العرش يسبّحون اللّه، فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك. ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصّحيح: "ما نقص مالٌ من صدقةٍ، ولا زاد اللّه عبدًا بعفوٍ إلّا عزًّا، ومن تواضع للّه رفعه الله"). [تفسير القرآن العظيم: 2/444]تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (150)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: إنّ الّذين يكفرون باللّه ورسله إلى آخر الآية. نزل في اليهود والنصارى، لأنهم في كفرهم بمحمد عليه السلام كأنهم قد كفروا بجميع الرسل. وكفرهم بالرسل كفر بالله، وفرقوا بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء، وقولهم نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ قيل: معناه من الأنبياء، وقيل: هو تصديق بعضهم لمحمد في أنه نبي، لكن ليس إلى بني إسرائيل، ونحو هذا من تفريقاتهم التي كانت تعنتا وروغانا. وقوله بين ذلك أي بين الإيمان والإسلام والكفر الصريح المجلح). [المحرر الوجيز: 3/56]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({إنّ الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا (150) أولئك هم الكافرون حقًّا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا (151) والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرّقوا بين أحدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان اللّه غفورًا رحيمًا (152)}يتوعّد [تبارك و] تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنّصارى، حيث فرّقوا بين اللّه ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضٍ، بمجرّد التّشهّي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليلٍ قادهم إلى ذلك، فإنّه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرّد الهوى والعصبيّة. فاليهود -عليهم لعائن اللّه-آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصّلاة والسّلام، والنّصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم، والسّامرة لا يؤمنون بنبيٍّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال: إنّهم كانوا يؤمنون بنبيٍّ لهم يقال له زرادشت، ثمّ كفروا بشرعه، فرفع من بين أظهرهم، واللّه أعلم.
والمقصود أنّ من كفر بنبيٍّ من الأنبياء، فقد كفر بسائر الأنبياء، فإنّ الإيمان واجبٌ بكلّ نبيٍّ بعثه اللّه إلى أهل الأرض، فمن ردّ نبوّته للحسد أو العصبيّة أو التّشهّي تبيّن أنّ إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًّا، إنّما هو عن غرضٍ وهوًى وعصبيّةٍ؛ ولهذا قال تعالى: {إنّ الّذين يكفرون باللّه ورسله} فوسمهم بأنّهم كفّارٌ باللّه ورسله {ويريدون أن يفرّقوا بين اللّه ورسله} أي: في الإيمان {ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا} أي: طريقًا ومسلكًا). [تفسير القرآن العظيم: 2/445]
تفسير قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (151)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الكافرون حقا، لئلا يظن أحد أن ذلك القدر الذي عندهم من الإيمان ينفعهم، وباقي الآية وعيد). [المحرر الوجيز: 3/56]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (ثمّ أخبر تعالى عنهم، فقال: {أولئك هم الكافرون حقًّا} أي: كفرهم محقّقٌ لا محالة بمن ادّعوا الإيمان به؛ لأنّه ليس شرعيًّا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول اللّه لآمنوا بنظيره، وبمن هو أوضح دليلًا وأقوى برهانًا منه، لو نظروا حقّ النّظر في نبوّته.وقوله: {وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا} أي: كما استهانوا بمن كفروا به إمّا لعدم نظرهم فيما جاءهم به من اللّه، وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدّنيا ممّا لا ضرورة بهم إليه، وإمّا بكفرهم به بعد علمهم بنبوّته، كما كان يفعله كثيرٌ من أحبار اليهود في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حيث حسدوه على ما آتاه اللّه من النّبوّة العظيمة، وخالفوه وكذّبوه وعادوه وقاتلوه، فسلّط اللّه عليهم الذّلّ الدّنيويّ الموصول بالذّلّ الأخرويّ: {وضربت عليهم الذّلّة والمسكنة وباءوا بغضبٍ من اللّه} [البقرة: 61] في الدّنيا والآخرة). [تفسير القرآن العظيم: 2/445]
تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (152)}
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرّقوا بين أحدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان اللّه غفوراً رحيماً (152) يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السّماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا اللّه جهرةً فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ثمّ اتّخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً (153)
لما
ذكر الله تعالى أن المفرقين بين الرسل هم الكافرون حقا، عقب ذلك بذكر
المؤمنين بالله ورسله جميعا. وهم المؤمنون بمحمد عليه السلام ليصرح بوعد
هؤلاء كما صرح بوعيد أولئك، فبين الفرق بين المنزلتين، وقرأ بعض السبعة
«سوف يؤتيهم» بالياء أي يؤتيهم الله، وقرأ الأكثر «سوف نؤتيهم» بالنون،
منهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو). [المحرر الوجيز: 3/56]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرّقوا بين أحدٍ منهم} يعني بذلك: أمّة
محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم، فإنّهم يؤمنون بكلّ كتابٍ أنزله اللّه
وبكلّ نبيٍّ بعثه اللّه، كما قال تعالى: {آمن الرّسول بما أنزل إليه من
ربّه والمؤمنون كلٌّ آمن باللّه [وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحدٍ
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير]} [البقرة: 285].
ثمّ أخبر تعالى بأنّه قد أعدّ لهم
الجزاء الجزيل والثّواب الجليل والعطاء الجميل، فقال: {أولئك سوف يؤتيهم
أجورهم} على ما آمنوا باللّه ورسله {وكان اللّه غفورًا رحيمًا} أي: لذنوبهم
أي: إن كان لبعضهم ذنوب). [تفسير القرآن العظيم: 2/445]
* للاستزادة ينظر: هنا