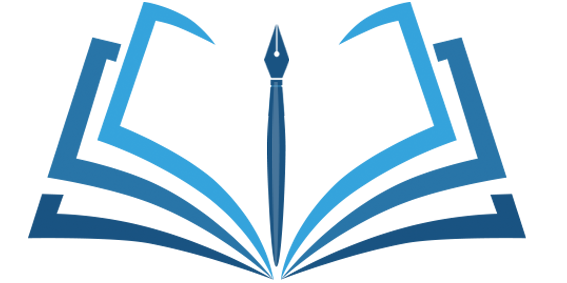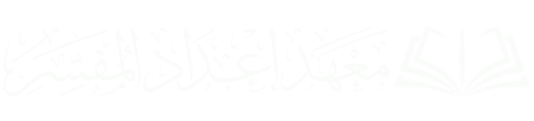منظومة الزمزمي
القسم الأول
حد علم التفسير
16 Nov 2008
حد علم التفسير
عِلْمٌ بِهِ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ = كِتَابِنَا مِنْ جِهَةِ الْإنْزَالِ
وَنَحْوِهِ بالْخَمْسِ وَالْخَمْسِينَا = قَدْ حُصِرَتْ أَنْوَاعُهُ يَقينَا
وَقَدْ حَوَتْهَا سِتَّةٌ عُقُودُ = َوبَعْدَهَا خَاتِمَةٌ تَعُودُ
وَقَبْلَهَا لَا بُدَّ مِنْ مُقَدَِّمَهْ = بِبَعْضِ مَا خُصَِّصَ فِيهِ مُعْلِمَهْ

هيئة الإشراف
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قالَ
الإمامُ جَلالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-: (عِلْمُ
التَّفْسِيرِ: عِلْمٌ يُبْحَثُ فيه عَنْ أَحْوَالِ الكتابِ العَزِيزِ،
ويَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَةٍ وخَمْسَةٍِ وخَمْسِينَ نَوْعًا).
علم التفسير: علمٌ
يبحَث فيه أحوالُ الكتابِ العزيزِ من جهةِ نزولِهِ وسَنَدِهِ وآدابِهِ
وألفَاظِهِ ومعَانِيهِ المتعلِّقَةِ بألفَاظِهِ والمتعلِّقَةِ بالأحكامِ
وغيرِ ذلكَ.
وهو علمٌ نفيسٌ لم أقفْ على تأليفٍ فيهِ لأحدٍ منَ المتقدِّمينَ حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقينيُّ فدوَّنَه ونقَّحه وهذَّبه ورتَّبه في كتابٍ سمَّاهُ (مواقع العلوم من مواقع النجوم) فأتى بالعجب العجاب، وجعله خمسين نوعا على نمطِ أنواع علوم الحديث.
وقد استدركتُ عليهِ منَ الأنواعِ ضِعْفَ ما ذكَرَه ,وتَتَبَّعْتُ أشياء متعلِّقة بالأنواعِ التي ذكرها مما أهمله ,وأودعتها كتابا سميته (التحبير في علم التفسير) وصدرته بمقدمة فيها حدودٌ مهمةٌ، ونقلت فيها حدوداً كثيرةً للتفسيرِ, ليس هذا موضع بسطِهَا.فكانَ ابتداء استنباطِ هذا العلمِ منَ البلقينيِّ، وتمامُه على يَدِي، وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرًا ثم يكبَر.
وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعاً بحسَبِ ما ذُكِرَ هُنا، وأنواعُه في التحبيرِ مائةَ نوعٍ ونوعانِ (102).

هيئة الإشراف
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حدّ علم التفسير، و(الحدّ):
هو التعريف، وجمعُه حدود، والتعاريف يُعنى بها أهل العلم عنايةً فائقة
يُحررونها، ويُجودونها، ويذكرون القيود المدخلة والمـُخرجة؛ ليكون التعريف
جامعًا مانعًا، ويذكرون المـُحترزات فهم يضبطونها ويُتقنونها.
والعنايةُ
بالحدود والتعاريف وُجِدت في المـُتأخرين أكثر، أما سلف هذه الأمّة فلا
يذكرونها إلا نادرًا؛ لأن المصطلحات لا يختلفون فيها، فلم يتعرضوا لتعريف
الصلاة ولا لتعريف الزكاة، ولا الصوم لأنها أمور عملية معروفة، وتعريف بعض
الأمور وحدّها مما يزيد في غموضها وخفائها ، فبعض الأمور قد تكون معروفة لدى النّاس فإذا عُرّفت ضاعت.
ولو بحثت في مصنفات المتقدمين ما وجدت من التعاريف إلا القليل النادر الذي
تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العُرفية، فيحتاجون إلى بيانه.
وأما
المـُتأخرون فجعلوا الحدّ ركن أساس في التعليم والتعلُم والتأليف؛ فلا
يتكلمون عن شيء إلا بعد تعريفه، ويقولون: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره،
والتصور لا يكون إلا بالحدّ، لكن قد يكون الشيء مُتصورا في الذهن ؛ فمن
يحتاج لتعريف الماء مثلاً؟
عرّفوا الماء بأنّه: مركب من كذا وكذا وذكروا أشياء جُل النّاس لايعرفُها.
وعرّفوا السماء، وعرّفوا الأرض، وعرّفوا الهواء ... إلى غير ذلك من التعريفات.
كلّ
هذه لا تحتاج إلى تعريف، ولهم تقسيمات للحدود والرسوم؛ لكن سلف هذه الأمّة
لا يُعنون بها، وإذا قامت الحاجة إلى تعليم شيء فلا بد من تعريفه، وإذا كيف
يُتكلم عنه ويُبحث عن حُكمهِ وهو لا يُعرف ؟
يقول في حدّ علم التفسير: علمٌ به يُبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزالِ ونحوهِ.
(علمٌ
به يُبحث عن أحوال): علم التفسير، وعلوم القرآن، وأصول التفسير تُطلق
ويراد بها علم واحد على ماتقدم نظير إطلاقات علوم الحديث؛ فهذا العلم
(يبحثُ عن أحوال كتابنا):ذكرنا بالأمس عند قوله:
(ضمنتُها علمًا هو التفسيرُ):
أنّه لا يريد بذلك التفسير التفصيلي للآيات، وإنما يريد ما يتعلقُ بالقرآن
إجمالاً، نظير ما يُبحث في أصول الفقه وعلوم الحديث من حيث الإجمال،
فيُبحث به عن الأحوال، وإذا أردنا أن ننظر علوم التفسير أو علوم القرآن مع
التفصيل بعلوم أُخرى قلنا: أن علوم القرآن بمنزلةِ علم النحو الذي يُبحثُ
فيه عن أحوال الكلمة وعوارضها، والتفسير نظير علم الصرف الذي يُبحثُ فيه عن
أجزاء الكلمة وحروفها، ولو أبعدنا قليلاً لقلنا أن علم التفسير وعلوم
القرآن نظير علم الطب يُبحثُ فيه عن أحوال المرض، مسببات المرض وعلاج
المرض.
والتفسير التفصيلي: نظير علم التشريح، هكذا قالوا، والتنظير شبه مُطابق.
قد
يقول قائل: إن من التفسير ما هو إجمالي وليس بتفصيلي؛ فهل يدخل في علوم
القرآن التفسير الموضوعي مثلاً، تجمع آيات تبحث في موضوعٍ واحد؛ فهل
نقول:هذه تدخل في علوم القرآن أو في التفسير؟
ونقول: التفسير ينقسم إلى قسمين:
_ تفسير موضوعي.
_ وتفسير تحليلي.
أو نقول:
_ تفسير إجمالي.
_ وتفسير تفصيلي.
هذه
مُدخلة في التفسير نفسه لا في علم التفسير، المقصود أن علم التفسير، وعلوم
القرآن علم يُبحث به عن أحوال كتابنا الذي هو القرآن العزيز من جهة نزوله
ونحوهِ مما يُذكر في العقود الستة:
العقد الأوّل: يقول: ما يرجع إلى النزول زمانًا ومكانًا.
والنزول، والإنزال، والتنزيل بمعنى واحد، من جهة إنزاله، هل هو:
_ مكي ولا مدني.
_ سفري ولا حضري.
_ صيفي ولا شتائي.
_ ليلي ولا نهاري.
من
جهة وقت إنزاله، ومن جهة مكان إنزاله، وكيفية النزول لأنواع الوحي مثلاً،
وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن من المسائل والأنواع التفصيلية التي يأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى ؛ ولذا قال:
........................... = ..... مِنْ جِهَةِ الإِنْـزَالِ
ونَحْوِهِ ، بالخَمْسِ والخَمْسِينا = قَـدْ حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا
لكن هذا الحصر استقرائي شامل لا يقبلُ المزيد، ولا النقص أو هو قابل للمزيد والنقص ؟
يعني: هل القسمة حاصره إلى خمسةٍ وخمسين ؟ ، أو أنّه قابل للزيادة ؟
هو تبع في ذلك "النُقاية" و "النُقاية" أُلفت لمـُبتدئين، واقتُصر فيها على الأنواع دون بعض، وإلا فمُؤلف "النُقاية" السيوطي ذكر في التحبير مائة ونوعين قريب من الضعف مما ذكرهُ هنا، وفي "الإتقان" قلت الأنواع لكنها زادت على ما عندنا كثيرًا؛ لأنه ضم بعضُها إلى بعض، وفي بعضها من التشابه ما يمكن ضمه إلى الآخر.
........ بالخَمْسِ والخَمْسِينا = قَـدْ حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا
لماذا ما قال بالخمسةِ والخمسينا، أو خمسةٍ وخمسين، هذا يُؤيد كونه إذا قلت:جاء خمسةٌ وخمسون رجُلاً، ولو كانت نساء نقول: جاء خمسٌ وخمسون امرأة، وهنا إذا كان التميز نوعًا بالخمسةِ والخمسين نوعًا لابد أن نأتي بالتاء، إذا حُذف التميز جاز التذكير والتأنيث ((من صام رمضان واتبعهُ ستًا من شوال))، لو ذُكر التميز فهي: أيام، فلابد أن يُقال: واتبعهُ ستةَ أيامٍ من شوال، مادام التميز غير مذكور يجوز التذكير والتأنيث .
ونَحْوِهِ ، بالخَمْسِ والخَمْسِينا = قَـدْ حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا
(قَدْ حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا): وعرفنا ما في هذا الحصر من إمكان الزيادة، وقد وجدت الزيادة.
(حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا): يعني أهم أنواعه مما يحتاجه الطالب المبتديء.
(وقَدْ حَوَتْهَا): أي حوت هذه الأنواع.
وقَدْ حَــوَتْهُ سِـتَّةٌ عُقُودُ = ......................
نظم هذه الأنواع كلّ مجموعة منها عشرة أو تزيد أو تنقص، كلّ مجموعة منها في عقد، مجموعة مُتشابهة جعلها في عقدٍ واحد؛ فصارت العقود ستة، وهي: الأبواب التي تتفرع عنها الفصول؛ فالعقود بمثابة الأبواب، والأنواع الداخلة في هذه العقود بمثابة الفصول .
وقَدْ حَــوَتْهُ سِـتَّةٌ عُقُودُ = وبَعـدَهـا ...........
بعد هذه العقود الستة خاتمة:
.................=...........خاتِمَـةٌ تَعُودُ
ختم بها المنظومة، (وقبلها) يعني :قبل العقود الستة لابد من مُقدمة، هذه خِطتة المنظومة التي جرى عليها الناظم، كلّ إنسان يريد أن يؤلف لابد أن يضع بين يديه خِطة يسير عليها، والبحوث التي يُكلف بها الطلاب يُكلف قبل ذلك بوضع خِطة، ويذكر في الخطة تمهيد أو مقدمة، وأبواب، وفصول، وخاتمة، والآن رسم الخِطة [رسم الخِطة] يقول:
وقَدْ حَــوَتْهُ سِـتَّةٌ عُقُودُ = وبَعـدَهـا خاتِمَـةٌ تَعُودُ
وقَبْلَها لا بُـدَّ مِنْ مُقَـدِّمَةْ = .....................
فالمنظومة تشتمل على مقدمة، والأصل أن تكون المـُقدمة في صدر الكلام، إذ كيف تكون مُقدمة وهي مُتأخرة عن بعضِهِ، وهذا كلام يُشكل أحيانًا يكتب الإنسان صفحتين يُبين فيه مزايا البحث وسبب الإختيار، ثمّ يقول: ويشتملُ هذه البحث على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخمسة أبواب وخاتمة، طيب واللي تَقدم ويش يصير؟
مثل ما عندنا:(تَبارَكَ المُنْـزِلُ للفُرقانِ .... إلخ)، في تسعة أبيات قبل المـُقدمة [قبل المـُقدمة] الأصل في المقدمة، وهي تُقال: بكسر الدال وفتحها، مُقدِمة، ومُقدَمة،[مُقدِمة، ومُقدَمة]، بفتح الدال وكسرها.
(ومُقدَمة): لأن المؤلف قدمهابين يدي كتابه، ومن لازم التقديم أن يكون في الصدر، يعني هل تستطيع إذا دخل خمسة، ستة، سبعة يوم دخل شخص اسمه زيد مثلاً، وقبله خمسة أشخاص ثمّ دخل بعدهُ مائة، أن تقول: مُقدمهم زيد، قبله ستة أو سبعة أو عشرة، لاتستطيع أن تقول: مُقدَمهم زيد ؛ إذاً كيف تكون مُقدَمة وهي قبلها تِسعة [أبواب]، تسعة أبيات؟
طيب لو قلنا حُكمًا لقلنا إن الأبيات التسعة السابقة داخلة في هذه المقدمة، وإن تقدمت عليها لفظًا وهي غير داخلة، نعم... تقديم نعم، (وهذه مُقدمة): تقديم مُقدمة ما زال الإشكال لأنّه لو قلنا: مُقدِمة أنّها تقدمت غيرها من الكلام.
وإذا قلنا أنّها مُقدَمة قلنا: أنّها قُدمت على غيرها من الكلام، نعم ، ولا يلزم عليه الدور، نعم.
المقدمات في الكتب ألا يكون من المـُفترض أن تتقدم الكتاب، مثل ما نظرنا، لو افترضنا أنّه الآن دخل مائة شخص دخل الأوّل، والثاني، والثالث، والتاسع، والعاشر، ثمّ دخل زيد ثمّ دخل بعدهُ تُسعون تستتطيع أن تقول: دخل مائة شخص يتقدمهم زيد، أو مُقدمهم زيد؟ ما تستطيع نعم.
نعم، يعني: تمهيد أو مدخل إلى المـُقدمة، على كلّ حال هذا من التحايل وإلا لابد أن نُغير في لفظ المقدمة، إذا لاحظنا أن لفظها من التقديم، وهي مُقَدمة بين يدي الكتاب، أو البحث لابد من التَصرُف فيها.
... مُقدِمة للعلم، وما قبلها ؟ مُقدمة للمتن.
والمتن وشه؟ (...) وما تَقدمها علمٌ به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، على كلّ حال هو لابد من التجوز في مثل هذا، لابد من التجوز في مثل هذا الكلام.
وقَبْلَها لا بُـدَّ مِنْ مُقَـدِّمَةْ = .....................
عرفنا أنّه تُقال بكسر الدال وفتحها.
......................... = بِبَعْضِ ما خُصِّصَ فيهِ مُعْلِمَةْ
هذه المـُقدمة (ببعض ما خُصص فيه مُعلمَه)، تُخبرُك هذه المـُقدمة، أو يُخبرُك المؤلف من خلال هذه المـُقدمة ببعض ما في الكتاب[1].
تخبرك هذه المقدمة أو يخبرك المؤلف من خلال هذه المقدمة ببعض ما في الكتاب, تكون ملخص أوفيها إشارة إلى موضوع الكتاب وأبواب الكتاب، ومسائل الكتاب على سبيل الإجمال.
الشيخ يحيب: مقدمة الفصل ما فيه بأس؟
طالب يسأل: وقبلها توجد مقدمة ..
الشيخ يجيب: وين؟
الشيخ: وقد حوتها الأنواع الخمسة والخمسين:
ونَحْوِهِ ، بالخَمْسِ والخَمْسِينا = قَدْ حُصِرَتْ أَنواعُهُ يَقينا
وقَدْ حَوَتْهُ سِتَّةٌ عُقُودُ = وبَعدَهــا خاتِمَةٌ تَعُودُ
وقَبْلَها ............ = ....................
هو قوله: (قبلها): ترى فيه شيء من الحل للإشكال؛ يعني مثل ما قلنا في كلام الحافظ العراقي :
من بعد حمد الله ذي الآلاء =.....................
قلنا: أنه المتقدم حكماً. وهنا قوله:
(وقبلها لابد) قلنا: أنه يمكن أن يقال: أنه المتقدم حكماً. لكن إذا انحل الإشكال فيما بين أيدينا ما ينحل في سائر البحوث التي على هذه الطريقة. يذكر لك صفحتين وثلاث في تمهيد يبين فيه سبب اختياره الموضوع ثم يقول: مقدمة. لكن نعود مرة ثانية إلى خطط البحوث، وإن كان هذا الجدوى منه قليلة ويعوقنا لكن نختصر.
إذا جئنا إلى البحوث وقال: مقدمة يُذكر فيها سبب اختيار الموضوع، وخطة البحث ثم يفصل الخطة ويقول: مقدمة. الخطة تشتمل على مقدمة. دار مرة ثانية فلابد من أن تُضبط الألفاظ، لابد من ضبط الألفاظ.
(ببعض ما خصص فيه):
وقَبْلَها لا بُـدَّ مِنْ مُقَـدِّمَةْ = بِبَعْضِ ما خُصِّصَ فيهِ مُعْلِمَةْ
يعني: المقدمات ينبغي أن تشتمل على المصطلحات المستعملة في الكتاب؛ لأن كثير من المؤلفين لهم اصطلاحات في كتبهم ؛ [لهم اصطلاحات في كتبهم]؛ لابد من بيانها في المقدمات وإلا فالطالب يقرأ، فهم هذه الاصطلاحات له أثر في فهم الكتاب، وتمرّ والطالب ما يدري عن شيء.
يعني: الفقهاء حينما استعملوا بعض الحروف للخلاف، بعض الحروف استعملوها للخلاف قالوا:
_ (لولا): للخلاف القوي.
_ و(حتى): للخلاف المتوسط.
_ و(إن): للضعيف. وما تبين في مقدمات الكتب استعملوها وما بيّنوها في مقدمات كل كتاب، الطالب يقرأ الكتاب وهو ما يدري.
فيه كتاب اسمه :"مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثير في الأحكام" هذا استعمل رموز في الكتاب لا تُحل إلا من خلال الإطلاع على المقدمة , إذا جاء صدر الحكم باسم فاعل فيريد فلان.خلاف فلان وفلان إذا صدره بالمضارع فيريد فلان. إذا صدره بكذا يريد فلان. وله رموز وحروف هذه لابد من معرفتها والإطلاع عليها.
الحافظ العراقي بيّن في مقدمة الألفية اصطلاحهُ:
فحيث جـاء الفعل والضمـير = لواحدٍ ومــن لـه مستـور
كقال، أو أطلقت لفظ: الشيخ = ما أريد إلا ابن الصلاح مطلق
وإن يكن لاثنين نحو التـزما... = ...........................
هذه اصطلاحات بيّنها المؤلف في مقدمة النظم. وهنا:
(ببعض ما خصص فيه معلمه) : هل يريد أن يبين اصطلاح، أو يريد أن يبحث في هذه المقدمة بعض ما خُصص بحثه في هذا العلم؟
(ببعض ما خصص فيه) : يعني في هذا العلم (معلمه):ومخبراً. ولذا عرف القرآن، وعرف السورة، وعرف الآية، وحكم ترجمة القرآن، وحكم روايته بالمعنى، وحكم تفسيره بالرأي، وبالأثر. هذه أمور متعلقة بالقرآن ، وهي تُبحَث في هذا العلم، واشتملت عليها المقدمة ولذا قال:
وقَبْلَها لا بُـدَّ مِنْ مُقَـدِّمَةْ = بِبَعْضِ ما خُصِّصَ فيهِ مُعْلِمَةْ
وإلا فالأصل أن هذه البحوث من أهم أنواع علوم القرآن، فقد يقول قائل: لماذا لا تكون المقدمة هي الباب الأول، أو العقد الأول؟
لأن فيها مباحث مهمة جداً. لكنه قال:
وقَبْلَها لا بُـدَّ مِنْ مُقَـدِّمَةْ = بِبَعْضِ ما خُصِّصَ فيهِ مُعْلِمَةْ
يعني لو استعمل المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم المفترض أن تبحث في باب مستقل أو عقد مستقل ؛ لأنه من أهم ما يبحث في هذا العلم؛ لأن فيه تعريف للقرآن، إعجاز القرآن، تعريف السورة تعريف الآية، ترجمة القرآن، قراءة القرآن بغير العربية، رواية القرآن بالمعنى.
هذه مسائل من أهم المهمات، من عضل المسائل. فهذه موضوع الباب الأول. وهذا هو الأصل؛ لأن الباب عندهم، الأبواب عندهم إنما تجعل للمسائل الكبرى، يليها ما تحويه الفصول , أما المقدمات في الغالب فلا يُدخَلُ فيها في صلب البحث أو صلب الكتاب.
على كل حال على هذا رتبه.
[1] انتهت مادة الشريط الأوّل.

هيئة الإشراف
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
حد علم التفسير
أي
علم أصول التفسير، هو مأخوذ من قولهم: فسرت الشيء: إذا بينته، وسمي العلم
المذكور تفسيراً، لأنه يبين القرآن ويوضحه، قال في النقاية، وهو علم نفيس،
لم أقف على تأليف فيه لأحد المتقدمين، حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين
البلقيني.
فدونه
ونقحه، وهذبه ورتبه في كتاب سماه "مواقع العلوم من مواقع النجوم" فأتى
بالعجب العجاب، وجعله خمسين نوعاً، على نمط، أنواع علوم الحديث، وقد
استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره، وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي
ذكرها، مما أهمله، وأودعتها كتاباً سميته "التحبير، في علم التفسير"،
وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة، ونقلت فيها حدوداً كثيرة للتفسير ليس هذا
موضع بسطها، فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني، وتمامه على يدي،
وهكذا كل مستنبط يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيراً ثم يكبر (علم به) أي فيه وهو يتعلق بقوله (يبحث) بالبناء للمفعول: أي تعريف علم التفسير، علم يبحث فيه أي في ذلك العلم (عن أحوال كتابنا) معاشر المسلمين، أي الكتاب المنزل إلى نبينا، وهو القرآن، فالإضافة للتشريف (من جهة الإنزال) أي نزوله كمكية أو مدنية أو سفرية أو نحوها، والجار والمجرور: حال وبيان للأحوال.
(ونحوه)
بالجر: عطفاً على الإنزال، وذلك كسنده وأدائه وألفاظه، ومعانيه المتعلقة
بألفاظه، والمتعلقة بالأحكام، وغير ذلك، واعلم أن هذا الحد لعلم التفسير،
بمعنى أصوله الذي هو كمصطلح الحديث، لا بمعنى التبيين والتوضيح لألفاظ
القرآن، فإنه كما قال الصاوي: علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله، على حسب
الطاقة البشرية (بالخمس والخمسينا) متعلق بحصرت والألف للإطلاق (قد حصرت) أي جمعت (أنواعه) حصراً (يقينا، وقد حوتها) أي شملت تلك الأنواع الخمس والخمسين (ستة) بالرفع على الفاعلية (عقود) بالرفع أيضاً على البدلية من ستة، والعقود: جمع عقد، وهي القلادة، شبه الناظم كل جملة من المسائل بالعقد في حسنها، (وبعدها) أي الستة العقود (خاتمة تعود) وترجع مقاصدها إلى تلك الأنواع (وقبلها) أي الستة العقود (لا بد) أي لا محالة (من مقدمه) مبينة بعض الأحكام والمسائل التي اختص بها علم التفسير وذلك: كتعريف القرآن، والآية، والسورة، وغيرها كما قال الناظم (ببعض ما خصص فيه) أي في علم التفسير (معلمه) من الإعلام: أي مشعرة، وهو صفة لمقدمة، والله أعلم.