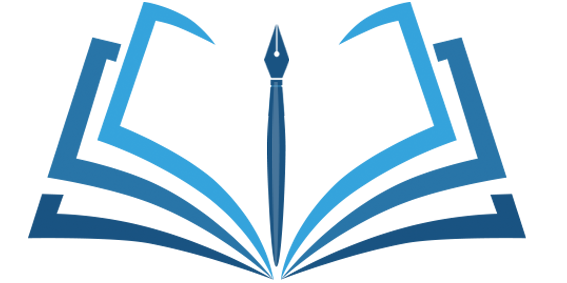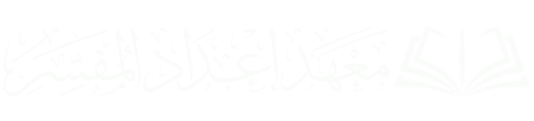منظومة الزمزمي
القسم الأول
معنى القرآن والسورة والآية
16 Nov 2008
مقدمة
فَذَاكَ مَا عَلَى مُحَمَّدٍ نَزَلْ = وَمِنْهُ الِاعْجَازُ بِسُورَةٍ حَصَلْ
وَالسُّورَةُ الطَّائِفَةُ الْمُتَرْجَمَهْ = ثَلَاثُ آىٍ لِأَقَلَِّهَا سِمَهْ
وَالآيَةُ الطَّائِفَةُ الْمَفْصُولَهْ = مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ وَالْمَفْضُولَهْ
مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ كَتَبَّتِ = وَالْفَاضِلُ الَّذْ مِنْهُ فِيهِ أَتَتِ
بِغَيرِ لَفْظِ الْعَرَبيِّ تَحْرُمُ = قِرَاءَةٌ وَأَنْ بِهِ يُتَرْجَمُ
كَذَاكَ بِالْمَعْنَى وَأَنْ يُفَسَّرَا = بِالرَّأْيِ لَا تَأْوِيلَهُ فَحَرِّرَا

هيئة الإشراف
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
(المُقَدِّمَةُ)
القُرْآنُ مُنَزَّلٌ علَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ للإعجازِ بسُورَةٍ مِنْهُ، والسُّورَةُ: الطَّائِفَةُ المُتَرْجَمَةُ تَوْقيفًا، وأَقَلُّهَا ثَلاثُ آياتٍ.
والآيةُ: طَائِفَةٌ مِن كَلِمَاتِ القُرْآنِ مُتَمَيِّزَةٌ بفَصْلٍ، ثُمَّ مِنْهُ فَاضِلٌ؛ وهو كَلامُ اللهِ في اللهِ، ومَفْضُولٌ؛ وهو كَلامُهُ -تَعالَى- في غَيْرِه، وتَحرُمُ قِرَاءَتُهُ بالعَجَمِيَّةِ، وبِالمَعْنَى، وتَفْسِيرُهُ بالرَّأْيِ، لا تَأْوِيلُهُ.
المقدمة في حدود لطيفة
القرآن حده: الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه
- فخرج بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: التوراة والإنجيل وسائر الكتب.
- وبالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين انا عند ظن عبدي بي وغيره، والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لانه المحتاج إليه في التمييز.
وقولنا بسورة هو بيان لأقل ما وقع به الإعجاز وهو قدر أقصر سورة كالكوثر أو ثلاث آيات من غيرها بخلاف ما دونها.
- وزاد بعض المتأخرين في الحد: المتعبد بتلاوته، ليخرج منسوخ التلاوة.
والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة أي المسماة باسم خاص توقيفا أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكافيجي في تصنيف له، وليس بصاف عن الإشكال فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين سوراً باسماء من عندهم كما سمى حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب
وسمى سفيان بن عيينة الفاتحة بالواقية، وسماها يحيى بن كثير كافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك مما بسطناه في التحبير في النوع الخامس والتسعين.
وقال بعضهم:السورة قطعة لها أول وآخر، ولا يخلو من نظر لصدقِه على الآية، وعلى القصة.
ثم ظهر لي رجحان الحد الأول، ويكون المراد بالتوقيفي: الاسم الذي تذكر به وتشتهر.
(وأقلها ثلاث آيات) كالكوثر على عدم عد البسملة آية إما على عدم كونها من القرآن في كل سورة كما هو مذهب غيرنا، أو على أنها منه لكنها ليست آية من السورة بل آية مستقلة للفصل كما هو وجه عندنا.
وليس في السور أقصر من ذلك.
والآية: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وهو آخر الآية.
ويقال فيه: الفاصلة.
( ثم منه) أي من القرآن (فاضل) وهو كلام الله في الله كآية الكرسي (ومفضول) وهو كلامه تعالى في غيره كسورة تبت كذا ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهو مبنى على جواز التفاضل بين الآي والسور وهو الصواب الذي عليه الأكثرون منهم مثل إسحاق ابن راهويه والحلومي والبيهقي وابن العربي، وقال القرطبي: إنه الحق الذي عليه جماعة من العلماء والمتكلمين.
وقال أبو الحسن بن الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل كحديث البخاري: (أعظم سورة في القرآن الفاتحة) وحديث مسلم: (أعظم آية في القرآن آية الكرسي) وحديث الترمذي: (سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن البقرة) وغير ذلك.
ومن ذهب إلى المنع قال: لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه.
وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما وقد بينته في التحبير.
(وتحرم قراءته) أي القرآن بالعجمية أي باللسان غير العربي لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له، ولهذا يترجم العاجز عن الأذكار في الصلاة ولا يترجم عن القرآن بل ينتقل إلى البدل وتحرم بالمعنى قراءته وإن جازت رواية الحديث بالمعنى لفوات الإعجاز المقصود من القرآن.
التفسير بالرأى
ويحرم تفسيره بالرأي قال صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وله طرق متعددة لا تأويله أي لا يحرم بالرأى للعالم بالقواعد والعارف بعلوم القرآن المحتاج إليها والفرق أن التفسير الشهادة على الله تعالى والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي، ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع.
وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى فاغتفر.
ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا.
وبعضهم منع التأويل أيضا سداً للباب.

هيئة الإشراف
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير (مفرغ)
فذاكَ مَا عَلى مُحَمَّدٍ نَزَلْ = ........................
(فذاك): الإشارة تعود إلى كتابنا
يعني
المنزل على النبي- عليه الصلاة والسلام- القرآن هو - على ما تقدم أيضاً
الفرقان -المنزل على محمد-صلى الله عليه وسلم- لا على غيره من الأنبياء:
فيخرج بذلك ما نزل على غير محمد- عليه الصلاة والسلام -كالتوراة، والإنجيل،
والزبور، وصحف موسى، وصحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب التي الإيمان بها ركن
من أركان الإيمان.
لكن البحث هذا خاص بالقرآن المنزل على محمد-صلى الله عليه وسلم-ولا يشمل الكتب السماوية الأخرى.
.......................... = ومِنْهُ الإعْجازُ بِسُورَةٍ حَصَلْ
اكتفى بتعريف القرآن أنه المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي حصل به الإعجاز.
نزل على النبي - عليه الصلاة والسلام - ليُبلغ به أمةً اشتهرت بالفصاحة والبلاغة، وحصل التحدي بالقرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وحِكَمِه وأسراره فهو معجز من كل وجه.
الإعجاز: يعني الإعجاز يمكن به تمييز القرآن عن غيره
المنزل على محمد يخرج به الكتب السماوية المنزلة على غيره-عليه الصلاة والسلام-
لكن هل يخرج السنة؟
لا يخرج السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى{3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى{4} }
وفي قضايا كثيرة كان النبي-عليه الصلاة والسلام- يُسأل عن شيء فينـزل جبريل بالوحي مما ليس في القرآن بل من السنة.
فالقيد الأول: يخرج الكتب السابقة.
والثاني: (ومنه الإعجاز بسورة حصل): يخرج الحديث النبوي، والحديث القدسي. يخرج الحديث القدسي المضاف إلى الله-جل وعلا - المنزل على رسوله - عليه الصلاة والسلام - من غير قرآن، ومن باب أولى: يخرج الحديث النبوي.
.......................... = ومِنْهُ الاعْجازُ بِسُورَةٍ حَصَلْ
(الإعجاز بسورة): الله - جل وعلا - تحدى المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعَشْرِ سُوَرٍ فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور
فعجزت العرب أن يأتوا بمثله {لا يأتون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً }
عجزوا عن أن يأتوا بكلامٍ يماثل سورة الكوثر التي هي أقصر السور.
فهل تحداهم بآية؟
الجواب: لا لم يتحدهم بآية؛ لأن الآية قد تكون كلمة واحدة والعرب ينطقون بكلمة. نطقوا بكلمة واحدة وبجملة يوجد نظيرها في القرآن.
يعني العرب لا يعجزون أن ينطقوا بكلمة مفردة؛ مثل: ( مدهامتان ) - مثلاً - ومثل قوله-جل وعلا-: {ثم نظر}.
فهل كانت العرب تعجز عن قول: {ثم نظر}
ألم يقولوها قبل نزول القرآن؟
بلى قالوها، ولكن مع كونه لم يتحدهم بآية فإن هذه الآية في موضعها معجزة؛ لا يقوم مقامها غيرها.
ففي مقامها وإن لم يحصل التحدي بها. ولو كان في غير كلام الله-جل وعلا- يمكن أن تستبدل كلمة من القرآن مثل: {مدهامتان} بغيرها، ولكنها لا تؤدي نفس المعنى الذي أدته تلك الكلمة، وقل مثل هذا في :( ثم نظر ). فالإعجاز حاصل على كل حال. فعجزوا - وهم أفصح الناس وهم أرباب البلاغة - عن الإتيان بمثله، وأذعنوا وصرحوا بعجزهم.
ولا يقال في مثل هذا ما يقوله المعتزلة: أنهم قادرون على ذلك لكن الله_جلّ وعلا_ صرفهم عن ذلك،
وإلا لو صُرفوا عن ذلك ما كان تحديا
فيقال حينئذ: بإمكانهم أن يأتوا بمثله لكنهم عجزوا بالصرف كما يقولون.
المعرّي له كتاب اسمه (الفصول والغايات) كتاب مواعظ قالوا عنه: أنه في بداية الأمر قال في اسمه أنه : (الفصول والغايات في معارضة الآيات) وهو مرمي بالزندقة، وعنده من عظائم الأمور ما عنده، ثم غُيّر اسم الكتاب إلى : (الفصول والغايات في المواعظ البريات)؛ لكن من قرأ هذا الكتاب عرف قيمة الكتاب ومؤلف الكتاب، وعرف حقيقة العجز البشري، لو اجتمع العرب كلهم على معارضته ما استطاعوا، ومسيلمة الكذاب ذُكر عنه شيئاً يعارض به القرآن فأتى بالعجائب والمضحكات.
.......................... = ومِنْهُ الإعْجازُ بِسُورَةٍ حَصَلْ
وأقل السور ثلاث آيات؛ مثل سورة الكوثر.
فيحصل التحدي بثلاث آيات أو بقدرها من الآيات الطويلة.
(والسُّورَةُ الطائِفَةُ المُتَرْجَمَةْ ) هذا تعريف للسورة، وهي مأخوذة من:
_ السور؛ سور البلد لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة تحتها.
- أو من السؤر؛ وهو البقية فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره.
وعلى كل حال: (والسورة: الطائفة المترجمة): المترجمة: أي التي لها ترجمة، أي لها عنوان. سورة الفاتحة، سورة البقرة. وبعضهم كالحجاج - مثلاً، وهو رغم ما أثر عنه من ظلم ومخالفات إلا إن له عناية فائقة بالقرآن - يقول : إنه لا يجوز أن تقول: سورة البقرة، إنما تقول: السورة التي يذكر فيها البقرة ) ويؤثر هذا عن بعض السلف
وذلك لأجل أن تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم له
فإذا قلت: سورة البقرة فما نصيب قصة البقرة من عدد آيات سورة البقرة؟
الجواب: آيات معدودة نسبتها: واحد إلى خمسين من مجموع آيات السورة
فكيف يترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها؟ لابد أن نقول: التي تذكر فيها البقرة. هذا من ذهب إليه من قال بهذا القول.
لكن هذا القول مردود؛ لأن:
- التعبير بسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة كذا، وسورة كذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.
- والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما رمى الجمرة ووقف طويلاً وقال: (ههنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة)، والنصوص في هذا كثيرة جداً.
فالقول الأول لا عبرة به. وعلى هذا فيجوز أن نقول: سورة البقرة.
والسور جاء في أسمائها أحاديث، فمن هذه الأسماء ما هو: توقيفي.
- ومنها: ما هو اجتهادي؛ نظراً إلى محتوى السورة.
فمثلاً: سورة التوبة توقيفي، لكن سورة الفاضحة - مثلاً - اجتهادي؛ نظراً لأنها فضحت المنافقين؛ فسماها بعض السلف الفاضحة.
والسُّورَةُ الطائِفَةُ المُتَرْجَمَةْ = ثَلاثُ آيٍ لأَقَلِّها سِمَةْ
ثلاثة آيات، سورة الكوثر ثلاث آيات. {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ{1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{2} إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{3} }
لكن هل التعداد وكونها ثلاث على اعتبار أن البسملة آية منها أو على غير ذلك؟
الجواب: على غير اعتبار أن البسملة آية منها.
- ومن أهل العلم من يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن.
- ومنهم: من يرى أنها ليست بآية، ولا في سورة واحدة من سور القرآن .
- ومنهم: من يرى أنها آيةٌ واحدة ٌ نزلت للفصل بين السور.
فالشافعي يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة.
فمنهم من يرى أنها آية من كل سورة من سور القرآن بما في ذلك الكوثر، فتكون أربع آيات على هذا القول.
لكنهم يُجمعون بأنها ليست آية في أول التوبة، ويجمعون على أنها بعض آية في سورة النمل، فهذان محلا إجماع، والخلاف فيما عدا ذلك.
فهل هي مئة وثلاث عشرة آية، أو آية واحدة أو ليست بآيةٍ أصلاً ؟
والخلاف معروفٌ بين أهل العلم. ومن أقوى الأدلة الإجماع في الطرفين، كل من الطرفين ينقل إجماع ويعتمد ويستند على إجماع.
فالذي يقول هي آية يستدل بإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف؛ ولولا أنها آية لم يجَرؤوا على كتابتها في المصحف.
والذين يقولون أنها ليست بآية استدلوا بالإجماع على أنها لو كانت آية لما جاز الاختلاف فيها، فإن من جحد حرفاً من القرآن المجمع عليه يكفر عند أهل العلم؛ لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان.
والذي يقول: إنها آية نزلت للفصل بين السور: وهذا المرجح عند شيخ الإسلام، وجمع من أهل العلم يخرج من الإجماع، وكأن هذا أقوى الأقوال.
والآيةُ الطائفةُ المَفْصُولَةْ = مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ والمَفْضُولَةْ
(الآية): الأصل أنها العلامة. والآيات لبدايتها ونهايتها علامات. فلا تمتزج بغيرها.
(مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ ): الآية مفصولة عما تقدمها وعما تأخر عنها. فهي مميزة الأول والآخر؛ لكن قد يكون التمييز ظاهراً لكل أحد، وقد يخفى على بعض النّاس كما إذا تعلقت الآية الثانية بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو تعلق الجار والمجرور بمتعلقه
- كآية البقرة: { َلعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ () فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}
- وآية النور: { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ () رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تجارة }
فقد
يخفى انفصال الآية وانفكاكها عما قبلها على بعض الناس، ولا سيما أن الكتابة
في السابق قد لا يميز فيها بين الآيات كتابة، وقد وجد في بعض المصاحف أن
الآيات مكتوبة فيها بدون فواصل.
(من كلمات): قد تكون الآية من كلمةٍ واحدة؛ كما في قوله تعالى: {مدهامتان}
أو من كلمتين كما في قوله تعالى: {ثم نظر}
ومنها ما هو أكثر من ذلك.
والآيـةُ الطائفـةُ المَفْصُـولَةْ = مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ والمَفْضُولَةْ
مِنْهُ على القَولِ بهُ كَـ«تَبَّتِ» = والفاضِلُ الَّذْ مِنْهُ فيهِ أَتَتِ
(من كلمات منه): يعني من القرآن.
(والمفضولة): يعني منه الفاضلة والمفضولة.
(على القول به): يعني مسألة: هل في القرآن فاضل ومفضول؟
قالوا: نعم في القرآن فاضل ومفضول.
المتكلم هو الله - جل وعلا - بالجميع؛ لكن الكلام يتفاضل.
فالآيات أو السور التي تتكلم أو تتحدث عن الله-جل وعلا- أفضل من الآيات التي تتحدث عن الأحكام.
والآيات التي تتكلم في العقائد - مثلاً - أفضل من التي في الأحكام، فضلاً عن كونها تتحدث عن قصة رجلٍ كافر كـ( تبت ).
وجاء في فضل {قل هو الله أحد} سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن.
وجاء في فضل آية الكرسي وجاء في فضل الفاتحة، وغير ذلك من السور والآيات التي جاءت بها النصوص.
ولا يعني هذا تنقص بعض السور أو قلة الأجر في قراءتها
بل سورة {تبت} في كل حرف عشر حسنات كغيرها من السور؛
لكن هل تعدل ثلث القرآن مثل ( قل هو الله أحد )؟
الجواب: لا، ويقال في مثل هذا الخلاف ما يقال في التفضيل بين الأنبياء.
قال الله - جل وعلا -: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.
وأما قول النبي-عليه الصلاة والسلام -: (( لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى ))
فيراد به ما إذا أدى هذا التفضيل إلى تنقص المفضول، فإنه يمنع حينئذ التفضيل سواء كان في الآيات أو بين الرسل
لأن بعض الناس، لاسيما من بعض الفرق المبتدعة لا يقرأ سورة {تبت}
لأنها تتحدث عن أبي لهب وهو عم النبي- عليه الصلاة والسلام - وعم الرجل صنو أبيه قاولوا: إن هذه إهانة للنبي-عليه الصلاة والسلام-أن نتكلم في عمه.
هذا عندهم - نسأل الله السلامة والعافية -
فإذا أدى هذا إلى التنقص فيمنع التفضيل.
(والمفضولة منه على القول به ): على القول بأن فيه فاضل ومفضول
الواو استئنافية.
(والمفضولة منه): أي من القرآن.
(على القول به): جواز التفضيل به كـ( تبت).
(والفاضِلُ الَّذْ مِنْهُ فيهِ أَتَتِ)
(الَّلذ) هي الذي تحذف الياء أحياناً ولا سيما في الشعر
كما قال ابن مالك في ألفيته:
صُغْ مِنْ مَصوغٍ منهُ للتَّعَجُّـبِ = أَفعلَ للتفضيلِ وَأْبَ اللَّـذْ أُبِـيفتحذف الياء للنظم.
( منه): من القرآن. ( فيه): أي في الله - جل وعلا - (أَتَتِ)
بِغَيْرِ لَفْظِ العَرَبِيِّ تَحْرُمُ = قِـراءَةٌ وأَنْ بِهِ يُتَرْجَمُ
هل تجوز قراءة القرآن بغير العربية؟
الجواب: تحرم قراءة القرآن بغير العربية، لكن هل هذا ممكن؟
وكذلك الحال في الترجمة، هل هناك ترجمة حرفية؟
بمعنى:
أنك لو أتيت بكلام عربي مقطوعة شعرية أو حديث أو قصة؛ وأعطيتها شخصاً
يترجمها إلى الإنجليزية أو إلى الفرنسية، وتمت الترجمة وألغيت الكلام
العربي الأول، ولم تطلع عليه الطرف الثالث؛ وقلت له: أعده إلى العربية،
ترجمه إلى العربية، فهل سيتطابق الكلام الثالث مع الأول؟
الجواب: لا، إذن الترجمة الحرفية غير ممكنة.
لأنه
ينظر إلى معنى من المعاني يسبق ذهنه إليه، وقد يحرف في المعنى المترجم لعدم
فهمه لمعاني العربية فإذا أريدت إعادته إلى الأصل ما استطاع؛ لأن اللفظة
الواحدة في العربية لها عدة معان.
مثال: كيف يترجم قوله تعالى: { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} إلى غير العربية؟
هل يمكن ترجمتها إلى غير العربية بحروفها؟
بمعنى
أن يؤتى إلى (هن) : الهاء وتضع مكانها ما يقابلها من اللغة الأخرى ، وهكذا
ما بعدها من الحروف، فالترجمة الحرفية بالحروف غير ممكنة.
وكذلك
بالكلمات: فلا يمكن ترجمتها كلمة كلمة؛ فالكلمة الواحدة تحتمل أكثر من
معنى فقد يسبق إلى ذهنه أول المعاني، فإذا أريد إعادة الكلام إلى العربية
يسبق إلى ذهن المترجم كلمة قد لا تكون هي المرادة.
فقال بعض المترجمين في قوله - جل وعلا - : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ }؛ قال : أنت بنطلون لها وهي بنطلون لك!!
فالترجمة
الحرفية مستحيلة، فلم يبق إلا ترجمة المعاني، وترجمة المعاني لا سيما
بالتعبد بالقراءاة، وترتيب الآثار عليها، وتصحيح العبادات بها لا تمكن؛
لأنه لا يمكن الترجمة إلا بتجاوز مرحلتين:
قراءة المعنى بغير العربية.
ولذا
يحرمون أيضاً قراءة القرآن بالمعنى. إذا أجازوا رواية الحديث بالمعنى، كما
هو قول الجمهور لأجل الحاجة والضرورة داعية إليه، وكتب السنة شاهدة على
ذلك؛ تجد القصة الواحدة تروى بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فجماهير أهل
العلم على جواز الرواية بالمعنى.
لكن إذا قلنا مثل هذا في الحديث هل يمكن أن نقول مثل هذا الكلام في القرآن المنزل المتعبد بلفظه؟
الجواب:
لا يمكن، لذا تحرم ترجمته؛ لأنها فرعٌ عن قراءته بالمعنى فإذا كانت قراءته
بالمعنى لا تجوز؛ فقراءته بغير العربية من باب أولى.
فقالوا: الترجمة الحرفية حرام، وترجمة المعنى جائزة.
وأنا أقول: الترجمة الحرفية مستحيلة أصلاً؛
قد
يمكن وجودها في الألفاظ التي ليس لها مرادف أما الألفاظ التي لها مرادف لا
يمكن فيها؛ لأن المترجم قد يسبق إلى ذهنه معنى لا يسبق إلى ذهن المترجم
الثاني الذي يريد إعادته إلى العربية.
بِغَيْرِ لَفْظِ العَرَبِيِّ تَحْرُمُ = قِـراءَةٌ وأَنْ بِهِ يُتَرْجَمُ
يعني
الأمور المتعبد بها لا يجوز القرءاة فيها بغير العربية؛ كالقراءة في
الصلاة، أذكار الصلاة، التكبير، التسبيح، وغير ذلك مما يقال كالتشهد في
الصلاة لابد من أن يقال بالعربية.
ومنهم من يقول: إذا لم يستطع تعلم العربية فيأتي به بلغته خير من ألا يأتي بها أصلاً، لكن هذه ألفاظ متعبد بها.
خطبة
الجمعة لا يجوز أن تكون بغير العربية؛ نعم للخطيب أن يترجم بعض الجمل، أو
بعض الكلام وإن كان هذا بعد نهاية الصلاة كان أولى. المقصود أن العبادات
توقيفية، وإذا قال:
بِغَيْرِ لَفْظِ العَرَبِيِّ تَحْرُمُ = قِـراءَةٌ وأَنْ بِهِ يُتَرْجَمُ
وهذه
فتنة وقعت قبل سبعين،أو ثمانين سنة، وأُلف فيها مصنفات كثيرة، وردود من
أطراف متعددة حول ترجمة معاني القرآن الكريم، لكن الآن استقر على الجواز
وترجم ونفع الله به نفعاً عظيماً.
(كذاكَ بالمَعْنى): يعني تحرم قراءته كذلك بالمعنى.
كذاكَ بالمَعْنَى وأَنْ يُفَسَّرا = بالرأَيِ لا تَأْوِيْلَهُ فَحَرِّرَا
التفسير بالرأي حرام، والتأويل جائز.
الفرق
بينهما: أنك إذا افترضت المسألة في شخصين؛ شخص لا علاقة له بالقرآن، ولا
علاقة له بتفسير القرآن ولا قرأ عن أئمة سلف هذه الأمة، ولا عن أئمتها
...شخص خام، ما يعرف من القرآن شيء.
فتعطيه سورة أو آية وتقول: فسر، ما عنده شيء يعتمد عليه ولا يركن إليه؛ هذا تفسيره بالرأي.
لكن
لو افترضت أن شخص له عناية بالقرآن وقرأ من التفاسير ما يؤهله لأن يرجح بين
الأقوال وصار رأيه في فهم هذه الآية يختلف عن فهم ابن كثير، وابن جرير،
والقرطبي وغيرهم من المفسرين، وجاء برأي تحتمله العربية والسياق يقتضيه أو
يدل عليه ولو لم يوجد له سلفٌ بين، لكن هذا الشخص له عناية، له دراية ودربة
في تفسير القرآن لأن فَهم النصوص يحتاج إلى دُربة؛ يعني الآن عندك أحاديث
كثيرة إذا أردت شرحها وبيان معانيها يُعوِزُك إِعِواز شديد، يعني حديث في
مسند أحمد ما شرح أبدًا أو في مُسند الطيالسي وما تحفظ له الشراح ، وإنت ما
تدري وش معناه، أنت يخفى عليك ليش ؟
لأنّك
مالك عناية بالسنّة ولا قرأت في كتب السنّة؛ لكن الذي لديه خِبرة ودِرَاية
وعناية، ويَعرِف كيف يَتصرف أهل العلم في فهم السنّة تكون لديه الملكة في
شرح السنّة وقل مثل هذا في القرآن، شخص له عناية بالقرآن ويلُوح له من معنى
الآية مالم يَلُوح لأكثر المـُفسرين قبله :((رُبّ مُبلَغٍ أوعى من سامع))،
هذا ينطبق عليه ولا يقول مثل من يقول بعضُ الكتاب: القرآن بالعربية وهم
رجال ونحن رجال نفهم مثل ما يفهمون، نقول: ليس بصحيح، كيف تفهم وهم
يَفهمون، أنت لو أن وَلَدك أُصيب بمرض وإحتاج إلى عملية فاحضرت السكين
قالوا: مجنون هذا، ويش علاقتك بالطب؟
ونحن
نقول: أنت مجنون لا علاقة لك بالتفسير، أما الشخص الذي له خِبرة ودُربه،
الطبيب لو جاءهُ حالة ما مرّت عليه قبل ذلك، نقول له: لا، لا تتصرف!؛ لكنّه
طبيب مشهود له بالخبرة وعانى من الحالات التي هي نظائر هذه الحالة، أو
قريب منها لابد أن يتصرف.
ففرق
بين أن يأتي شخص لا علاقة له، ولاخبرة، ولا دُربة، ولا يعرف من القرآن شيء
ويأتي يُفسر القرآن، ومع الأسف الشديد أنّه يوجد من يهجم على الآيات وعلى
السنّة فيُفسر، جاء ذمُ التفسيرِ بالرأي، وإذا كان أهل العلم يحتاطون في
تفسير السنّة وشرحها، فلا أن يحتاطوا في تفسير القرآن من باب أولى؛ لأن
الذي يُفسر القرآن يدعي أن هذا مُرادُ الله من كلامه فأنت قولته وحملته من
المعنى ما لم يحتمل، حملت هذا الكلام من المعنى مالا يحتمل؛ ولذا جاء الذّم
الشديد لمن قال بالقرآن برأيه، وقد يتجه الذم على من قال بالقرآن برأيه
ولو أصاب،كمن حكم بين إثنين بجهل فهو في النّار ولو أصاب الحكم، تفسير
الآية من طالب علم له عناية لكن ماهي بعناية كافية تُؤهِلُه لأن يَجزِم، له
عناية بالتفسير، أو مجموعة من طلاب العلم من متوسطي الطلاب معهم القرآن
يتدارسونه، فما معنى هذه الآية؟
لو
قال بعضهم: لعّل المـُراد كذا، ولعلّ المـُراد كذا ولم يقطعوا بشيء وراجعوا
على ذلك الكتب، ووافق تفسيرُ أحدِهم إذا جيء بصيغة الترجي فالأمرُ فيه
سَعة، من غير جزم وكذلك في السُنّة ولذلك في حديث: السبعين ألف الذين
يدخلُون الجنّة من غير حساب ولا عذاب، قاله النبيّ _عليه الصلاة والسلام_
ودخل تركهم،((فباتوا يدوكون))، لعلّهم كذا... لعلّهم كذا؛ فلم خرج
النبيّ_عليه الصلاة والسلام_ أخبروهُ وما ثَرب عليهم ولا خطأهم، لماذا؟
لأنّهم
لم يجزموا، فالإتيان بحرف الترجي ممن له شيء من الخبرة، وله شيء من
المعرفة، ماهو إنسان خالي جاي من .. لا علاقة له يالقرآن أو بالسنّة ويقول
لعلَّ!، فمثل هذا إذا ترجى، إذا جاء بحرف الترجي وقال: لعلّ المراد كذا...
لعلّ المـ ....، يُحتمل منه ولا يُثرب عليه على ألا يجزم، ولايَقطع حتى
يُراجع كلام أهل العلم وما قالهُ سلف هذه الأمّة عن كتاب الله.
.......................... = ...... لا تَأْوِيْلَهُ فَحَرِّرَا
التأويل هو:
أن
يُفسر بالرأي يعني: من غير اعتمادٍ على تفسير القرآن بالقرآن، ولا بالسنّة،
ولا بأقوال الصحابة والتابعين، ولا بلغة العرب فمن التفسير ما يعرفه العرب
من لُغتهم ومنه ما يُعرف بالقرآن في موضع آخر إذا ضمت آية إلى أخرى تبين
المـُراد منها، ومنها ما يُعرف معناه بالسنّة؛ لأن السنّة تُبين القرآن
وتُفسره، ومنها ما يُعرف بما يُروى عن الصحابة الذين عاصروا التنزبل
وعايشوا الرسول_عليه الصلاة والسلام_ إيه لكن هل اكتُشف قطعًا أو ظنًا؟
لأن
هناك نظريات، وسارع بعض النّاس في تنزيل بعض الآيات عليها، ثمّ اكتُشف
غيرُها، مثل هذا لا يجوز اقترانه بالقرآن؛ لأنّه يُعرضه للنفي والإثبات،
يُعرضهُ للنفي والإثبات؛ لكن إذا وُجِدَ أمر قطعي، يعني أدركتهُ الحواس،
فمثل هذا لاشك أنّه مما يُخبِرُ الله_جلّ وعلا_، أو مما أخبر الله _جلّ
وعلا_ بكتابه عنه وحصل على أرض الواقع .
(لا تأويلهُ): التفسير من الفَسِر وهو الكشف والتوضيح والبيان.
والتأويل يُطلق ويُراد به:
_التفسير، وكثيرًا ما يقول ابن جرير الطبري:"القول في تأويل قول الله_جلّ وعلا_ كذا، ويريد بذلك التفسير.
_ويُطلق ويُراد به:
ما يؤول إليه الكلام _ يعني حقيقة الكلام_ فالنبيّ_عليه الصلاة والسلام_
يُكثر من الاستغفار، والتسبيح، يتأول القرآن، يتأول سورة النصر، كما قالت
عائشة_رضي الله عنها_.
ومنه:
حملُ القرآن على المعنى المـَرجوح، هذا تأويل الراجح ظاهر، والمرجوح مُؤول
والذي لا يحتمل نص فالنص مافيه إشكال، الآية التي لا تحتمل لابد أن تُفسر
نصًا، الآية المـُحتملة لمعنى راجح ، ومعنى مرجوح، الراجح هو: الظاهر،
وعليه المـُعول عند أهل العلم؛ لكن قد يمنع من إرادة هذا الظاهر مانع
فيُلجأ حينئذ إلى الإحتمال المـَرجوح وهو: التأويل، والتأويل: مركب
ارتَكَبَهُ المبتدعة؛ لإثبات ما أرادوا ونفي ما لم يُريدوا، لإثبات ما
أرادوا إثباتهُ ونفي ما أرادوا نفيهُ من غير دليلٍ يقتضيه، أما إذا قام
الدليل على منع إرادة الظاهر؛ فلابد من أن يُرتَكب التأويل.
.......................... = ...... لا تَأْوِيْلَهُ فَحَرِّرَا
يعني: عند اقتضاء الحاجةِ إليه، لا متى نسلك هذا المسلك؟
إذا وُجد ما يمنع من إحتمال الراجح، إذا وجد ما يمنع من إحتمال المعنى الراجح مثلاً: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا}، الاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ: معهم بينهم مختلط بينهم، بذاته معهم مختلط بهم .
لكن
الاحتمال المـَرجوح: إنّه معهم بحفظه ورعايته وعنايتهِ المعية الخاصة،
نعم... هذا احتمال مرجوح منع منه أدلةٌ تمنع من الحلول والمخالطة
والممازجة.
لا،
القول المرجوح لهم ولا في لغة العرب، [المعنى] في لغة العرب، اللفظ يحتمل
المعنيين؛ لكن هذا راجح وهذا مرجوح، الأصل أن نعمل بالراجح باستمرار في كلّ
شيء تعمل بالراجح؛ لكن لو كان هذا الراجح توجد نصوص تمنعُ من ارادته تلجأ
إلى المعنى الثاني وهو مقبول في لغة العرب، ما تأتي بلفظ مُبتكر لا سلف لك
به وتقول: احتمال مرجوح لا.
سؤال: التعريف
المشتهر للحديث القدسي: هو كلامٌ معناه من الله-سبحانه وتعالى-ولفظه من
النبي-صلى الله عليه وسلم-أليس في هذا مدخل للأشاعرة الذين يقولون: أن
الكلام نفسي لله-سبحانه وتعالى-؟
الجواب: أولاً: القرآن قبل ذلك كله:
- يطلق ويراد به: اسم المفعول: المقروء، المتلو.
- ويطلق ويراد به: القراءاة.
فالمقروء هو القرآن.
والقراءة يقال لها: قرآن.
كما قال الشاعر في عثمان - رضي الله عنه -:
ضحى بأشمط عنوان السجود به = يقطع الليل تسبيحاً وقرءاناً
يعني قراءاة.
هذا
القران المنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام - المعجز الذي سبق الحديث عن
إعجازه ما علاقته بالكلام النفسي - الذي يقوله الأشعرية -:
أولاً: الله - جل وعلا - كما هو معتقد أهل السنة والجماعة: يتكلم بحرف وصوت مسموع.
دلت النصوص على أن جبريل يسمع كلام الله - جل وعلا -.
ثانياً: الله - جل وعلا- يتكلم متى شاء إذا شاء؛ فكلامه وإن كان قديم النوع إلا إنّه مُتجدد الآحاد، فأفراده متجددة يتكلم متى شاء إذا شاء.
وعند الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون: كلامه واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، ولم يتكلم بعد ذلك، وكلامه واحد.
هذا الكلام الواحد؛ إن عُبر عنه بالعربية صار قرآناً، وإن عبر بالعبرانية صار توراة، وبالسريانية يصير إنجيلاً!
إذاً
الشرائع متطابقة؛ جميع الأحكام التي جاءت في التوراة - على هذا الكلام - هي
جميع الأحكام من غير زيادة ولا نقصان جاءت في الإنجيل؛ إذن هي جميع
الأحكام التي جاءت في القرآن، ولا فرق.
ففي التوراة - على قولهم - سورة {تبت} إلا إنها بالعبرانية!
وفي الإنجيل سورة {تبت} إلا إنها بالسريانية!
فعلى
كلامهم: لما نزلت على النبي - عليه الصلاة والسلام - سورة اقرأ في الغار
وذهب بها ترجف فؤاده ثم التقى بورقة بن نوفل وقرأ عليه ما أنزل عليه، وشهد
له بالرسالة، وكان ورقة كما في الحديث الصحيح قد قرأ الكتب السابقة من
التوراة والإنجيل، فكان يترجم هذه الكتب السابقة من العبرانية والسريانية
إلى العربية.
فلما
قرأ عليه النبي- عليه الصلاة والسلام - سورة اقرأ - قرأها بالعربية، وهو
يعرف العبرانية و السريانية، ويعرف التوراة والإنجيل، ويترجمها من لغةٍ إلى
لغة؛ هل قال: هذا موجود عند من تقدم من الرسل؟
هل سورة (اقرأ) موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل باللغات الأخرى؟
قال: {هذا الناموس الذي أنزل على موسى} يعني جبريل.
فببداهة
العقول لايمكن أن يقول قائل: إن الأحكام الموجودة في القرآن بما في ذلك ما
اقتضته الحاجة المتأخرة؛ لأن من القرآن ما نزل بسبب واقعة؛ كقصة الظهار
التي نزلت في هلال بن أمية، وقصة اللعان التي نزلت في عويمر العجلاني
هل يقال: إن هذه القصة حصلت لليهود والنصارى بلغاتهم؟
هل يمكن أن يقول هذا عاقل؟
فهذا قولٌ باطل،
ففي
التوراة ما يخصها من الأحكام، وفي الإنجيل ما يخصه، وفي كتابنا ما يخصه.
ويستقل كتابنا بالإعجاز والحفظ؛ فكتابنا محفوظ تكفل الله بحفظه إلى قيام
الساعة، إلى أن يرفع، وكتبهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها.
وهناك قصة ليحيى بن أكثم القاضي مع يهودي دعاه يحيى إلى الإسلام فرفض، وغاب سنةً كاملةً ثم حضر على رأس الحول وأعلن إسلامه.
فسأله
يحيى بن أكثم عن السبب، فقال: إنه في هذه المدة نَسخ نُسخاً من التوراة
وحرف وقدم وآخر وزاد ونقص وباعها على اليهود في سوق الوراقين عندهم
فتخطفوها واعتمدوها، ثم بعد ذلك نَسخ نُسخاً من الإنجيل وقدم فيها وأخر،
وزاد فيها ونقص وعرضها على النصارى في سوق الوراقين وفعلوا بها مثل ما فعل
اليهود، صارت عمدة عندهم.
ثم
عمد إلى القرآن فنسخ منه نسخاً وزاد شيئاً يسيراً ونقص شيئاً لا يدركه إلا
النظر الثاقب فعرضه في سوق الوراقين فكل واحد يطلع على المصحف يرميه في
وجهه.
يقول: عرفت بهذا أن هذا الدين هو المحفوظ.
هذا الدين لا يمكن أن يتلاعب به المرتزقة، مثل التوراة والإنجيل.
لما ذكر هذا ليحيى بن أكثم، ويحي بن أكثم حج في تلك السنة وذكر القصة لسفيان بن عيينة، قال له: هذا منصوص عليه في القرآن.
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }فقد تولى الله حفظه فلا سلطان لأحدٍ عليه.
وفي الكتب الآخر {بما استحفظوا عليه} ولم يحفظوا.
والحاصل: أن وجوه الرد عليهم كثيرة، ونكتفي بهذا.

هيئة الإشراف
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
مقدمة
أي هذه مقدمة في بعض الحدود والأحكام التي اختص بها علم التفسير، وهي مقدمة
كتاب؛ إذ هي مسائل تذكر أمام المقصود، لارتباط بينها وبين المقصود، لا
مقدمة علم، فإنها تصور العلم المشروع فيه: إما بوجه ما، أو على بصيرة،
فيحصل الأول منهما بمجرد تصور حده، والثاني يتصوره بمباديه العشرة، وإذا
عرفت ذلك (فـ) أقول لك (ذاك) أي حد القرآن عرفا (ما) أي: كلام نزل (على) سيدنا (محمد) صلى الله عليه وسلم فالجار والمجرور متعلق بقوله (نزل و) الحال (منه) أي من ذلك الكلام (الإعجاز) للخلق (بسورة حصل) فالمعنى،
حد القرآن: كلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاز منه حصل بسورة، فقوله كلام:
جنس شامل لجميع الكلام، وقوله نزل على سيدنا محمد: فصل مخرج للكلام النازل
على غيره من الأنبياء، كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب والصحف، وقوله ومنه
الإعجاز إلخ، فصل ثان، مخرج للأحاديث الربانية، كحديث الصحيحين: ((أنا عند ظن عبدي بي))، ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز، وإن نزل القرآن لغيره أيضاً، لأنه المحتاج إليه في التمييز، فهو الأهم، وأما القرآن لغة: فمأخوذ من القرء، وهو الجمع.
"تنبيه" اختار ابن الهمام أن الإعجاز غير
مقصود بالذات من الإنزال، وإنما الإنزال للتدبر والتفكر، وأما الإعجاز
فتابع غير مقصود، ولا شك أن حصوله بغير قصد أبلغ في التعجيز، وقد توقف فيه
تلميذه ابن أبي شريف، قاله في نشر البنود، وقوله بسورة إلخ: بيان لأقل ما
يحصل به الإعجاز، وهو بقدر أقصر سورة كالكوثر، وإنما كان أقل الإعجاز بأقصر
سورة لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها
وما بعدها، فتكون ثلاث آيات، وزاد بعضهم في الحد فقال: "المتعبد بتلاوته"
ليخرج منسوخ التلاوة، وفيه أنه حكم من أحكام القرآن، وهي لا تدخل في
الحدود، وأجيب كما في نشر البنود، بأن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره،
بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على محمد صلى الله
عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبداً، ولم تعلم عين القرآن
منهما، فيقال لك: هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
للإعجاز المتعبد بتلاوته.
ثم قال (والسورة) أي حدها (الطائفة) بالرفع: خبر أي جملة من القرآن (المترجمة)
أي المسماة باسم خاص لها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تذكر
بذلك الاسم وتشتهر به، وهذا التعريف للكافيجي، وهو الراجح، وقيل هي قطعة
لها أول وآخر، وفيه نظر، فإنه صادق على الآية والقصة، قاله في شرح النقاية
"فائدة": ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار: شيء ابتدعه الحجاج في زمنه،
ثم قال مبيناً لأقل السورة (ثلاث آي لأقلها) أي: السورة، متعلق بقوله (سمه)
أي علامة، وذلك كالكوثر، وليس في السور أقصر من ذلك، وهذا بناء على القول
بعدم عد البسملة من القرآن في كل سورة، كما هو مذهب غير الشافعية، أو على
القول بأنها منه لكنها ليست آية من السورة بل آية مستقلة للفصل، كما هو وجه
عند الشافعية، وأما على الأصح عندهم من أنها آية من كل سورة، فلا يكون أقل
السورة ثلاث آيات، بل أقلها أربع.
"تتمة": حاصل الكلام على البسملة: أن التي في سورة النمل لا خلاف في كونها
من القرآن، كما أنه لا خلاف في التي في أول براءة أنها ليست منه، وإنما
الخلاف في التي في أوائل السور، فعند إمامنا الشافعي أنها آية من القرآن
ومن كل سورة، وعند الإمام مالك أنها ليست آية من القرآن، ولا من كل سورة،
وعند أبي حنيفة أنها آية من القرآن لا من كل سورة، وعند أحمد وأبي ثور أنها
آية من الفاتحة فقط، لا من كل سورة.
ثم شرع في تعريف الآية، فقال (والآية) أي حدها (الطائفة) أي الجملة (المفصولة) أي المميزة بفصل، وهو آخر الآية حال كون تلك الطائفة (من كلمات منه) أي من القرآن (والمفضولة) وهو كلامه تعالى في حق غيره (منه) أي من القرآن (على القول بـ) وجود (ـه كـ) سورة (تبت) يدا أبي لهب (والفاضل) وهو كلام الله في الله، كما قال الناظم (الذ) لغة في الذي (منه) أي من الله (فيه) أي في الله (أتت) أي تلك الآية، والظرفان متعلقان بأتت، والجملة صلة اللذ، وذلك كآية الكرسي وسورة الفاتحة.
ثم القول بوجود الفاضل والمفضول في آيات القرآن، كما في شرح النقاية هو
الصواب الذي ذكره ابن عبد السلام والأكثرون، لورود النصوص بالتفضيل، كحديث
البخاري: ((أعظم سورة في القرآن الفاتحة))، وحديث مسلم: ((أعظم آية في القرآن آية الكرسي))، وحديث الترمذي: ((سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن: البقرة))، وغير ذلك، ومن ذهب إلى المنع قال: لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه،
ثم قال: وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول، لأن كلام الله
بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما. ثم قال: (بغير لفظ العربي) الظرف متعلق بقوله قراءة (تحرم قراءة) بالرفع فاعل أي قراءة القرآن (وأن به يترجم)
بفتح الهمزة، والمصدر المنسبك عطف على بغير لفظ العربي عطف تفسير، والمعنى
تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، وبالمترجم به، لأنه يذهب إعجازه
الذي أنزل له، ولهذا يترجم للعاجز عن الذكر في الصلاة، ولا يترجم عن
القرآن، بل ينتقل إلى قراءة بدله.
"فائدة" الفرق بين الترجمة والتفسير والتأويل: أن الترجمة: هو تبيين الكلام أو اللغة بلغة أخرى كما قيل: وأن التفسير: هو التوضيح لكلام الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الآثار أو القواعد الأدبية أو العقلية، وأن التأويل: هو أن يكون الكلام محتملاً لمعان، فيقصر على بعضها الأبعد بدليل، كما في {ويبقى وجه ربك} فإنه محتمل للوجه الحقيقي وهو الأقرب، وللذات وهو بعيد، فيقتصر على الثاني البعيد، لاستحالة الأول (كذاك) أي مثل ذاك التحريم تحريم قراءته (بالمعنى) أي بخلاف الحديث، فإنه يجوز روايته بالمعنى على المنصور.
(و) تحريم (أن يفسرا) أي القرآن، فالألف للإطلاق، قوله (بالرأي) متعلق بـ (يفسر) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قال في القرآن برأيه -أو بما لا يعلم- فليتبوأ مقعده من النار)).
رواه أبو داود والترمذي وحسنه (لا تأويله)
بالرأي، فلا يحرم للعالم بالقواعد، والعارف بعلوم القرآن المحتاج إليها،
والفرق بينهما كما في شرح النقاية: أن التفسير شهادة على الله تعالى،
والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى مثلاً، فلم يجز إلا بنص من النبي
صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي؛ ولهذا جزم
الحاكم في المستدرك، بأن تفسير الصحابة مطلقاً، أي سواء كان ذكر فيه سبب
النزول أم لا، في حكم المرفوع.
وأما التأويل: فهو ترجيح أحد المحتملات، بدون القطع والشهادة على الله
تعالى فاغتفر، ولهذا. اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات، ولو
كان عندهم فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، وبعضهم منع
التأويل أيضاً سداً للباب، وقوله (فحررا) تكملة والله أعلم.