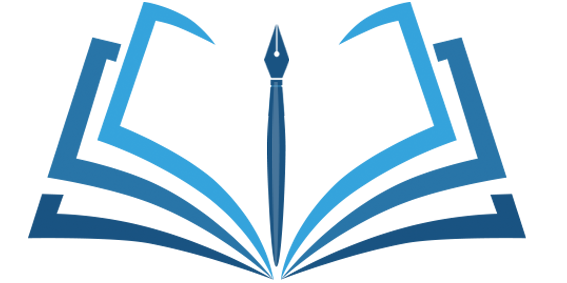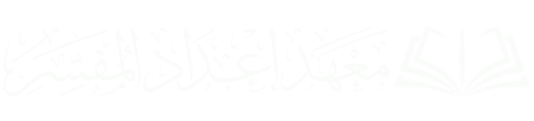النوع العاشر : أسباب النزول
وَصَنَّفَ الْأَئِمَّةُ الْأَسْفَارَا = فِيهِ فَيَمِّمْ نَحْوَهَا اسْتِفْسَارَا
مَا فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحَابِيٍّ رُفِعْ = وَإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِعْ
أَوْ تَابِعِي فَمُرْسَلٌ وَصَحَّتِ = أَشْيَا كَما لِإفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةِ
وَالسَّعْيُ وَالْحِجَابُ مِنْ آيَاتِ = خَلْفَ الْمَقَامِ الْأَمْرُ بِالصَّلاَةِ

هيئة الإشراف
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
النوعُ العاشرُ: أَسْبَابُ النُّزُولِ، وفيه تَصَانِيفُ، وما رُوِيَ فيهِ عَنْ صَحَابِيٍّ فمَرْفُوعٌ، فَإِنْ كَانَ بلا سَنَدٍ فمُنْقَطِعٌ، أو تَابِعِيٍّ، فمُرْسَلٌ، وصَحَّ فِيهِ أَشْيَاءُ، كقِصَّةِ الإفْكِ، والسَّعْيِ، وآيةِ الحِجَابِ، والصلاةِ خَلْفَ المَقَامِ، وَ{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ..} الآيةَ.
أسباب النزول
النوع العاشر أسباب النزول وفيه تصانيف أشهرها للواحدي ولشيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر فيه تأليف في غاية النفاسة لكن مات عن غالبه مسوده فلم ينتشر وما روي فيه عن صحابي فمرفوع أي فحكمه حكم الحديث المرفوع لا الموقوف إذ قول الصحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه مرفوع وذلك منه فإن كان بلا سند فمنقطع لا يلتفت إليه أو تابعي فمرسل لإنه ما سقط فيه الصحابي كما سيأتي في علم الحديث فإن كان بلا سند رد كذا قال البلقيني فتبعناه ولا أدري لم فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي فقال في الأول منقطع وفي الثاني رد مع أن الحكم فيهما الإنقطاع والرد وهذا الفصل محرر في التحبير بما لم أسبق إليه وصح فيه أشياء كقصة الإفك وهي مشهورة في الصحاح وغيرها والسعي ففي الصحيحين عن عائشة كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفاة والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
وروي البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وآية الحجاب وآية الصلاة خلف المقام عسى ربه إن طلقكن الآية فقد روي البخاري عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك.

هيئة الإشراف
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير
الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين، أما بعد...
فيقول المؤلف_رحمه الله تعالى_ النوع العاشر: أسباب النزول.
(الأسباب): جمعُ سبب، والسبب: هو الباعث على الشيء.
وأسباب النزول بالنسبةِ للقرآن كأسباب وُرُودِ الحديث .
قد يقول قائل: ما الداعي لمعرفة السبب؟
الذي
يهمُنا النازل هو الذي يُتعبد به، وكون الأية نزلت في قصة فلان أو فلان،
وكون الحديث ورد في شأن فلان أو فلان، لا يهُمُنا العلماء عُنوا بذلك عناية
فائقة وصنفوا فيه المؤلفات،
أسباب النزول له فوائد كثيرة:
_أوّلاً:
أن معرفة السبب مما يورث العلم بالمـُسبَب، فكم من آية نقرَأُها ولا ندري
ما مراد الله فيها ولا يتضح لنا وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدها،ثم إذا
اطلعنا على السبب زال الإشكال، والعرب يقولون:"إذا عرف السبب بطلَ العجب"،
يعني تسمع كلام تتعجب منه!، كيف يُقال مثل هذا الكلام؟، لا تدري ماوَجههُ؛
لكن إذا عرفت سببهُ تبيّن لك معناه.
_السبب
قد يُحتاج إليه في قصر الحُكم العام على مدلول السبب، الصحابة_ رضوان الله
عليهم_ استشكلوا بعض الآيات فلما بيّن لهم النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_
السبب زال عنهمُ الاشكال، اسشتكلوا ما جاء في آخر البقرة، استشكلوا ما جاء
في سورة الأنعام {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ }[1]....إلخ، قالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل الله تعالى:{إن الشرك لظلمٌ عظيم}،
في بعض الروايات ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم ،
زال بهذا الإشكال، قد نحتاج إلى قصر الـحُكم العام على سببهِ، معروف عند
أهل العلم قاطبة، ونُقل فيه الإجماع أن العبرة:" بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب"؛ لكن قد يُلجأ إلى خصوص السبب إذا كان العموم مُعارض بما هو أقوى
منه، مثال ذلك {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}[2]
، العموم يدل على أن من صلى إلى أي جهةٍ صحت صلاتُه، والأدلة دلت على:أن
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؛ فإذا عرفنا سبب النزول:وهو أنّ
الصحابة اجتهدوا في الصلاة_ فصلّوا إلى جهاتٍ متعددة فنزل قوله_جلّ وعلا_:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}فهذه الآية مقصورة على سببها يعني في من خفيت عليه القبلة ثمّ بان له أنّه صلّى إلى غير القبلة.
مثال ذلك من الحديث:(( صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب))، مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم)).
الحديث الأوّل يدل على: أن الصلاة لا تصحُ من القاعد المستطيع للقيام مُطلقًا.
والثاني يدلُ على: أن الصلاة تصح من القاعد المستطيع مُطلقًا.
هذا
تعارض تام لكن، إذا نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني: من أركان الصلاة
القيام مع القدرة [القيام مع القدرة]، والعلماء يقولون: القيام في الفرض مع
القدرة، لماذا؟
ما حملُوهُ على عمومه لوُجود المعرض، والحديث الثاني:((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم))
له سبب: النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _ دخل المسجد والمدينةُ مُحمة_يعني
فيها حمى_لماذا دخل المسجد وجدهم يصلون من قعود؛ فقال النبيّ_ عليه الصلاة
والسلام _:((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم))
فتجشم النّاس الصلاة قيامًا، هذا سبب الوُرود أخذ منه أهل العلم: أن صلاة
النافلة تصح من قعود ولو كان قادرًا مُستطيعًا، أخذًا من سبب الورود، كونهم
يصلون قبل حضور النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _دخل المسجد فوجدهم يصلون دّل
على أنّها نافلة، لايصلون الفريضة حتى يأتي _عليه الصلاة والسلام_، كما
دّل الخبر على أنّهم يستطيعون القيام، فمن صلّى قاعدًا وهو قادر على القيام
في الفريضة صلاته باطلة ((صلي قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا)) من صلى في الفريضة أو النافلة وهو عاجز صلاتُه صحيحة وأجرهُ كامل ((فإن لم تستطع فقاعدًا))، من صلى النافلة من قعود وهو قادر على القيام صلاتُه صحيحة لكن أجرهُ على النصف؛ فهذه من فوائد معرفة سبب النزول.
_ أيضًا معرفة الأسباب:
إنّه لا يُشكك في دخول الصورة التي تضمنها السبب في العام، يقول أهل
العلم:"دخول السبب في النص قطعي"، لو جاء طالب مثلاً إلى شيخ من الشيوخ
وقال: إن الكتاب الفلاني المـُقرر في الدرس الفلاني ما يوجد في المكتبات،
والطلاب ظروفهم ما تُساعدهم على أن يبذلُوا الأسباب المـُكلفة لإحضار الكتب
و تصوير الكتاب، ثمّ الشيخ بطريقته دَبرَ بعدد الطلاب، ثمّ أعطى جميع
الطلاب إلا هذا الطالب الذي جاء إليه. فهذا أمر غيرحسن لأن أولى النّاس
بالكتاب هذا الطالب اللي هو سبب في إيجاد الكتاب، فأهل العلم يقولون:"دخول
السبب قطعي’’.
فهذه من فوائد معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن، وأسباب الورود بالنسبة للحديث.
وصَنَّفَ الأَئِمَةُ الأَسْفَـارا
......................
صنف الأئمة في هذا النوع أسفار يعني:
كتب (أئمة): جمعُ إمام.
(والأسفار): جمعُ سفر وهو الكتاب، صنفوا في هذا النوع (فيه): يعني في هذا النوع كُتبًا مُتعددة، منها :
_ الواحدي مثلاً صنف في أسباب النزول.
_ والسيوطي صنف في أسباب النزول.
وغيرهما صُنف .يقول:
(فيمم): اقصد.
(نحوها استفسارا): اقصد نحو هذه الكتب الذي صنفها الأئمةُ في أسباب النزول، ويممها واقصدها، واقصد نحوها استفسارًا يعني: اطلب من خلال هذه الكتب أسباب نزول القرآن، واطلب أيضًا: من أسباب ورود الحديث أسباب ورود السنّة وهناك أسباب ورود الحديث للسيوطي، وفي "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني"، وهو أوسع من كتاب السيوطي.
...........................
فِيهِ فَيَمِّمْ نَحْوَها اسْتِفْسَارَا
ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ
وإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِـعْ
يعني: ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع، كيف مرفوع والقائل ابن عباس ولو يقل قال: رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، أو القائل عمر، أو القائل أبو هريرة.قالوا: مرفوع لماذا؟
لأن التنزيل على الرسول_ عليه الصلاة والسلام _لذا هو طرف في التنزيل ذُكر أم لم يُذكر، وعليه حمل أهل العلم كلام الحاكم في قوله:"أن ما يضاف إلى الصحابي، أوتفسير الصحابي مرفوع"، حملهُ أهل العلم على أسباب النزول؛ ولذى يقول الحافظ العراقي:
وعدّوا ما فسره الصحابي رفعًا
فمحمولٌ على الأسباب
(رفعًا فمحمولٌ على الأسباب): لماذا حوروا كلام الحاكم إلى أسباب النزول؟
لأن الصحابي قد يجتهد ويُفسر القرآن من غير رفع للنبي_ عليه الصلاة والسلام _ بل بما يعرفه من لغة العرب، أو بما استنبطه مما أتاه الله_جلّ وعلا_ من فهم كابن عباس الذي دعا له النبي_ عليه الصلاة والسلام _ أن يُعلمه الله التأويل، فالذي يُؤثر عن ابن عباس من التأويل من أثر هذه الدعوة من فهم ابن عباس، وليس بمرفوع وليس له حُكمُ الرفع، وأما الحاكم فكأنّه نظر إلى أن التفسير بالرأي جاء ذمه، والصحابة_رضوان الله عليهم_ من أشدّ النّاس تحري وتثبت في تفسير القرآن من غير مستند.
"أيّ سماءٍ تظلُّني، وأيّ أرضٍ تُقلني؛ إذا قلت في كتاب الله مالم أعلم"هذا قاله أبو بكر وغيره لما سئل في تفسير الأبّ {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً}[3] ، فالمقصود أنّهم يحتاطون فيتحرون، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عمومًا وطالب العلم على وجه الخصوص صاحب تحرّي وتثبث ما يقول في كتاب الله_جلّ وعلا_ برأيه ولا يُفسر السنّة ولا يشرح الحديث برأيه.
هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال:" كلّ ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع" ؛لأنّه جاء ذم التفسير بالرأي إذاً لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف؛ لكن أهل العلم حملُوه على أسباب النزول لأن أسباب النزول النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _ طرف ذُكر أو لم يُذكر.
ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ
.................
يعني من أسباب النزول، وعرفنا وجه هذا الكلام (رفع):
إذا قُلنا أنّه مرفوع والنبيّ _ عليه الصلاة والسلام _ طرف فكيف يُروى عن جَمع من الصحابة أسباب مُختلفة لنازلٍ واحد.
يُذكر عن ابن عباس سبب نزول، يُذكر عن ابن عمر سبب نزول، يُذكر عن كذا .....، إذا كان مرفوع فمصدرهُ واحد لا يقع فيه الاختلاف، قد يتعددالسبب لنازل واحد، قد يتعدد النزول عند بعضهم تنزل الآية مرتين مثلاً في قصتين متوافقتين مما يشملها، يشملهما حكم الآية، وهذا يسلُكله بعض العلماء صيانةً للرواة الإثبات عن التوهيم، وإلا إذا قلنا: إن آيات اللعان نزلت في هلال ابن أمية، أو عويمر العجلاني- والخبر صحيح في الطرفين -جاء أن آيات اللعان نزلت في: عويمر العجلاني في الصحيح، وجاء أنّها نزلت في: هلال ابن أمية. كيف ينزل النازل الواحد في قصتين مختلفتين؟
- النازل نزل بسبب أحدهما، فلما حصلت القصة، نزل القرآن على النبي-عليه الصلاة والسلام-مبيّناً للحكم فتلاه على الصحابة؛ فسمعه من سمعه ونقل السبب والمسبب، ثم حصل قصة ثانية فتلا النبي-عليه الصلاة والسلام-الآية فسمعها من لم يسمع من قبل؛ فقال أنزل الله-جل وعلا-{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ }[4] فيظن السامع الثاني أنها نزلت لأول مرة. هذا توجيه من بعض العلماء.
- وبعضهم: يحكم بالترجيح؛ فيقول: الراجح هو المحفوظ وما عداه شاذ.
وإذا أمكن صيانة الرواة بقدر الإمكان، فلا يعدل إلى الترجيح.
ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ
وإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِعْ
تجدون في كتب التفسير: قال ابن عباس: نزلت الآية في كذا. بغير سند؛ هذا منقطع، والمنقطع ضعيف لابد من البحث عن إسناده والنظر في الإسناد من حيث الاتصال، وثقة الرواة، وهل يثبت أو لا يثبت؟
ويوجد في كتب أسباب النزول قدر كبير من الأخبار الضعيفة.
وهذا يسأل عن كتاب:( الصحيح المسند من أسباب النزول ) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟
هذا من خير ما يقتنيه طالب العلم، ويستفيد منه.
(وإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِعْ): الآن ما يروى عن الصحابي من غير سند منقطع.
(أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ): الآن ما يروى عن الصحابي من غير سند منقطع، أي ما يروى عن التابعي فمرسل. ما له حكم الرفع؛ إن اتصل السند بالصحابي، برواة ثقات فالخبر صحيح. وإن روي عن الصحابي وله حكم الرفع فهو مرفوع لكنه ضعيف منقطع.
ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع، مما لا يدرك بالرأي هذا مرفوع؛ فإن اتصل السند إليه فمرسل؛ لأنه لابد من ذكر واسطة بينه وبين النبي-عليه الصلاة والسلام-. التابعي لا يمكن أن يقول شيء مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف بالفرية. لكن المسألة مفترضة بالتابعين الثقات الذين يضاف إليهم مما له حكم الرفع هذا مرسل لابد أن يكون بينه وبين النبي-عليه الصلاة والسلام- واسطة وهو الصحابي.
فما يرفعه التابعي مرسل؛ ولذا قال: (أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ )]. فإن انضم إلى الإرسال حذف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع كما يقال، كما قيل في سابقه وهو مرسل لعدم ذكر الصحابي. وكلاهما ضعيف.
أو صح في أشياء:
أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ ، وصَحَّتِ
أَشْيَا كَما لإِفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةِ
سبب نزول قصة الإفك في القرآن في عشر آيات من سورة النور. ثبتت القصة في الصحيحين بطولها، وهي سبب نزول الآيات في سورة النور التي جاءت لبراءة عائشة-رضي الله عنها-.
(والسَّعْيِ والحِجَابِ مِنْ آياتِ): السعي بين الصفا والمروة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[5] هذه الآية جاءت على سبب، ولولا السبب الذي أجابت به عائشة-رضي الله تعالى عنها-عروة لقلنا أن الآية لا تدل على الوجوب. لكن لما عرفنا السبب بطل العجب. عروة استشكل وجوب السعي من مجرد رفع الجناح. {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا }، هل يكفي في إثبات الوجوب رفع الجناح؟
يعني رفع الجناح غاية ما يدل عليه الإباحة؛ لكن سبب النزول: وهو أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين، ويطوفون بين الصفا والمروة من أجلهما، فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام وكفروا بما عداه من الأصنام، وفرض الحج كان من واجباته وواجبات العمرة بل من أركانه: السعي بين الصفا والمروة. فاستصعبوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فكرهوا الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت الآية لبيان أن هذا الأمر لا جناح فيه ولا حرج فيه ولا شيئاً مما تأثمتم به. استصعبوا أنهم كانوا في هذا المكان يسعون من أجل هذين الصنمين.
ذكرنا مثال: لو أن إنساناً احتاج إلى كراتين لنقل مكتبته من مكانٍ إلى مكان، فما وجد إلا كراتين دخان. فقال: هذه كتب علم قال الله ، وقال رسوله، وهذه الكراتين كانت ظروف لمحرم فكيف أحمل الكتب من خلال هذه الكراتين التي استعملت في معصية. يقال له: لا حرج عليك ولا جناح؛ لأن هذه الكراتين طاهرة ونظيفة، ومناسبة للكتب، وقوية ومتينة. تحرج باعتبار ما كان. وأما الحكم الشرعي: كراتين طاهرة، واليابس لا ينجس اليابس، على القول: بأن المسكر والمفتر فيه ما فيه. ولا شك أن النفس تجد، أو الأنسان يجد في نفسه شيء من القلق في مثل هذه الأمور. يعني لو عندك أو معك مصحف وتقرأ وأردت أن تسجد فتقول: بدل من أن أضعه على الأرض-ويجوز وضعه على الأرض- بخلاف إلقائه. لكن ما معك إلا كرتون-مثلاً- أكرمكم الله حفائظ لكنه جديد، جيء به من المصنع. نعم.. يتحرج الإنسان أن يضع هذا المصحف الجليل الشريف على هذا الكرتون، وهو نظيف ما فيه أدنى إشكال، لكن الإنسان يجد في نفسه حرج من بعض الأمور، فهم وجدوا في أنفسهم مثل هذا الأمر. وإلا جاء الأمر به: ( إن الله كتب عليكم السعي ) وسعى النبي-عليه الصلاة والسلام-فما للحرج من موقع في مثل هذه الأمور. لكن النفس جبلت على هذا فنزل قول الله-جل وعلا-:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا }ولو لم نعرف السبب لوقعنا في إشكال في دلالة الآية كما وقع عروة.
(والسَّعْيِ والحِجَابِ مِنْ آياتِ): عمر-رضي الله تعالى عنه-كان يغار على زوجات النبي-عليه الصلاة والسلام-ولا يوجد مخلوق أغير من النبي-عليه الصلاة والسلام-فغيرة عمر-رضي الله عنه-زائدة؛ لأن هناك من الصفات، وإن شئت فقل جميع الصفات المحمودة لابد من التوسط فيها، فصنيعه عليه الصلاة والسلام هو الوسط.
عمر-رضي الله عنه-قال:( إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن ) فنزل قول الله-جل وعلا-: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ }[6] ولذا يقول عمر-رضي الله تعالى عنه-:( وافقت ربي في ثلاث ) وذكر منها الحجاب، وذكر منها الصلاة خلف المقام، وذكر منها: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ }[7] ثلاث. وموافقات عمر الملهم تزيد على ذلك بكثير وجمع السيوطي منها ما يقرب من عشرين في رسالة.
(والحجابِ من آياتِ):سببها قول عمر_ رضي الله تعالى عنه _.
..........................
خَلْفَ المَقَامِ الأَمْرُ بالصَّلاةِ
"لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصلى": يقول عمر_ رضي الله تعالى عنه_ فنزل قوله_جلّ وعلا_{اتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى}[8] فهذه من موافقاتهِ_ رضي الله تعالى عنه_ ونزلت آيات على هذه الأسباب، كلّ.....
هل يُعبر بعضُ الصحابة بالنزول وهم يقصدون تفسيرهم للآية، أو ذكر حُكمِها؟ مثل قول ابن عمر في قوله تعالى:{نساؤكم حرثٌ لكم}[9] أنّها نزلت في إتيان المرأة في دُبُرِها، فهل يَعُدون مثل هذا سبب نزول؟ وماهي العبارات الصحيحة في ذلك؟
غالبًا ما يأتي النازل بعد ذكر القصة، تُذكر القصة ثمّ يُقال:"فأنزل الله تعالى" يُرتب عليها يُفرع على القصة النزول، وقد يقال:" أنزل الله تعالى في كذا" يعني: في حكم كذا، في حُكم كذا وإن لم يكن سببًا.
[1] سورة (الأنعام:82)
[2] سورة (البقرة:115)
[3] سورة (عبس:31)
[4] سورة (النور:6)
[5] سورة (البقرة:158)
[6]سورة ( الأحزاب:53)
[7]سورة ( التحريم5:)
[8] سورة (البقرة:125)
[9] سورة (البقرة:223)
تم التعديل بواسطة زمزم

هيئة الإشراف
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
النوع العاشر: أسباب النزول
ذكر في الإتقان فوائد لهذا النوع، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، ومنها الوقف على المعنى وإزالة الإشكال، قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، قال الناظم (وصنف الأئمة) جمع إمام (الأسفارا) جمع سفر وهو الكتاب (فيه) أي في سبب النزول، أشهرها للواحدي (فيمم) بصيغة الأمر: اقصد (نحوها) أي جهة الأسفار (استفساراً) أي حال كونك مستفسراً، (ما) أي وسبب النزول الذي (فيه يروى عن صحابي) بسند متصل فحكمه (رفع) أي حكمه حكم الحديث المرفوع، لا الموقوف، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه مرفوع (و) السبب الذي روي عنهم (إن) روي (بغير سند) أي متصل (فـ) حكمه (منقطع) لا يلتفت إليه (أو تابعي) بتسكين ياء النسبة للوزن، وهو معطوف على صحابي، أي والسبب الذي روي بسند متصل عن تابعي (فـ) حكمه أنه (مرسل) لأنه ما سقط فيه الصحابي، فإن كان بلا سند فمردود، قال في شرح النقاية: كذا قال البلقيني فتبعناه، ولا أدري لم فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع، وفي الثاني رد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد؟ (وصحت) بكسر التاء للروي (أشيا) بالقصر للوزن، وذلك (كما) ثبت (لإفكهم) أي المنافقين (من قصة) بيان لما، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (والسعي): بالجر عطفاً على إفكهم، أي وكما ثبت للسعي من القصة والسبب، ففي الصحيحين عن عائشة: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله ...} إلى قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} وفي البخاري عن عاصم بن سليمان، قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة؟ قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (والحجاب) بالجر أيضاً لما مر، أي كما ثبت لآيات الحجاب من السبب كما قال الناظم (من آيات) وهو بيان للحجاب (خلف المقام) متعلق بالصلاة (الأمر) بالجر أيضاً لما مر (بالصلاة) متعلق بالأمر، أي وكما ثبت للأمر بالصلاة خلف المقام من السبب، وذلك كما في البخاري عن أنس قال، قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت كذلك، اهـ. والله أعلم.