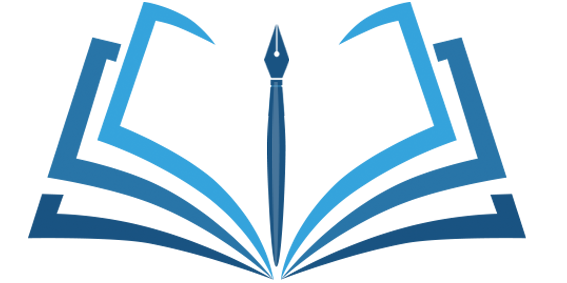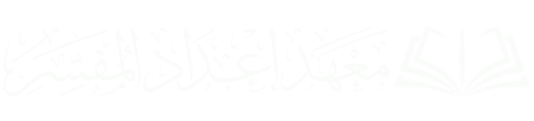تفسير سورة البقرة
القسم الرابع
تفسير سورة البقرة [من الآية (40) إلى الآية (43) ]

تفسير سورة البقرة
القسم الرابع
تفسير سورة البقرة [من الآية (40) إلى الآية (43) ]
18 Aug 2014
تفسير قوله تعالى: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) }
تفسير قوله تعالى: ({يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي فارهبون (40)} تفسير
قوله تعالى: {وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41)} تفسير قوله تعالى:{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)} تفسير قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)}
نصب {بني إسرائيل}
لأنه نداء مضاف، وأصل النداء النصب لأن معناه معنى "ناديت" و "دعوت".
و"إسرائيل" في موضع خفض إلا إنّه فتح آخره لأنه لا ينصرف، وفيه شيئان
يوجبان منع الصرف، وهما أنّه أعجمي وهو معرفة، وإذا كان الاسم كذلك لم
ينصرف، إذا جاوز ثلاثة أحرف عند النحويين، وفي قوله: {نعمتي الّتي أنعمت عليكم}
وجهان، أجودهما فتح الياء؛ لأنّ الذي بعدها ساكن -وهو لام المعرفة-
فاستعمالها كثير في الكلام فاختير فتح الياء معها لالتقاء السّاكنين، ولأن
الياء لو لم يكن بعدها ساكن كان فتحها أقوى في اللغة، ويجوز أن تحذف الياء
في اللفظ لالتقاء السّاكنين فتقرأ: (نعمت التي) أنعمت بحذف الياء،
والاختيار: إثبات الياء وفتحها؛ لأنه أقوى في العربية وأجزل في اللفظ وأتم
للثواب؛ لأن القارئ يجازى على كل ما يقرؤه من كتاب اللّه بكل حرف حسنة، فإن
إثباته أوجه في اللغة، فينبغي إثباته لما وصفنا.
فأما قوله عزّ وجلّ: {هارون أخي (30) اشدد به أزري (31)}؛ فلم يكثر القراء فتح هذه الياء، وقال أكثرهم بفتحها مع الألف واللام.
ولعمري إن اللام
المعرفة أكثر في الاستعمال، ولكني أقول: الاختيار "أخيَ اشدد" بفتح الياء
لالتقاء السّاكنين، كما فتحوا مع اللام، لأن اجتماع ساكنين مع اللام وغيرها
معنى واحد، وإن حذفت فالحذف جائز حسن، إلا أن الأحسن ما وصفنا.
وأمّا معنى الآية في التذكير بالنعمة، فإنهم ذكروا بما أنعم به على آبائهم من قبلهم، وأنعم به عليهم، والدليل على ذلك قوله: {إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً}
فالذين صادفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أنبياء، وإنّما ذكّروا
بما أنعم به على آبائهم وعليهم في أنفسهم وفي آبائهم، وهذا المعنى موجود في
كلام العرب معلوم عندها، يفاخر الرجل الرجل فيقول: "هزمناكم يوم ذي قار"،
ويقول: "قتلناكم يوم كذا"، معناه: قتل آباؤنا آباءكم.
وقوله عزّ وجلّ: {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} معناه -واللّه أعلم- قوله: {وإذ أخذ اللّه ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للنّاس ولا تكتمونه} فتمام تبيينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنّا ما يدل على ذكر العهد قبل هذا، وفيه كفاية.
وقوله عزّ وجلّ: {وإيّاي فارهبون}
نصب بالأمر كأنه في المعنى "أرهبوني" ويكون الثاني تفسير هذا الفعل
المضمر، ولو كان في غير القرآن لجاز: "وأنا فارهبون"، ولكن الاختيار في
الكلام والقرآن والشعر (وإيّاي فارهبون) حذفت الياء وأصله "فارهبوني"؛
لأنها فاصلة، ومعنى فاصلة رأس آية؛ ليكون النظم على لفظ متسق، ويسمّي أهل
اللغة رؤوس الآي: الفواصل، وأواخر الأبيات: القوافي.
ويقال: "وفيت له بالعهد فأنا واف به"، و"أوفيت له بالعهد فأنا موف به". والاختيار: أوفيت، وعليه نزل القرآن كله قال الله عزّ وجلّ: {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} وقال: {وأوفوا بعهد اللّه إذا عاهدتم} وقال: {فأوفوا الكيل والميزان}، وكل ما في القرآن بالألف، وقال الشاعر في "أوفيت" و"وفيت"، فجمع بين اللغتين في بيت واحد:
أما ابن عوف فقد أوفى بذمته ........ كما وفى بقلاص النجم حاديها
). [معاني القرآن: 1/ 119-122]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل:
{يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم
وإيّاي فارهبون (40) وآمنوا بما أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل
كافرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيّاي فاتّقون (41)}
- (يا) حرف نداء مضمن معنى التنبيه.
قال الخليل: «والعامل في المنادى فعل مضمر كأنه يقول: أريد أو أدعو».
وقال أبو علي
الفارسي: العامل حرف النداء عصب به معنى الفعل المضمر فقوي فعمل، ويدل على
ذلك أنه ليس في حروف المعاني ما يلتئم بانفراده مع الأسماء غير حرف النداء،
- و(بني) منادى
مضاف و(إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وهو اسم أعجمي
يقال فيه إسراءل وإسرائيل وإسرائيل، وتميم تقول إسرائين،
وإسرا هو بالعبرانية عبد، وإيل اسم الله تعالى، فمعناه عبد الله.
وحكى المهدوي أن (إسرا) مأخوذ من الشدة في الأسر كأنه الذي شد الله أسره وقوى خلقته.
وروي عن نافع والحسن والزهري وابن أبي إسحاق ترك همز إسراييل،
- والذكر في كلام العرب على أنحاء، وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضد النسيان،
- والنعمة هنا اسم
الجنس فهي مفردة بمعنى الجمع، وتحركت الياء من (نعمتي) لأنها لقيت الألف
واللام، ويجوز تسكينها، وإذا سكنت حذفت للالتقاء وفتحها أحسن لزيادة حرف في
كتاب الله تعالى،
وخصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية.
فقال الطبري: «بعثة الرسل منهم وإنزال المن والسلوى، وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون، وتفجير الحجر».
وقال غيره: «النعمة هنا أن دركهم مدة محمد صلى الله عليه وسلم».
وقال آخرون: «هي أن منحهم علم التوراة وجعلهم أهله وحملته».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه أقوال على جهة المثال، والعموم في اللفظة هو الحسن.
وحكى مكي: أن المخاطب من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا نعمة لله عليه.
وقال ابن عباس وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي عليه السلام، مؤمنهم وكافرهم،
- والضمير في
(عليكم) يراد به على آبائكم كما تقول العرب ألم نهزمكم يوم كذا لوقعة كانت
بين الآباء والأجداد، ومن قال إنما خوطب المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم
استقام الضمير في (عليكم) ويجيء كل ما توالى من الأوامر على جهة
الاستدامة.
- وقوله تعالى: {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} أمر وجوابه.
فقال الخليل: «جزم الجواب في الأمر من معنى الشرط، والوفاء بالعهد هو التزام ما تضمن من فعل».
وقرأ الزهري: «أوفّ» بفتح الواو وشد الفاء للتكثير.
واختلف المتأولون
في هذا العهد إليهم؛ فقال الجمهور ذلك عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه
فيدخل في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وقيل العهد قوله
تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوّةٍ}[البقرة: 63، 93]، وقال ابن جريج: العهد قوله تعالى: {ولقد أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل} [المائدة: 12]، وعهدهم هو أن يدخلهم الجنة، ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم بعهدهم، لا علة له، لأن العلة لا تتقدم المعلول.
- وقوله تعالى: {وإيّاي فارهبون} الاسم ايا والياء
ضمير ككاف المخاطب، وقيل: إيّاي بجملته هو الاسم، وهو منصوب بإضمار فعل
مؤخر، تقديره: وإياي ارهبوا فارهبون، وامتنع أن يتقدر مقدما لأن الفعل إذا
تقدم لم يحسن أن يتصل به إلا ضمير خفيف، فكان يجيء وارهبون، والرهبة يتضمن
الأمر بها معنى التهديد وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية.
وقرأ ابن أبي إسحاق بالياء). [المحرر الوجيز: 1/ 193-195]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({يا
بني إسرائيل اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم
وإيّاي فارهبون (40) وآمنوا بما أنزلت مصدّقًا لما معكم ولا تكونوا أوّل
كافرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا وإيّاي فاتّقون (41) }
يقول تعالى آمرًا
بني إسرائيل بالدّخول في الإسلام، ومتابعة محمّدٍ عليه من اللّه أفضل
الصّلاة والسّلام، ومهيجًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل، وهو نبيّ اللّه يعقوب،
عليه السّلام، وتقديره: يا بني العبد الصّالح المطيع للّه كونوا مثل أبيكم
في متابعة الحقّ، كما تقول: يا ابن الكريم، افعل كذا. يا ابن الشّجاع، بارز
الأبطال، يا ابن العالم، اطلب العلم ونحو ذلك.
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: {ذرّيّة من حملنا مع نوحٍ إنّه كان عبدًا شكورًا}[الإسراء: 3]
فإسرائيل هو يعقوب عليه السّلام، بدليل ما رواه أبو داود الطّيالسيّ:
حدّثنا عبد الحميد بن بهرامٍ، عن شهر بن حوشب، قال: حدّثني عبد اللّه بن
عبّاسٍ قال: حضرت عصابةٌ من اليهود نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال
لهم:
«هل تعلمون أنّ إسرائيل يعقوب؟». قالوا: اللّهمّ نعم. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «اللّهمّ اشهد».
وقال الأعمش، عن إسماعيل بن رجاءٍ، عن عميرٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن عبد اللّه بن عبّاسٍ؛
«أنّ إسرائيل كقولك: عبد اللّه».
وقوله تعالى: {اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم} قال مجاهدٌ:
«نعمة اللّه
الّتي أنعم بها عليهم فيما سمّى وفيما سوى ذلك، فجّر لهم الحجر، وأنزل
عليهم المنّ والسّلوى، وأنجاهم من عبودية آل فرعون».
وقال أبو العالية:
«نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرّسل، وأنزل عليهم الكتب».
قلت: وهذا كقول موسى عليه السّلام لهم: {يا قوم اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين}[المائدة: 20] يعني في زمانهم.
وقال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّدٍ، عن عكرمة أو سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم}:
«أي: بلائي عندكم وعند آبائكم، لما كان نجّاهم به من فرعون وقومه»،{وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} قال:«بعهدي الّذي أخذت في أعناقكم للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذا جاءكم.{أوف بعهدكم}
أي: أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتّباعه، بوضع ما كان عليكم من
الإصر والأغلال الّتي كانت في أعناقكم بذنوبكم الّتي كانت من إحداثكم».
[وقال الحسن البصريّ:
«هو قوله: {ولقد
أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا وقال اللّه إنّي
معكم لئن أقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكاة وآمنتم برسلي وعزّرتموهم وأقرضتم
اللّه قرضًا حسنًا لأكفّرنّ عنكم سيّئاتكم ولأدخلنّكم جنّاتٍ تجري من تحتها
الأنهار}الآية [المائدة: 12]».
وقال آخرون: هو
الّذي أخذه اللّه عليهم في التّوراة أنّه سيبعث من بني إسماعيل نبيًّا
عظيمًا يطيعه جميع الشّعوب، والمراد به محمّدٌ صلّى اللّه عليه وسلّم، فمن
اتّبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنّة وجعل له أجران.
وقد أورد فخر الدّين الرّازيّ هاهنا بشاراتٍ كثيرةٍ عن الأنبياء عليهم السّلام بمحمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم].
وقال أبو العالية: {وأوفوا بعهدي} قال:
«عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتّبعوه».
وقال الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ: {أوف بعهدكم} قال:
«أرض عنكم وأدخلكم الجنّة».
وكذا قال السّدّيّ، والضّحّاك، وأبو العالية، والرّبيع بن أنسٍ.
وقوله: {وإيّاي فارهبون} أي: فاخشون؛ قاله أبو العالية، والسّدّيّ، والرّبيع بن أنسٍ، وقتادة.
وقال ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {وإيّاي فارهبون}:
«أي: أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النّقمات الّتي قد عرفتم من المسخ وغيره».
وهذا انتقالٌ من
التّرغيب إلى التّرهيب، فدعاهم إليه بالرّغبة والرّهبة، لعلّهم يرجعون إلى
الحقّ واتّباع الرّسول والاتّعاظ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق
أخباره، واللّه الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: {وآمنوا بما أنزلت مصدّقًا لما معكم}).[تفسير ابن كثير: 1/ 241-242]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {وآمنوا بما أنزلت مصدّقا لما معكم ولا تكونوا أوّل كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيّاي فاتّقون (41)}
يعني: القرآن، ويكون أيضاً {ولا تكونوا أوّل كافر}: بكتابكم وبالقرآن، إن شئت عادت الهاء على قوله: {لما معكم}، وإنما قيل لهم: {ولا تكونوا أوّل كافر}، لأن الخطاب وقع على حكمائهم فإذا كفروا كفر معهم الأتباع، فلذلك قيل لهم: {ولا تكونوا أوّل كافر}.
فإن قال قائل: كيف تكون الهاء لكتابهم؟
قيل له: إنهم إذا كتموا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتابهم، فقد كفروا به، كما إنّه من كتم آية من القرآن فقد كفر به.
ومعنى {ولا تكونوا أوّل كافر به} -إذا كان بالقرآن-: لا مؤنة فيه؛ لأنهم يظهرون أنهم كافرون بالقرآن، ومعنى {أوّل كافر}: أول الكافرين.
قال بعض البصريين في هذا قولين:
قال الأخفش:
معناه: أول من كفر به، وقال البصريون أيضا: معناه: ولا تكونوا أول فريق
كافر به، أي: بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين صواب حسن.
وقال بعض
النحويين: إن هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول، تقول: الجيش منهزم، والجيش
مهزوم، ولا يجوز فيما ذكر: الجيش رجل، والجيش فرس، وهذا في فاعل ومفعول
أبين، لأنك إذا قلت: الجيش منهزم، فقد علم أنك تريد هذا الجيش، فنقطت في
لفظه بفاعل؛ لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على جمع، فهو "فعال"
و"مفعول" يدل على ما يدل عليه الجيش، وإذا قلت: الجيش رجل، فإنما يكره في
هذا أن يتوهم أنك تقلله، فأمّا إذا عرف معناه، فهو سائغ جيد.
تقول: جيشهم إنّما
هو فرس ورجل، أي: ليس بكثير الأتباع، فيدل المعنى على أنك تريد: الجيش خيل
ورجال، وهذا في "فاعل" و"مفعول" أبين كما وصفنا.
وقوله عزّ وجلّ {أوّل كافر به}
اللغة العليا والقدمى: الفتح في الكاف، وهي لغة أهل الحجاز، والإمالة في
الكاف أيضاً جيّد بالغ في اللغة؛ لأن فاعلا ً إذا سلم من حروف الإطباق
وحروف المستعلية: كانت الإمالة فيه سائغة إلا في لغة أهل الحجاز، والإمالة
لغة بني تميم، وغيرهم من العرب، ولسان الناس الذين هم بالعراق جار على لفظ
الإمالة، فالعرب تقول: هذا عابد وهو عابد، فيكسرون ما بعدها إلا أن تدخل
حروف الإطباق، وهي: الطاء والظاء والصاد والضاد، لا يجوز في قولك: فلان
ظالم، "ظالم" ممال، ولا في: طالب، "طالب" ممال، ولا في: صابر، "صابر" ممال،
ولا في: ضابط، "ضابط" ممال، وكذلك حروف الاستعلاء وهي: الخاء والغين
والقاف، لا يجوز في: غافل، "غافل" ممال، ولا في: خادم، "خادم" ممال، ولا
في: قاهر، "قاهر" ممال، وباب الإمالة يطول شرحه إلا أن هذا -في هذا الموضع-
هو المقصود وقدر الحاجة). [معاني القرآن: 1/ 122-124]
و{ما أنزلت} كناية عن القرآن، و{لما معكم} يعني من التوراة.
وقوله تعالى: {ولا تكونوا أوّل كافرٍ به}
هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه والمسكوت عنه حكمهما واحد، فالأول
والثاني وغيرهما داخل في النهي، ولكن حذروا البدار إلى الكفر به إذ على
الأول كفل من فعل المقتدى به، ونصب (أول) على خبر كان.
قال سيبويه: «أوّل أفعل لا فعل له لاعتلال فائه وعينه»، قال غير سيبويه: «هو أوأل من وأل إذا نجا، خففت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت».
وقيل: إنه من آل فهو أأول قلب فجاء وزنه أعفل، وسهل وأبدل وأدغم،
ووحد كافر وهو بنية الجمع لأن أفعل إذا أضيف إلى اسم متصرف من فعل جاز إفراد ذلك الاسم، والمراد به الجماعة.
قال الشاعر:
وإذا هم طعموا فألأم طاعم ....... وإذا هم جاعوا فشرّ جياع
وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من معرفة، كأنه قال: ولا تكونوا أول كافرين به، وقيل معناه: ولا تكونوا أول فريق كافر به.
قال القاضي أبو
محمد رحمه الله: وقد كان كفر قبلهم كفار قريش، فإنما معناه من أهل الكتاب،
إذ هم منظور إليهم في مثل هذا، لأنهم حجة مظنون بهم علم،
واختلف في الضمير في (به) على من يعود، فقيل: على محمد عليه السلام، وقيل: على التوراة إذ تضمنها قوله: {لما معكم}.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وعلى هذا القول يجيء (أوّل كافرٍ به) مستقيما على ظاهره في الأولية،
وقيل: الضمير في (به) عائد على القرآن، إذ تضمنه قوله: {بما أنزلت}.
واختلف المتأولون
في الثمن الذي نهوا أن يشتروه بالآيات، فقالت طائفة: إن الأحبار كانوا
يعلمون دينهم بالأجرة، فنهوا عن ذلك وفي كتبهم: علم مجانا كما علمت مجانا،
أي: باطلا بغير أجرة.
وقال قوم: كانت للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك.
وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رشى على تغيير قصة محمد عليه السلام في التوراة، ففي ذلك قال تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلًا}[البقرة: 41، المائدة: 44].
وقال قوم: معنى الآية: ولا تشتروا بأوامري ونواهيّ وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نزر لا خطر له،
وقد تقدم نظير قوله: {وإيّاي فاتّقون}، وبين «اتقون» و«ارهبون» فرق، أن الرهبة مقرون بها وعيد بالغ).[المحرر الوجيز: 1/ 195-197]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ([{مصدّقًا} ماضيًا منصوبًا على الحال من {بما} أي: بالّذي أنزلت مصدّقًا أو من الضّمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته مصدّقًا، ويجوز أن يكون مصدرًا من غير الفعل وهو قوله: {بما أنزلت مصدقًا}]
يعني به: القرآن الّذي أنزله على محمّدٍ النّبيّ الأمّيّ العربيّ بشيرًا
ونذيرًا وسراجًا منيرًا مشتملًا على الحقّ من الله تعالى، مصدّقًا لما بين
يديه من التّوراة والإنجيل.
قال أبو العالية، رحمه اللّه، في قوله: {وآمنوا بما أنزلت مصدّقًا لما معكم}:
«يقول: يا معشر
أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدّقًا لما معكم، يقول: لأنّهم يجدون محمّدًا
صلّى اللّه عليه وسلّم مكتوبًا عندهم في التّوراة والإنجيل».
وروي عن مجاهدٍ والرّبيع بن أنسٍ وقتادة نحو ذلك.
وقوله: {ولا تكونوا أوّل كافرٍ به} [قال بعض المفسّرين: أوّل فريقٍ كافرٍ به ونحو ذلك].
قال ابن عبّاسٍ:
«{ولا تكونوا أوّل كافرٍ به} وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم».
وقال أبو العالية:
«يقول:{ولا تكونوا أوّل [كافرٍ به}أوّل] من كفر بمحمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم [يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمّدٍ وبمبعثه»].
وكذا قال الحسن، والسّدّيّ، والرّبيع بن أنسٍ.
واختار ابن جريرٍ أنّ الضّمير في قوله: {به} عائدٌ على القرآن، الّذي تقدّم ذكره في قوله: {بما أنزلت}.
وكلا القولين
صحيحٌ؛ لأنّهما متلازمان، لأنّ من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمّدٍ صلّى اللّه
عليه وسلّم، ومن كفر بمحمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم فقد كفر بالقرآن.
وأمّا قوله: {أوّل كافرٍ به}
فيعني به أوّل من كفر به من بني إسرائيل؛ لأنّه قد تقدّمهم من كفّار قريشٍ
وغيرهم من العرب بشر كثيرٌ، وإنّما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل
مباشرةً، فإنّ يهود المدينة أوّل بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به
يستلزم أنّهم أوّل من كفر به من جنسهم.
وقوله: {ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا}
يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدّنيا وشهواتها،
فإنّها قليلةٌ فانيةٌ، كما قال عبد اللّه بن المبارك: أنبأنا عبد الرّحمن
بن يزيد بن جابرٍ، عن هارون بن زيدٍ قال: سئل الحسن، يعني البصريّ، عن قوله
تعالى: {ثمنًا قليلا} قال:
«الثّمن القليل: الدّنيا بحذافيرها».
وقال ابن لهيعة: حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: {ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا}:
«وإنّ آياته: كتابه الّذي أنزله إليهم، وإنّ الثّمن القليل: الدّنيا وشهواتها».
وقال السّدّيّ:
«{ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا} يقول: لا تأخذوا طمعًا قليلًا، ولا تكتموا اسم اللّه لذلك الطّمع وهو الثّمن».
وقال أبو جعفرٍ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية في قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا}:
«يقول: لا تأخذوا عليه أجرًا». قال: «وهو مكتوبٌ عندهم في الكتاب الأوّل: يا ابن آدم علّم مجّانا كما علّمت مجّانا».
وقيل: معناه لا
تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النّافع في النّاس بالكتمان واللّبس
لتستمرّوا على رياستكم في الدّنيا القليلة الحقيرة الزّائلة عن قريبٍ، وفي
سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
«من تعلّم علمًا ممّا يبتغى به وجه اللّه لا يتعلّمه إلّا ليصيب به عرضًا من الدّنيا لم يرح رائحة الجنّة يوم القيامة».
وأمّا تعليم العلم
بأجرةٍ، فإن كان قد تعيّن عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرةً، ويجوز أن
يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيءٌ
وقطعه التّعليم عن التّكسّب، فهو كما لم يتعيّن عليه،
وإذا لم يتعيّن
عليه، فإنّه يجوز أن يأخذ عليه أجرةً عند مالكٍ والشّافعيّ وأحمد وجمهور
العلماء، كما في صحيح البخاريّ عن أبي سعيدٍ في قصّة اللّديغ:
«إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللّه»، وقوله في قصّة المخطوبة: «زوّجتكها بما معك من القرآن»،
فأمّا حديث عبادة
بن الصّامت، أنّه علّم رجلًا من أهل الصّفّة شيئًا من القرآن فأهدى له
قوسًا، فسأل عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال:
«إن أحببت أن تطوّق بقوسٍ من نارٍ فاقبله»
فتركه، رواه أبو داود وروي مثله عن أبيّ بن كعبٍ مرفوعًا فإن صحّ إسناده
فهو محمولٌ عند كثيرٍ من العلماء -منهم أبو عمر بن عبد البرّ- على أنّه
لمّا علّمه اللّه لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب اللّه بذلك القوس، فأمّا
إذا كان من أوّل الأمر على التّعليم بالأجرة فإنّه يصحّ كما في حديث
اللّديغ وحديث سهلٍ في المخطوبة، واللّه أعلم.
{وإيّاي فاتّقون} قال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أبو عمر الدّوريّ، حدّثنا أبو إسماعيل المؤدّب، عن عاصمٍ الأحول، عن أبي العالية، عن طلق بن حبيبٍ، قال:
«التّقوى أن تعمل
بطاعة اللّه رجاء رحمة اللّه على نورٍ من اللّه، والتّقوى أن تترك معصية
اللّه مخافة عذاب اللّه على نورٍ من اللّه».
ومعنى قوله: {وإيّاي فاتّقون} أنّه تعالى يتوعّدهم فيما يتعمّدونه من كتمان الحقّ وإظهار خلافه ومخالفتهم الرّسول، صلوات الله وسلامه عليه).[تفسير ابن كثير: 1/ 242-244]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (قوله عزّ وجلّ: {ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون (42)}
يقال: لبست عليهم الأمر أَلبِسُه، إذا أعمّيته عليهم، ولبست الثوب ألبسه، ومعنى الآية: {لا تلبسوا الحق} و"الحق" ههنا: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وما أتى به من كتاب الله -عزّ وجلّ-، وقوله {بالباطل} أي: بما يحرفون.
وقوله عزّ وجلّ: {وأنتم تعلمون} أي: تأتون لبسكم الحق وكتمانه على علم منكم وبصيرة.
وإعراب {ولا تلبسوا} الجزم بالنهي، وعلامة الجزم سقوط النون، أصله: "تلبسون" و"تكتمون"، يصلح أن يكون جزماً على معنى {ولا تكتموا الحق}، ويصلح أن يكون نصباً، وعلامة النصب أيضاً سقوط النون، أما إذا نصبت فعلى معنى الجواب بالواو.
ومذهب الخليل
وسيبويه والأخفش وجماعة من البصريين: أن جميع ما انتصب في هذا الباب
فبإضمار "أن"، كأنك قلت: لا يكن منكم إلباس الحق وكتمانه، كأنّه قال: وإن
تكتموه، ودلّ "تلبسوا" على لبس، كما تقول: من كذب كان شرّا، ودل ما في صدر
كلامك على الكذب فحذفته). [معاني القرآن: 1/ 124-125]
المعنى ولا تخلطوا، يقال: «لبست الأمر» بفتح الباء ألبسه، إذا خلطته ومزجت بينه بمشكله وحقه بباطله.
وأما قول الشاعر:
وكتيبة لبّستها بكتيبة ....... ... ... ... ...
فالظاهر أنه من هذا المعنى، ويحتمل أن يكون من اللباس،
واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: {الحقّ بالباطل}.
فقال أبو العالية: «قالت اليهود: محمد نبي مبعوث، لكن إلى غيرنا، فإقرارهم ببعثه حق، وجحدهم أنه بعث إليهم باطل».
وقال الطبري: «كان من اليهود منافقون، فما أظهروا من الإيمان حق، وما أبطنوا من الكفر باطل».
وقال مجاهد: «معناه: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام».
وقال ابن زيد: «المراد بـ«الحقّ» التوراة، و«الباطل» ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام»،
و(تلبسوا) جزم
بالنهي، و(تكتموا) عطف عليه في موضع جزم، ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار
«أن»، وإذا قدرت «أن» كانت مع (تكتموا) بتأويل المصدر، وكانت الواو عاطفة
على مصدر مقدر من (تلبسوا)، كأن الكلام: ولا يكن لبسكم الحق بالباطل
وكتمانكم الحق.
وقال الكوفيون: (تكتموا) نصب بواو الصرف، والحقّ يعني به أمر محمد صلى الله عليه وسلم».
وقوله تعالى: {وأنتم تعلمون}
جملة في موضع الحال، ولم يشهد لهم تعالى بعلم وإنما نهاهم عن كتمان ما
علموا، ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد عليه السلام،
ولم يشهد لهم بالعلم على الإطلاق ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال،
وفي هذه الألفاظ دليل على تغليظ الذنب على من واقعه على علم، وأنه أعصى من
الجاهل). [المحرر الوجيز: 1/ 197-198]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون (42) وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة واركعوا مع الرّاكعين (43)}
يقول تعالى ناهيًا لليهود عمّا كانوا يتعمّدونه، من تلبيس الحقّ بالباطل، وتمويهه به وكتمانهم الحقّ وإظهارهم الباطل: {ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون} فنهاهم عن الشّيئين معًا، وأمرهم بإظهار الحقّ والتّصريح به؛ ولهذا قال الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ:
«{ولا تلبسوا الحقّ بالباطل}لا تخلطوا الحقّ بالباطل والصّدق بالكذب».
وقال أبو العالية:
«{ولا تلبسوا الحقّ بالباطل} يقول: ولا تخلطوا الحقّ بالباطل، وأدّوا النّصيحة لعباد اللّه من أمّة محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم».
ويروى عن سعيد بن جبيرٍ والرّبيع بن أنسٍ، نحوه.
وقال قتادة: {ولا تلبسوا الحقّ بالباطل} [قال:]
«ولا تلبسوا اليهوديّة والنّصرانيّة بالإسلام؛ إنّ دين اللّه الإسلام، واليهوديّة والنّصرانيّة بدعةٌ ليست من اللّه».
وروي عن الحسن البصريّ نحو ذلك.
وقال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّدٍ، عن عكرمة أو سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ:
«{وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون} أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم فيما تعلمون من الكتب الّتي بأيديكم». وروي عن أبي العالية نحو ذلك.
وقال مجاهدٌ، والسّدّيّ، وقتادة، والرّبيع بن أنسٍ:
«{وتكتموا الحقّ}يعني: محمّدًا صلّى اللّه عليه وسلّم».
[قلت:{وتكتموا}
يحتمل أن يكون مجزومًا، ويجوز أن يكون منصوبًا، أي: لا تجمعوا بين هذا
وهذا، كما يقال: لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن. قال الزّمخشريّ: وفي مصحف
ابن مسعودٍ: "وتكتمون الحقّ" أي: في حال كتمانكم الحقّ، "وأنتم تعلمون"
حالٌ أيضًا، ومعناه: وأنتم تعلمون الحقّ،
ويجوز أن يكون
المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضّرر العظيم على النّاس من إضلالهم عن
الهدى المفضي بهم إلى النّار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب
بنوعٍ من الحقّ لتروّجوه عليهم، والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحقّ
بالباطل]). [تفسير ابن كثير: 1/ 245]
وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا ....... حتى تقيم الخيل سوق طعان
وقد تقدم القول في
الصلاة، والزّكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب
الأمر بها، والزّكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد، وسمي الإخراج من
المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به
المزكي، وقيل: الزّكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال: زكا فلان أي: طهر من
دنس الجرحة أو الاغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل
الله فيه للمساكين، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الموطأ ما
يخرج في الزكاة «أوساخ الناس».
وقوله تعالى: {واركعوا مع الرّاكعين}
- قال قوم: جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة كلها.
- وقال قوم: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع.
- وقالت فرقة: إنما قال: (مع) لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله: (مع) بشهود الجماعة،
والركوع في اللغة: الانحناء بالشخص. قال لبيد:
أخبر أخبار القرون التي مضت ....... أدبّ كأني كلما قمت راكع
ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة، قال الأضبط بن قريع:
لا تعاد الضعيف علك أن ....... تركع يوما والدهر قد رفعه
).[المحرر الوجيز: 1/ 198-199]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة واركعوا مع الرّاكعين}.
قال مقاتلٌ:
«قوله تعالى لأهل الكتاب: {وأقيموا الصّلاة}أمرهم أن يصلّوا مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم{وآتوا الزّكاة} أمرهم أن يؤتوا الزّكاة، أي: يدفعونها إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم{واركعوا مع الرّاكعين} أمرهم أن يركعوا مع الرّاكعين من أمّة محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم. يقول: كونوا منهم ومعهم».
وقال عليّ بن طلحة، عن ابن عبّاسٍ: [{وآتوا الزّكاة}]:
«يعني بالزّكاة: طاعة اللّه والإخلاص».
وقال وكيع، عن أبي جناب، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {وآتوا الزّكاة} قال: ما يوجب الزّكاة؟ قال:
«مائتان فصاعدًا».
وقال مبارك بن فضالة، عن الحسن، في قوله تعالى: {وآتوا الزّكاة} قال:
«فريضةٌ واجبةٌ، لا تنفع الأعمال إلّا بها وبالصّلاة».
وقال ابن أبي
حاتمٍ: حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا جريرٌ عن أبي
حيّان [العجميّ] التّيميّ، عن الحارث العكلي في قوله: {وآتوا الزّكاة} قال:
«صدقة الفطر».
وقوله تعالى: {واركعوا مع الرّاكعين} أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخصّ ذلك وأكمله الصّلاة.
[وقد استدلّ كثيرٌ
من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير
إن شاء اللّه، وقد تكلّم القرطبيّ على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]). [تفسير ابن كثير: 1/ 245-246]
* للاستزادة ينظر: هنا