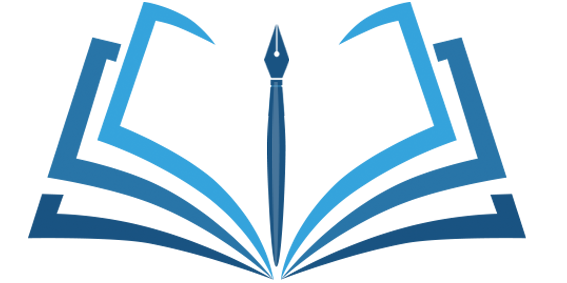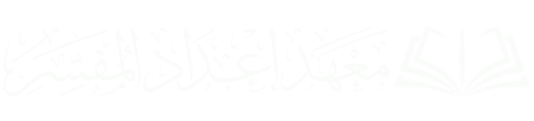تفسير سورة البقرة
القسم السابع
تفسير سورة البقرة [من الآية (97) إلى الآية (100) ]

تفسير سورة البقرة
القسم السابع
تفسير سورة البقرة [من الآية (97) إلى الآية (100) ]
1 Sep 2014
تفسير قوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100)}
تفسير
قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98)} تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99)} تفسير قوله تعالى: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100)}
تفسير قوله
تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (قوله عزّ وجلّ: {قل من كان عدوّا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن اللّه مصدّقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين (97)}
"جبريل" في
اسمه لغات قرئ ببعضها, ومنها ما لم يقرأ به، فأجود اللغات "جَبرئيل" بفتح
الجيم، والهمز، لأن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الصور: «جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره»،
هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث، ويقال: "جبريل" بفتح الجيم وكسرها, ويقال
أيضا "جبرألّ" بحذف الياء, وإثبات الهمزة, وتشديد اللام, ويقال: "جبرين"
بالنون، وهذا لا يجوز في القرآن، أعني: إثبات النون؛ لأنه خلاف المصحف, قال
الشاعر:
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة ....... الدهر إلا جبرئيل أمامها
وهذا البيت على لفظ ما في الحديث, وما عليه كثير من القراء.
وقد جاء في الشعر "جبريل", قال الشاعر:
وجبريل رسول الله فينا ....... وروح القدس ليس له كفاء
وإنما جرى ذكر هذا؛ لأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جبريل عدونا, فلو أتاك ميكائيل، لقبلنا منك، فقال اللّه عزّ وجلّ: {قل من كان عدوّا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن اللّه مصدّقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين (97)}
ونصب {مصدقًا}على الحال). [معاني القرآن: 1/ 180]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {قل من كان عدوًّا لجبريل} الآية، نزل على سبب لم يتقدم له ذكر فيما مضى من الآيات، ولكن أجمع أهل التفسير أن اليهود قالت: جبريل عدونا،واختلف في كيفية ذلك؛
- فقيل: إن يهود فدك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نسألك عن أربعة أشياء فإن عرفتها اتبعناك، فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، فقال: «لحوم الإبل وألبانها»، وسألوه عن الشبه في الولد، فقال: «أي ماء علا كان الشبه له»، وسألوه عن نومه، فقال:«تنام عيني ولا ينام قلبي»، وسألوه عمن يجيئه من الملائكة، فقال: «جبريل»، فلما ذكره قالوا: ذاك عدونا، لأنه ملك الحرب والشدائد والجدب، ولو كان الذي يجيئك ميكائيل ملك الرحمة والخصب والأمطار لاتبعناك،
- وقيل:
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتكرر على بيت المدارس، فاستحلفهم يوما
بالذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتعلمون أن محمدا نبي؟، قالوا:
نعم، قال: «فلم تهلكون في تكذيبه؟»، قالوا: صاحبه جبريل وهو عدونا،
وذكر أنهم قالوا سبب عداوتهم له أنه حمى بختنصر حين بعثوا إليه قبل أن يملك من يقتله، فنزلت هذه الآية لقولهم.
وفي جبريل لغات:
- «جبريل» بكسر الجيم والراء من غير همز، وبها قرأ نافع،
- و«جبريل» بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز، وبها قرأ ابن كثير، وروي عنه أنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ جبريل وميكال فلا أزال أقرؤهما أبدا كذلك»،
- وجبريل بفتح الجيم والراء وهمزة بين الراء واللام وبها قرأ عاصم،
- و«جبرءيل» بفتح الجيم والراء وهمزة بعد الراء وياء بين الهمزة واللام، وبها قرأ حمزة والكسائي وحكاها الكسائي عن عاصم،
- «وجبرائل» بألف بعد الراء ثم همزة وبها قرأ عكرمة،
- و«جبرائيل» بزيادة ياء بعد الهمزة، و«جبراييل» بياءين وبها قرأ الأعمش،
- و«جبرئل» بفتح الجيم والراء وهمزة ولام مشددة، وبها قرأ يحيى بن يعمر، و«جبرال» لغة فيه،
- و«جبرين» بكسر الجيم والراء وياء ونون، قال الطبري: «هي لغة بني أسد» ولم يقرأ بها،
و«جبريل» اسم
أعجمي عربته العرب فلها فيه هذه اللغات، فبعضها هي موجودة في أبنية العرب،
وتلك أدخل في التعريب كجبريل الذي هو كقنديل، وبعضها خارجة عن أبنية العرب
فذلك كمثل ما عربته العرب ولم تدخله في بناء كإبريسم وفرند وآجر ونحوه.
وذكر ابن عباس رضي
الله عنه وغيره أن «جبر» و«ميك» و«سراف» هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد
ومملوك، وإيل: اسم الله تعالى، ويقال فيه إلّ، ومنه قول أبي بكر الصديق رضي
الله عنه حين سمع سجع مسيلمة: «هذا كلام لم يخرج من إلّ».
وقوله تعالى: {فإنّه نزّله على قلبك} الضمير في {فإنّه} عائد على الله عز وجل، والضمير في {نزّله} عائد على جبريل صلى الله عليه وسلم، والمعنى: بالقرآن وسائر الوحي،
- وقيل: الضمير في {إنه} عائد على جبريل، وفي {نزّله} على القرآن،
وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف،
وجاءت المخاطبة بالكاف في {قلبك}
اتساعا في العبارة إذ ليس ثم من يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه
الكاف، وإنما يجيء قوله: فإنه نزله على قلبي، لكن حسن هذا إذ يحسن في كلام
العرب أن تحرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول ويحسن أن تقصد المعنى الذي
يقوله فتسرده مخاطبة له، كما تقول لرجل: قل لقومك لا يهينوك، فكذلك هي
الآية، ونحو من هذا قول الفرزدق:
ألم تر أنّي يوم جو سويقة ....... بكيت فنادتني هنيدة ما ليا
فأحرز المعنى ونكب عن نداء هنيدة «مالك»،
و{بإذن اللّه} معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة، و{مصدّقاً} حال من ضمير القرآن في {نزّله}، و«ما بين يديه»: ما تقدمه من كتب الله تعالى، هدىً إرشاد، والبشرى: أكثر استعمالها في الخير، ولا تجيء في الشر إلا مقيدة به،
ومقصد هذه الآية: تشريف جبريل صلى الله عليه وسلم وذم معاديه). [المحرر الوجيز: 1/ 291-294]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({قل
من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه مصدّقًا لما بين
يديه وهدًى وبشرى للمؤمنين (97) من كان عدوًّا للّه وملائكته ورسله وجبريل
وميكال فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين (98)}
قال الإمام أبو
جعفر بن جريرٍ الطّبريّ رحمه اللّه: أجمع أهل العلم بالتّأويل جميعًا [على]
أنّ هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أنّ جبريل
عدوٌّ لهم، وأن ميكائيل وليٌّ لهم، ثمّ اختلفوا في السّبب الذي من أجله
قالوا ذلك.
فقال بعضهم: إنّما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في أمر نبوّته. ذكر من قال ذلك:
حدّثنا أبو كريب،
حدّثنا يونس بن بكير، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن
عبّاسٍ أنّه قال: حضرت عصابةٌ من اليهود رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم،
فقالوا: يا أبا القاسم، حدّثنا عن خلالٍ نسألك عنهنّ، لا يعلمهنّ إلّا
نبيٌّ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «سلوا عمّا شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمّةً وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدّثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعنّي على الإسلام». فقالوا: ذلك لك. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:«سلوني عمّا شئتم».
فقالوا: أخبرنا عن
أربع خلالٍ نسألك عنهنّ: أخبرنا أيّ الطّعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل
أن تنزّل التّوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرّجل؟ وكيف يكون الذّكر
منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النّبيّ الأمّيّ في النّوم ووليّه من الملائكة؟
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عليكم عهد اللّه لئن أنا أنبأتكم لتتابعنّي؟» فأعطوه ما شاء اللّه من عهدٍ وميثاقٍ.
فقال: «نشدتكم
بالذي أنزل التّوراة على موسى، هل تعلمون أنّ إسرائيل يعقوب مرض مرضًا
شديدًا فطال سقمه منه، فنذر للّه نذرًا لئن عافاه اللّه من سقمه ليحرّمنّ
أحبّ الطّعام والشّراب إليه، وكان أحبّ الطّعام إليه لحوم الإبل وأحبّ
الشّراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللّهمّ نعم.
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «اللّهمّ
اشهد عليهم. وأنشدكم باللّه الذي لا إله إلّا هو، الذي أنزل التوراة على
موسى، هل تعلمون أنّ ماء الرّجل أبيض غليظٌ، وأنّ ماء المرأة أصفر رقيقٌ،
فأيّهما علا كان له الولد والشّبه بإذن اللّه، وإذا علا ماء الرّجل ماء
المرأة كان الولد ذكرًا بإذن اللّه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرّجل كان
الولد أنثى بإذن اللّه؟». قالوا: اللّهمّ نعم. قال: «اللّهمّ اشهد». قال: «وأنشدكم باللّه الذي أنزل التّوراة على موسى، هل تعلمون أنّ هذا النّبيّ الأمّيّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللّهمّ نعم. قال: «اللّهمّ اشهد».
قالوا: أنت الآن، فحدّثنا من وليّك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإنّ وليّي جبريل، ولم يبعث اللّه نبيًّا قطّ إلّا وهو وليّه». قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك. قال: «فما منعكم أن تصدّقوه؟»، قالوا: إنّه عدوّنا. فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {قل من كان عدوًّا لجبريل} إلى قوله: {لو كانوا يعلمون} فعندها باؤوا بغضبٍ على غضبٍ.
وقد رواه الإمام
أحمد في مسنده، عن أبي النّضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميدٍ في تفسيره، عن
أحمد بن يونس، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، به.
ورواه الإمام أحمد -أيضًا- عن الحسين بن محمّدٍ المروزيّ، عن عبد الحميد، بنحوه [به] .
وقد رواه محمّد بن
إسحاق بن يسارٍ: حدّثني عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن أبي حسينٍ، عن شهر بن
حوشبٍ، فذكره مرسلًا، وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنّه جبريل، وهو الذي يأتيني؟»، قالوا: نعم، ولكنّه لنا عدوٌّ، وهو ملكٌ إنّما يأتي بالشّدّة وسفك الدّماء، فلولا ذلك اتّبعناك. فأنزل اللّه فيهم: {قل من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه} إلى قوله: {كأنّهم لا يعلمون} .
وقال الإمام أحمد:
حدّثنا أبو أحمد حدّثنا عبد اللّه بن الوليد العجليّ، عن بكير بن شهابٍ،
عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أقبلت يهود إلى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وسلّم فقالوا: يا أبا القاسم، إنّا نسألك عن خمسة أشياء، فإن
أنبأتنا بهنّ عرفنا أنّك نبيٌّ واتّبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على
بنيه إذ قال: {اللّه على ما نقول وكيلٌ}[يوسف:66] قال: «هاتوا».
قالوا: أخبرنا عن علامة النّبيّ. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه».
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكّر الرّجل؟ قال: «يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرّجل ماء المرأة أذكرت، وإذا علا ماء المرأة ماء الرّجل أنّثت»،
قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكي عرق النّساء، فلم يجد شيئًا يلائمه إلّا ألبان كذا وكذا -قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل- فحرّم لحومها»، قالوا: صدقت.
قالوا: أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: «ملكٌ من ملائكة اللّه، عزّ وجلّ، موكّلٌ بالسّحاب بيديه -أو: في يده- مخراق من نارٍ يزجر به السّحاب، يسوقه حيث أمره اللّه عزّ وجلّ».
قالوا: فما هذا الصّوت الذي نسمعه؟ قال: «صوته».
قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا إنّه ليس من نبيٍّ إلّا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟
قال: «جبريل عليه السّلام»،
قالوا: جبريل ذاك
الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوّنا، لو قلت: ميكائيل الذي ينزل
بالرحمة والنبات والقطر لكان، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {قل من كان عدوًّا لجبريل} إلى آخر الآية.
ورواه التّرمذيّ، والنّسائيّ من حديث عبد اللّه بن الوليد، به. وقال التّرمذيّ: حسنٌ غريبٌ.
وقال سنيد في
تفسيره، عن حجّاج بن محمّدٍ، عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزّة أنّ
يهود سألوا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي.
قال: «جبريل». قالوا: فإنّه لنا عدوٌّ، ولا يأتي إلّا بالشّدّة والحرب والقتال. فنزل: {قل من كان عدوًّا لجبريل} الآية.
قال ابن جريجٍ: وقال مجاهدٌ: «قالت يهود: يا محمّد، ما ينزل جبريل إلّا بشدّةٍ وحربٍ وقتالٍ، وإنّه لنا عدوٌّ. فنزل:{قل من كان عدوًّا لجبريل} الآية».
وقال البخاريّ: قوله: {من كان عدوًّا لجبريل}؛ قال عكرمة:«جبر، وميك، وإسراف: عبدٌ. وإيل: اللّه».
حدّثنا عبد اللّه
بن منير، سمع عبد اللّه بن بكرٍ، حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: سمع عبد
اللّه بن سلامٍ بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرضٍ يخترف.
فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّي سائلك عن ثلاثٍ لا يعلمهنّ
إلّا نبيٌّ: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنّة؟ وما ينزع
الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال:«أخبرني بهن جبريل آنفًا». قال: جبريل؟ قال: «نعم". قال: ذاك عدوّ اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: {من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك}،
«أمّا أوّل أشراط
السّاعة فنارٌ تحشر النّاس من المشرق إلى المغرب، وأمّا أوّل طعامٍ يأكله
أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة نزع الولد،
وإذا سبق ماء المرأة [ماء الرّجل] نزعت».
قال: أشهد أن لا
إله إلّا اللّه وأشهد أنّك رسول اللّه. يا رسول اللّه، إنّ اليهود قومٌ
بهت، وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني.
فجاءت اليهود، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:«أيّ رجلٍ عبد اللّه بن سلامٍ فيكم؟»، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيّدنا وابن سيّدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد اللّه بن سلامٍ».
فقالوا: أعاذه اللّه من ذلك. فخرج عبد اللّه، فقال: أشهد أن لا إله إلّا
اللّه وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّه. فقالوا: شرّنا وابن شرّنا. فانتقصوه.
قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول اللّه.
انفرد به البخاريّ
من هذا الوجه وقد أخرجه من وجهٍ آخر، عن أنسٍ بنحوه وفي صحيح مسلمٍ، عن
ثوبان مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قريبٌ من هذا السّياق كما
سيأتي في موضعه.
وحكاية البخاريّ عن عكرمة هو المشهور أنّ "إيل" هو اللّه. وقد رواه سفيان الثّوريّ، عن خصيف، عن عكرمة.
ورواه عبد بن
حميدٍ، عن إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، عن عكرمة، ورواه ابن جريرٍ، عن
الحسين بن يزيد الطّحّان، عن إسحاق بن منصورٍ، عن قيسٍ، عن عاصمٍ، عن
عكرمة، أنّه قال: «إنّ جبريل اسمه: عبد اللّه، وميكائيل: عبيد اللّه. إيل: اللّه».
ورواه يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، مثله سواءً. وكذا قال غير واحدٍ من السلف، كما سيأتي قريبا.
[وقال الإمام أحمد
في أثناء حديث سمرة بن جندبٍ: حدّثنا محمّد بن سلمة، حدّثنا محمّد بن
إسحاق، حدّثنا محمّد بن عمرو بن عطاءٍ قال: قال لي عليّ بن الحسين: «اسم جبريل: عبد اللّه، واسم ميكائيل: عبيد اللّه»].
ومن النّاس من
يقول: "إيل" عبارةٌ عن عبدٍ، والكلمة الأخرى هي اسم اللّه؛ لأنّ كلمة "إيل"
لا تتغيّر في الجميع، فوزانه: عبد اللّه، عبد الرّحمن، عبد الملك، عبد
القدّوس، عبد السّلام، عبد الكافي، عبد الجليل. فعبد موجودةٌ في هذا كلّه،
واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل
ونحو ذلك، وفي كلام غير العرب يقدّمون المضاف إليه على المضاف، واللّه
أعلم.
ثمّ قال ابن جريرٍ: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرةٍ جرت بين عمر بن الخطّاب وبينهم في أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. ذكر من قال ذلك:
حدّثني محمّد بن
المثنى، حدّثني ربعيّ بن عليّة، عن داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ، قال:
نزل عمر الرّوحاء، فرأى رجالًا يبتدرون أحجارًا يصلّون إليها، فقال: ما بال
هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلّى هاهنا.
قال: فكفر ذلك. وقال: إنّما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أدركته
الصّلاة بوادٍ صلّاها ثمّ ارتحل، فتركه. ثمّ أنشأ يحدّثهم،
فقال: كنت أشهد
اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التّوراة كيف تصدّق الفرقان ومن الفرقان كيف
يصدّق التّوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يومٍ،
قالوا: يا ابن الخطّاب، ما من أصحابك أحدٌ أحبّ إلينا منك.
قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنّك تغشانا وتأتينا.
فقلت: إنّي آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدّق التّوراة، ومن التّوراة كيف تصدّق الفرقان.
قال: ومرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: يا ابن الخطّاب، ذاك صاحبكم فالحق به،
قال: فقلت لهم عند
ذلك: نشدتكم باللّه الذي لا إله إلّا هو، وما استرعاكم من حقّه واستودعكم
من كتابه؛ أتعلمون أنّه رسول اللّه؟ قال: فسكتوا.
فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنّه قد غلّظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت.
قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنّا نعلم أنّه رسول اللّه،
قال: قلت: ويحكم فأنّي هلكتم؟! قالوا: إنّا لم نهلك،
[قال]: قلت: كيف ذلك وأنتم تعلمون أنّه رسول اللّه [ثمّ] ولا تتبعونه ولا تصدّقونه؟
قالوا: إنّ لنا عدوًّا من الملائكة وسلمًا من الملائكة، وإنّه قرن بنبوّته عدوّنا من الملائكة.
قال: قلت: ومن عدوّكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدوّنا جبريل، وسلمنا ميكائيل.
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل، وفيم سالمتم ميكائيل؟
قالوا: إنّ جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتّشديد والعذاب ونحو هذا، وإنّ ميكائيل ملك الرّأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا.
قال: قلت: وما منزلتهما من ربّهما عزّ وجلّ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.
قال: قلت:
فو[اللّه] الذي لا إله إلّا هو، إنّهما والذي بينهما لعدوٌّ لمن عاداهما
وسلمٌ لمن سالمهما، وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدوّ ميكائيل، وما ينبغي
لميكائيل أن يسالم عدوّ جبريل.
ثمّ قمت فاتّبعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فلحقته وهو خارجٌ من خوخة لبني فلانٍ، فقال: «يا ابن الخطّاب، ألا أقرئك آياتٍ نزلن قبل؟»، فقرأ عليّ: {من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه مصدّقًا لما بين يديه} حتّى قرأ هذه الآيات.
قال: قلت: بأبي وأمّي يا رسول اللّه، والذي بعثك بالحقّ لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك، فأسمع اللّطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر.
وقال ابن أبي
حاتمٍ: حدّثنا أبو سعيدٍ الأشج، حدثنا أبو أسامة، عن مجالدٍ، أنبأنا عامرٌ،
قال: انطلق عمر بن الخطّاب إلى اليهود، فقال:«أنشدكم بالذي أنزل التّوراة على موسى؛ هل تجدون محمّدًا في كتبكم؟»، قالوا: نعم.
قال: «فما يمنعكم أن تتبعوه؟»،
قالوا: إنّ اللّه لم يبعث رسولًا إلّا جعل له من الملائكة كفلا وإنّ جبريل
كفل محمّدًا، وهو الذي يأتيه، وهو عدوّنا من الملائكة، وميكائيل سلمنا؛ لو
كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا.
قال: «فإنّي أنشدكم باللّه الذي أنزل التّوراة على موسى؛ ما منزلتهما من ربّ العالمين؟»، قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله.
قال عمر:«وإنّي أشهد ما ينزلان إلّا بإذن اللّه، وما كان ميكائيل ليسالم عدوّ جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدوّ ميكائيل».
فبينما هو عندهم
إذ مرّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطّاب،
فقام إليه عمر فأتاه، وقد أنزل اللّه -عزّ وجلّ- عليه: {من كان عدوًّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين}.
وهذان الإسنادان يدلّان على أنّ الشّعبيّ حدّث به عن عمر، ولكن فيه انقطاعٌ بينه وبين عمر، فإنّه لم يدرك وفاته، واللّه أعلم.
وقال ابن جريرٍ:
حدّثنا بشرٌ، حدّثنا يزيد بن زريع، عن سعيدٍ، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنّ
عمر بن الخطّاب انطلق ذات يومٍ إلى اليهود. فلمّا أبصروه رحّبوا به، فقال
لهم عمر: «أما واللّه ما جئت لحبّكم ولا للرّغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم».
فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: «جبريل».
فقالوا: ذاك
عدوّنا من أهل السّماء، يطلع محمّدًا على سرّنا، وإذا جاء جاء الحرب
والسّنة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء الخصب والسّلم.
فقال لهم عمر: «هل تعرفون جبريل وتنكرون محمّدًا صلّى اللّه عليه وسلّم؟»،
ففارقهم عمر عند ذلك وتوجّه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدّثه حديثهم، فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: {قل من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه}.
ثمّ قال: حدّثني
المثنّى، حدّثنا آدم، حدّثنا أبو جعفرٍ، عن قتادة، قال: بلغنا أنّ عمر أقبل
إلى اليهود يومًا، فذكر نحوه. وهذا -أيضًا-منقطعٌ، وكذلك رواه أسباطٌ، عن
السّدّيّ، عن عمر مثل هذا أو نحوه، وهو منقطعٌ أيضًا.
وقال ابن أبي
حاتمٍ: حدّثنا محمّد بن عمّارٍ، حدّثنا عبد الرّحمن -يعني الدّشتكي-،
حدّثنا أبو جعفرٍ، عن حصين بن عبد الرّحمن، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: «أنّ يهوديًّا أتى عمر بن الخطّاب، فقال: إنّ جبريل الذي يذكر صاحبكم عدوٌّ لنا. فقال عمر:{من كان عدوًّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين}»، قال: «فنزلت على لسان عمر -رضي اللّه عنه-».
وقال ابن جريرٍ: حدّثني يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا هشيمٌ، أخبرنا حصين بن عبد الرّحمن، عن ابن أبي ليلى في قوله: {من كان عدوًّا لجبريل} قال: «قالت
اليهود للمسلمين: لو أنّ ميكائيل كان الذي ينزل عليكم اتّبعناكم، فإنّه
ينزل بالرّحمة والغيث، وإنّ جبريل ينزل بالعذاب والنّقمة فإنّه لنا عدوٌّ»، قال:«فنزلت هذه الآية».
حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاءٍ، بنحوه.
وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: {قل من كان عدوًّا لجبريل} قال: «قالت
اليهود: إنّ جبريل عدوّنا، لأنّه ينزل بالشّدّة والسّنة، وإنّ ميكائيل
ينزل بالرّخاء والعافية والخصب، فجبريل عدوّنا. فقال اللّه تعالى:{من كان عدوًّا لجبريل}[الآية]».
وأمًّا تفسير الآية؛ فقوله تعالى: {قل من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه}
أي: من عادى جبريل فليعلم أنّه الرّوح الأمين الذي نزل بالذّكر الحكيم على
قلبك من اللّه بإذنه له في ذلك، فهو رسولٌ من رسل اللّه ملكي [عليه وعلى
سائر إخوانه من الملائكة السّلام] ومن عادى رسولًا فقد عادى جميع الرّسل،
كما أنّ من آمن برسولٍ فإنّه يلزمه الإيمان بجميع الرّسل، وكما أنّ من كفر
برسولٍ فإنّه يلزمه الكفر بجميع الرّسل، كما قال تعالى: {إنّ
الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين اللّه ورسله ويقولون
نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم
الكافرون حقًّا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا}[النّساء:150، 151]
فحكم عليهم بالكفر المحقّق، إذ آمنوا ببعض الرّسل وكفروا ببعضهم وكذلك من
عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأنّ جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنّما
ينزل بأمر ربّه كما قال: {وما نتنزل إلا بأمر ربّك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربّك نسيًّا}[مريم: 64]، وقال تعالى: {وإنّه لتنزيل ربّ العالمين* نزل به الرّوح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين}[الشّعراء: 192-194]، وقد روى البخاريّ في صحيحه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالحرب». ولهذا غضب اللّه لجبريل على من عاداه، فقال: {من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن اللّه مصدّقًا لما بين يديه} أي: من الكتب المتقدّمة، {وهدًى وبشرى للمؤمنين} أي: هدًى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنّة، وليس ذلك إلّا للمؤمنين. كما قال تعالى: {قل هو للّذين آمنوا هدًى وشفاءٌ والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمًى أولئك ينادون من مكانٍ بعيدٍ}[فصّلت: 44]، وقال تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خسارًا} [الإسراء: 82]). [تفسير ابن كثير: 1/ 335-342]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {من كان عدوّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ اللّه عدوّ للكافرين (98)}
"ميكائيل" فيه
لغات، ميكائيل , وميكال, وقد قرئ بهما جميعاً, وميكَأْل بهمزة بغير ياء,
وهذه أسماء أعجمية دفعت إلى العرب, فلفظت بها بألفاظ مختلفة, أعني: جبريل،
وميكائيل, و"إسرائيل"
فيه لغات أيضا: إسراييل, وإسرال، وإسرايل, وإبراهيم, وإبراهم، وأبرهم,
وإبراهام، والقرآن إنما أتى بإبراهيم فقط, وعليه القراءة, وأكثر ما أرويه
من القراءة في كتابنا هذا, فهو عن أبي عبيد ممّا رواه إسماعيل بن إسحاق, عن
أبي عبد الرحمن, عن أبي عبيد). [معاني القرآن: 1/ 180-181]
وذكر جبريل
وميكائيل وقد كان ذكر الملائكة عمهما تشريفا لهما، وقيل: خصا لأن اليهود
ذكروهما ونزلت الآية بسببهما، فذكرهما واجب لئلا تقول اليهود إنا لم نعاد
الله وجميع ملائكته،
- وقرأ نافع «ميكائل» بهمزة دون ياء، وقرأ بها ابن كثير فيما روي عنه،
- وقرأ ابن عامر وابن كثير أيضا وحمزة والكسائي «ميكائيل» بياء بعد الهمزة،
- وقرأ أبو عمرو وعاصم «ميكال»، ورويت عن ابن كثير منذ رآها في النوم كما ذكرنا،
- وقرأ ابن محيصن «ميكئل» بهمزة دون ألف،
- وقرأ الأعمش «ميكاييل» بياءين،
وظهر الاسم في قوله: {فإنّ اللّه}
لئلا يشكل عود الضمير، وجاءت العبارة بعموم الكافرين لأن عود الضمير على
من يشكل سواء أفردته أو جمعته، ولو لم نبال بالاشكال وقلنا المعنى يدل
السامع على المقصد للزم تعيين قوم بعداوة الله لهم، ويحتمل أن الله تعالى قد علم أن بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن تطلق عليه عداوة الله للمآل.
وروي أن رجلا من اليهود لقي عمر بن الخطاب فقال له: أرأيت جبريل الذي يزعم صاحبك أنه يجيئه ذلك عدونا، فقال له عمر رضي الله عنه: {من كان عدوًّا للّه} إلى آخر الآية، فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا الخبر يضعف من جهة معناه). [المحرر الوجيز: 1/ 295-294]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (ثمّ قال تعالى: {من كان عدوًّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين} يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي -ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: {اللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس} [الحجّ: 75]-، {وجبريل وميكال}
وهذا من باب عطف الخاصّ على العامّ، فإنّهما دخلا في الملائكة، ثمّ عموم
الرّسل، ثمّ خصّصا بالذّكر؛ لأنّ السّياق في الانتصار لجبريل وهو السّفير
بين اللّه وأنبيائه،
وقرن معه ميكائيل
في اللّفظ؛ لأنّ اليهود زعموا أنّ جبريل عدوّهم وميكائيل وليّهم، فأعلمهم
أنّه من عادى واحدًا منهما فقد عادى الآخر وعادى اللّه أيضًا؛ لأنّه
-أيضًا- ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، كما قرن برسول اللّه صلّى اللّه
عليه وسلّم في ابتداء الأمر، ولكنّ جبريل أكثر، وهي وظيفته،
وميكائيل موكّلٌ
بالقطر والنّبات، هذاك بالهدى وهذا بالرّزق، كما أنّ إسرافيل موكّلٌ
بالصّور للنّفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الصّحيح: أنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا قام من اللّيل يقول: «اللّهمّ
رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشّهادة،
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحقّ
بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ».
وقد تقدّم ما حكاه البخاريّ، ورواه ابن جريرٍ عن عكرمة أنّه قال: «جبر، وميك، وإسراف: عبيد. وإيل: الله».
وقال ابن أبي
حاتمٍ: حدّثنا أحمد بن سنان، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن
الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عميرٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ،
قال:«إنّما قوله: "جبريل" كقوله: "عبد اللّه" و "عبد الرّحمن"».
وقيل: جبر: عبد. وإيل: اللّه.
وقال محمّد بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن عليّ بن الحسين، قال: «أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟»، قلنا: لا. قال: «اسمه عبد اللّه»، قال: «فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟»، قلنا: لا. قال:«اسمه عبيد اللّه. وكلّ اسمٍ مرجعه إلى "يل" فهو إلى اللّه».
قال ابن أبي حاتمٍ: وروي عن مجاهدٍ وعكرمة والضّحّاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك.
ثمّ قال: حدّثني أبي، حدّثنا أحمد بن أبي الحواري، حدّثني عبد العزيز بن عميرٍ، قال: «اسم جبريل في الملائكة خادم اللّه». قال: فحدّثت به أبا سليمان الدّارانيّ، فانتفض وقال: لهذا الحديث أحبّ إليّ من كلّ شيءٍ، [وكتبه] في دفترٍ كان بين يديه.
وفي جبريل
وميكائيل لغاتٌ وقراءاتٌ، تذكر في كتب اللّغة والقراءات، ولم نطوّل كتابنا
هذا بسرد ذلك إلّا أن يدور فهم المعنى عليه، أو يرجع الحكم في ذلك إليه،
وباللّه الثّقة، وهو المستعان.
وقوله تعالى: {فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين} فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل: فإنّه عدوٌّ للكافرين. قال: {فإنّ اللّه عدوٌّ للكافرين}، كما قال الشّاعر:
لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ ....... نغّص الموت ذا الغنى والفقيرا
وقال آخر:
ليت الغراب غداة ينعب دائبًا ....... كان الغراب مقطّع الأوداج
وإنّما أظهر الاسم
هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره، وإعلامهم أنّ من عادى أولياء اللّه فقد
عادى اللّه، ومن عادى اللّه فإنّ اللّه عدوٌّ له، ومن كان اللّه عدوّه فقد
خسر الدّنيا والآخرة، كما تقدّم الحديث:«من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآخر: «إنّي لأثأر لأوليائي كما يثأر اللّيث الحرب». وفي الحديث الصّحيح: «ومن كنت خصمه خصمته»). [تفسير ابن كثير: 1/ 342-343]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله عزّ وجلّ: {ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما يكفر بها إلّا الفاسقون} يعني: الآيات التي جرى ذكرها مما قد بيّنّاه، و"الآية" في اللغة: العلامة.
و{بينات}: واضحات، و"قد" إنما تدخل في الكلام لقوم لا يتوقعون الخبر، واللام في {لقد} لام قسم.
وقوله عزّ وجلّ: {وما يكفر بها إلا الفاسقون} يعني: الذين قد خرجوا عن القصد، وقد بيّنّا أن قول العرب "فسقت الرطبة": خرجت عن قشرتها). [معاني القرآن: 1/ 181]
والفاسقون هنا:
الخارجون عن الإيمان، فهو فسق الكفر، والتقدير: ما يكفر بها أحد إلّا
الفاسقون، لأن الإيجاب لا يأتي إلا بعد تمام جملة النفي).[المحرر الوجيز: 1/ 295]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({ولقد
أنزلنا إليك آياتٍ بيّناتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون (99) أو كلّما
عاهدوا عهدًا نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (100) ولمّا جاءهم رسولٌ
من عند اللّه مصدّقٌ لما معهم نبذ فريقٌ من الّذين أوتوا الكتاب كتاب
اللّه وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون (101) واتّبعوا ما تتلو الشّياطين على
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ الشّياطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحدٍ حتّى يقولا
إنّما نحن فتنةٌ فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارّين به من أحدٍ إلا بإذن اللّه ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون (102) ولو أنّهم آمنوا واتّقوا لمثوبةٌ من عند اللّه خيرٌ
لو كانوا يعلمون (103)}
قال الإمام أبو جعفر بن جريرٍ في قوله تعالى: {ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيّناتٍ}
أي: أنزلنا إليك يا محمّد علاماتٍ واضحاتٍ [دلالاتٍ] على نبوّتك، وتلك
الآيات هي ما حواه كتاب اللّه من خفايا علوم اليهود، ومكنونات سرائر
أخبارهم، وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنّبأ عمّا تضمّنته كتبهم التي
لم يكن يعلمها إلّا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه
من أحكامهم، التي كانت في التّوراة. فأطلع اللّه في كتابه الذي أنزله إلى
نبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البيّنات
لمن أنصف نفسه، ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كلّ ذي
فطرةٍ صحيحةٍ تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمّدٌ صلّى اللّه عليه وسلّم من
الآيات البيّنات التي وصف، من غير تعلّم تعلّمه من بشريٍّ ولا أخذ شيئًا
منه عن آدميٍّ. كما قال الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ: {ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيّناتٍ}
يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوةً وعشيّةً، وبين ذلك، وأنت عندهم
أمّيٌّ لا تقرأ كتابًا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول اللّه:
في ذلك لهم عبرةٌ وبيانٌ، وعليهم حجّةٌ لو كانوا يعلمون.
وقال محمّد بن إسحاق: حدّثني محمّد بن أبي محمّدٍ، عن عكرمة أو سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: «قال
ابن صوريا الفطيوني لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: يا محمّد، ما
جئتنا بشيءٍ نعرفه، وما أنزل اللّه عليك من آيةٍ بيّنةٍ فنتبعك. فأنزل
اللّه في ذلك من قوله: {ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيّناتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون}»). [تفسير ابن كثير: 1/ 344-345]
معنى {نبذه}: رفضه, ورمى به. قال الشاعر:
نظرت إلى عنوانه فنبذته ....... كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
ونصب {أوكلما عاهدوا} على الظرف.
وهذه الواو في {أوكلما}
تدخل عليها ألف الاستفهام، لأن الاستفهام مستأنف، والألف أمّ حروف
الاستفهام, وهذه الواو تدخل على هل فتقول: وهل زيد عاقل؟، لأن معنى ألف
الاستفهام موجود في "هل"، فكأن التقدير: أو هل، إلا أن ألف الاستفهام و"هل"
لا يجتمعان لإغناء "هل" عن الألف).[معاني القرآن: 1/ 181-182]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {أوكلّما
عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (100) ولمّا جاءهم
رسولٌ من عند اللّه مصدّقٌ لما معهم نبذ فريقٌ من الّذين أوتوا الكتاب كتاب
اللّه وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون (101) واتّبعوا ما تتلوا الشّياطين
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ الشّياطين كفروا يعلّمون النّاس
السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت}
- قال سيبويه: الواو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام،
- وقال الأخفش: هي زائدة،
- وقال الكسائي: هي «أو» وفتحت تسهيلا،
وقرأها قوم «أو» ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل، وكما يقول القائل: لأضربنك فيقول المجيب: أو يكفي الله.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا كله متكلف، واو في هذا المثل متمكنة في التقسيم، والصحيح قول سيبويه.
وقرئ «عهدوا عهدا»، وقرأ الحسن وأبو رجاء «عوهدوا».
و«عهداً» مصدر، وقيل: مفعول بمعنى أعطوا عهدا،
والنبذ: الطرح والإلقاء، ومنه النبيذ والمنبوذ،
والفريق: اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويقع على اليسير والكثير من الجمع، ولذلك فسرت كثرة النابذين بقوله: {بل أكثرهم} لما احتمل الفريق أن يكون الأقل، و{لا يؤمنون} في هذا التأويل حال من الضمير في {أكثرهم}،
- ويحتمل الضمير العود على الفريق،
- ويحتمل العود على جميع بني إسرائيل وهو أذم لهم،
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم،
وفي مصحف ابن مسعود «نقضه فريق»). [المحرر الوجيز: 1/ 296]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقال
مالك بن الصّيف -حين بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وذكّرهم ما أخذ
عليهم من الميثاق، وما عهد إليهم في محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم-:
واللّه ما عهد إلينا في محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم ولا أخذ [له] علينا
ميثاقًا. فأنزل اللّه: {أوكلّما عاهدوا عهدًا نبذه فريقٌ منهم}.
وقال الحسن البصريّ في قوله: {بل أكثرهم لا يؤمنون} قال: «نعم، ليس في الأرض عهدٌ يعاهدون عليه إلّا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم، وينقضون غدًا».
وقال السّدّيّ: «لا يؤمنون بما جاء به محمّدٌ صلّى اللّه عليه وسلّم».
وقال قتادة: «{نبذه فريقٌ منهم}أي: نقضه فريقٌ منهم».
وقال ابن جريرٍ:
أصل النّبذ: الطّرح والإلقاء، ومنه سمّي اللّقيط: منبوذًا، ومنه سمّي
النّبيذ، وهو التّمر والزّبيب إذا طرحا في الماء. قال أبو الأسود الدّؤليّ:
نظرت إلى عنوانه فنبذته ....... كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
قلت:
فالقوم ذمّهم اللّه بنبذهم العهود التي تقدّم الله إليهم في التّمسّك بها
والقيام بحقّها. ولهذا أعقبهم ذلك التّكذيب بالرّسول المبعوث إليهم وإلى
النّاس كافّةً، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتّباعه
ومؤازرته ومناصرته، كما قال: {الّذين يتّبعون الرّسول النّبيّ الأمّيّ الّذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التّوراة والإنجيل} الآية [الأعراف: 157]، وقال هاهنا: {ولمّا جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدّقٌ لما معهم نبذ فريقٌ من الّذين أوتوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون}). [تفسير ابن كثير: 1/ 345]
* للاستزادة ينظر: هنا