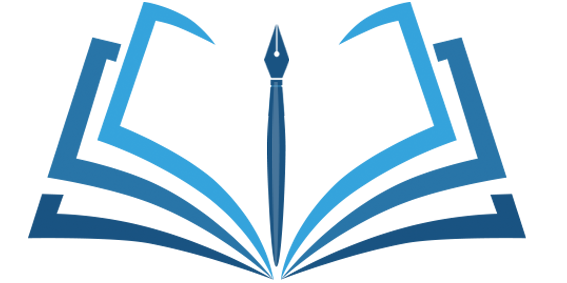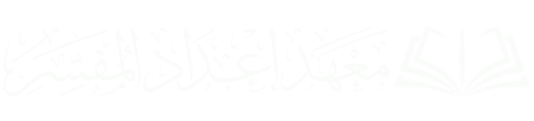تفسير سورة البقرة
القسم السابع عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (238) إلى الآية (242) ]

تفسير سورة البقرة
القسم السابع عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (238) إلى الآية (242) ]
17 Sep 2014
تفسير
قول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ
رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي
مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)}
تفسير قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين}
قالوا: {الصلاة الوسطى} العصر - وهو أكثر الرواية، وقيل إنها الغداة وقيل إنها الظهر.
واللّه قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات إلا أن هذه الواو إذا جاءت مخصصة فهي دالة على الفضل للذي تخصصه كما قال: عز وجل: {من كان عدوّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال} فذكرا مخصوصين لفضلهما على الملائكة، وقال يونس النحوي في قوله عزّ وجلّ: {فيهما فاكهة ونخل ورمّان} إنما خص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على سائرها.
وقوله عزّ وجلّ: {وقوموا للّه قانتين}.
القانت المطيع والقانت - الذاكر اللّه، كما قال عزّ وجلّ: {أمّن هو قانت آناء اللّيل ساجدا وقائما} وقيل القانت العابد - وقالوا في قوله عزّ وجلّ: (وكانت من القانتين) أي: العابدين.
والمشهور في اللغة والاستعمال: أن القنوت الدعاء في القيام، وحقيقة القانت أنه القائم بأمر اللّه، فالداعي إذا كان قائما خص بأن يقال له قانت،
لأنه ذاكر الله عزّ وجلّ وهو قائم على رجليه. فحقيقة القنوت العبادة والدعاء لله في حال القيام.
ويجوز أن: يقع في سائر الطاعة، لأنه إن لم يكن قياما بالرجلين فهو قيام بالشيء بالنية). [معاني القرآن: 1/320-321]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين (238) تفسير
قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ (239)} قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (ومعنى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون} أي:
فصلوا ركبانا أو رجالا، ورجال جمع راجل ورجال، مثل صاحب وصحاب، أي إن لم
يمكنكم أن تقوموا قانتين أي عابدين موفّين الصّلاة حقها لخوف ينالكم، فصلوا
رجالا أو ركبانا. وقوله عزّ وجلّ: {فإذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون} أي: فإذا أمنتم فقوموا قانتين مؤدّين للفرض). [معاني القرآن: 1/321] تفسير
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)} قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {والّذين
يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن
خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروف واللّه عزيز حكيم} {وصيّة لأزواجهم} و {وصية لأزواجهم} يقرءان جميعا. فمن نصب أراد فليوصوا وصية لأزواجهم. ومن رفع فالمعنى فعليهم وصية لأزواجهم. {متاعا إلى الحول غير إخراج}أي: متعوهنّ متاعا إلى الحول، ولا تخرجوهن، وهذا منسوخ بإجماع. نسخه ما قبله وقد بيناه. وقيل إنه نسخته آية المواريث وكلاهما - أعني ما أمر الله به من تربص أربعة أشهر وعشرا، وما جعل لهن من المواريث قد نسخه). [معاني القرآن: 1/321] تفسير قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)} تفسير قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)} قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تعقلون} آياته علاماته ودلالاته على ما فرض عليكم، أي: مثل هذا البيان يبين لكم ما هو فرض عليكم، وما فرض عليكم. ومعنى {لعلّكم تعقلون}:
معنى يحتاج إلى تفسير يبالغ فيه، لأن أهل اللغة والتفسير أخبروا في هذا
بما هو ظاهر، وحقيقة هذا أن العاقل ههنا أهو، الذي يعمل بما افترض عليه،
لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل ليس بعاقل، وحقيقة العقل هو
استعمال الأشياء المستقيمة متى علمت، ألا ترى إلى قوله عزّ وجلّ: {إنّما التّوبة على اللّه للّذين يعملون السّوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب}،
لو كان هؤلاء جهالا غير مميزين ألبتّة لسقط عنهم التكليف، لأن الله لا
يكلف من لا يميز، ويقال جهال وإن كانوا مميزين. لأنهم آثروا هواهم على ما
علموا أنه الحق). [معاني القرآن: 1/321-322]
الخطاب لجميع الأمة،
والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها وبجميع شروطها، وذكر
تعالى الصّلاة الوسطى ثانية وقد دخلت قبل في عموم قوله الصّلوات لأنه قصد
تشريفها وإغراء المصلين بها، وقرأ أبو جعفر الرؤاسي «والصلاة الوسطى»
بالنصب على الإغراء، وقرأ كذلك الحلواني.
واختلف الناس في أي
صلاة هو هذا الوصف، فذهبت فرقة إلى أنها الصبح وأن لفظ «وسطى» يراد به
الترتيب، لأنها قبلها صلاتا ليل يجهر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يسر فيهما،
قال هذا القول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وصلى بالناس يوما الصبح فقنت
قبل الركوع فلما فرغ قال: «هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها
قانتين»، وقاله أبو العالية ورواه عن جماعة من الصحابة، وقاله جابر بن عبد
الله وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شداد بن الهاد والربيع
ومالك بن أنس. وقوى مالك ذلك بأن الصبح لا تجمع إلى غيرها، وصلاتا جمع
قبلها وصلاتا جمع بعدها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون
ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقال: «إنهما أشدّ الصلوات على
المنافقين»، وفضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة، وقال
الله تعالى إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً [الإسراء: 78]، فيقوي هذا كله أمر
الصبح.
وقالت فرقة: هي صلاة الظهر. قاله زيد بن ثابت ورفع فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقاله أبو سعيد
الخدري وعبد الله بن عمر. واحتج قائلو هذه المقالة بأنها أول صلاة صليت في
الإسلام، فهي وسطى بذلك، أي فضلى، فليس هذا التوسط في الترتيب، وأيضا فروي
أنها كانت أشق الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تجيء
في الهاجرة، وهم قد نفعتهم أعمالهم في أموالهم، وأيضا فيدل على ذلك ما
قالته حفصة وعائشة حين أملتا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة
العصر، فهذا اقتران الظهر والعصر.
وقالت فرقة: الصّلاة
الوسطى صلاة العصر لأنها قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل، وروي هذا
القول أيضا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد
الخدري، وفي مصحف عائشة رضي الله عنها «والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر»،
وهو قولها المروي عنها. وقاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وفي إملاء
حفصة أيضا «والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر»، ومن روى «وصلاة العصر» فيتناول
أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد. كما تقول جاءني زيد
الكريم والعاقل، وروي عن ابن عباس أنه قرأ «حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى صلاة العصر» على البدل، وروى هذا القول سمرة بن جندب عن النبي صلى
الله عليه وسلم وتواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم
الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم
نارا»، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كنا نرى أنها الصبح حتى قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة
العصر. فعرفنا أنها العصر»، وقال البراء ابن عازب: «كنا نقرأ على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم نسخها الله،
فقرأنا: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي العصر؟،
قال: «قد أخبرتك كيف قرأناها وكيف نسخت»، والله أعلم. وروى أبو مالك
الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وعلى هذا القول جمهور الناس وبه أقوال والله أعلم.
وقال قبيصة بن ذؤيب:
«الصلاة الوسطى صلاة المغرب»، لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية ولا
رباعية، وأيضا فقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر، وحكى أبو عمر يوسف بن
عبد الله بن عبد البر في شرح باب جامع الوقوت وغيره عن فرقة أن الصّلاة
الوسطى صلاة العشاء الآخرة، وذلك أنها تجيء في وقت نوم وهي أشد الصلوات على
المنافقين، ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها،
وأيضا فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان.
وقالت فرقة: الصّلاة
الوسطى لم يعينها الله تعالى لنا، فهي في جملة الخمس غير معينة، كليلة
القدر في ليالي العشر، فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميع، قاله نافع
عن ابن عمر وقاله الربيع بن خثيم.
وقالت فرقة: الصّلاة الوسطى هي صلاة الجمعة فإنها وسطى فضلى، لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا، ذكره ابن حبيب ومكي.
وقال بعض العلماء:
الصّلاة الوسطى المكتوبة الخمس، وقوله أولا على الصّلوات يعم النفل والفرض،
ثم خص الفرض بالذكر، ويجري مع هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم:
«شغلونا عن الصلاة الوسطى».
وقوله تعالى وقوموا
للّه قانتين معناه في صلاتكم، واختلف الناس في معنى قانتين، فقال الشعبي:
«معناه مطيعين»، وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير، وقال الضحاك: «كل
قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة»، وقاله أبو سعيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم، وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون لله عاصمين، فقيل لهذه الأمة
وقوموا لله مطيعين، وقال نحو هذا الحسن بن أبي الحسن وطاوس، وقال السدي:
«قانتين معناه ساكتين»، وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان
ذلك مباحا في صدر الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود: «كنا نتكلم في الصلاة
ونرد السلام ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته» قال: «ودخلت يوما والنبي صلى الله
عليه وسلم يصلي بالناس فسلمت فلم يرد عليّ أحد، فاشتد ذلك عليّ، فلما فرغ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنا
أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة»، والقنوت السكوت، وقاله زيد بن
أرقم، وقال: «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا للّه قانتين، فأمرنا
بالسكوت»، وقال مجاهد: «معنى قانتين خاشعين، القنوت طول الركوع والخشوع وغض
البصر وخفض الجناح».
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وإحضار الخشية والفكر في الوقوف بين يدي الله تعالى، وقال
الربيع: «القنوت طول القيام وطول الركوع والانتصاب له»، وقال قوم: القنوت
الدعاء، وقانتين معناه داعين، روي معنى هذا عن ابن عباس، وفي الحديث: قنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، فقال قوم: معناه
دعا، وقال قوم: معناه طوّل قيامه، ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء). [المحرر الوجيز: 1/597-602]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({حافظوا
على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين (238) فإن خفتم فرجالا
أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون
(239)}
يأمر اللّه تعالى
بالمحافظة على الصّلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما
ثبت في الصّحيحين عن ابن مسعودٍ قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلّم: أيّ العمل أفضل؟ قال: "الصّلاة على وقتها". قلت: ثمّ أيٌّ؟ قال:
"الجهاد في سبيل اللّه". قلت: ثمّ أيٌّ؟ قال: "برّ الوالدين". قال: حدّثني
بهنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ولو استزدته لزادني.
وقال الإمام أحمد:
حدّثنا يونس، حدّثنا ليثٌ، عن عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصمٍ، عن القاسم
بن غنّامٍ، عن جدّته أمّ أبيه الدّنيا، عن جدّته أمّ فروة -وكانت ممّن
بايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّها سمعت رسول اللّه صلّى اللّه
عليه وسلّم، وذكر الأعمال، فقال: "إنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه تعجيل
الصّلاة لأوّل وقتها".
وهكذا رواه أبو داود، والتّرمذيّ وقال: لا نعرفه إلّا من طريق العمريّ، وليس بالقويّ عند أهل الحديث:
وخصّ تعالى من بينها
بمزيد التّأكيد الصّلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاةٍ هي؟
فقيل: إنّها الصّبح. حكاه مالكٌ في الموطّأ بلاغًا عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ
[قال: مالكٌ: وذلك رأيي]. وقال هشيمٌ، وابن عليّة، وغندر، وابن أبي عديٍّ،
وعبد الوهّاب، وشريك وغيرهم، عن عوفٍ الأعرابيّ، عن أبي رجاءٍ العطارديّ
قال: صلّيت خلف ابن عبّاسٍ الفجر، فقنت فيها، ورفع يديه، ثمّ قال: هذه
الصّلاة الوسطى الّتي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جريرٍ. ورواه
أيضًا من حديث عوفٍ، عن خلاس بن عمرٍو، عن ابن عبّاسٍ، مثله سواءً.
وقال ابن جريرٍ:
حدّثنا ابن بشّارٍ، حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا عوفٌ، عن أبي المنهال، عن
أبي العالية، عن ابن عبّاسٍ: أنّه صلّى الغداة في مسجد البصرة، فقنت قبل
الرّكوع وقال: هذه الصّلاة الوسطى الّتي ذكرها اللّه في كتابه فقال:
{حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين}
وقال أيضًا: حدّثنا
محمّد بن عيسى الدّامغانيّ، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الرّبيع بن أنسٍ،
عن أبي العالية قال: صلّيت خلف عبد اللّه بن قيسٍ بالبصرة صلاة الغداة،
فقلت لرجلٍ من أصحاب رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، إلى جانبي: ما
الصّلاة الوسطى؟ قال: هذه الصّلاة.
وروي من طريقٍ أخرى
عن الرّبيع، عن أبي العالية: أنّه صلّى مع أصحاب رسول اللّه، صلّى اللّه
عليه وسلّم، صلاة الغداة، فلمّا فرغوا قال، قلت لهم: أيّتهنّ الصّلاة
الوسطى؟ قالوا: الّتي قد صلّيتها قبل.
وقال أيضًا: حدّثنا
ابن بشّارٍ، حدّثنا ابن عتمة، عن سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن جابر بن عبد
اللّه قال: الصّلاة الوسطى: صلاة الصّبح.
وحكاه ابن أبي حاتمٍ،
عن ابن عمر، وأبي أمامة، وأنسٍ، وأبي العالية، وعبيد بن عميرٍ، وعطاءٍ،
ومجاهدٍ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والرّبيع بن أنسٍ. ورواه ابن جريرٍ، عن
عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد أيضًا وهو الّذي نصّ عليه الشّافعيّ، رحمه
اللّه، محتجًّا بقوله: {وقوموا للّه قانتين} والقنوت عنده في صلاة الصّبح.
[ونقله الدّمياطيّ عن عمر، ومعاذٍ، وابن عبّاسٍ، وابن عمر، وعائشة على
خلافٍ منهم، وأبي موسى، وجابرٍ، وأنسٍ، وأبي الشّعثاء، وطاوسٍ، وعطاءٍ،
وعكرمة، ومجاهدٍ].
ومنهم من قال: هي
الوسطى باعتبارٍ أنّها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيّتين مقصورتين. وتردّ
المغرب. وقيل: لأنّها بين صلاتي ليلٍ جهريّتين، وصلاتي نهارٍ سرّيّتين.
وقيل: إنّها صلاة
الظّهر. قال أبو داود الطّيالسيّ في مسنده: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن
الزبرقان - يعني ابن عمرٍو -عن زهرة -يعني ابن معبدٍ -قال: كنّا جلوسًا عند
زيد بن ثابتٍ، فأرسلوا إلى أسامة، فسألوه عن الصّلاة الوسطى، فقال: هي
الظّهر، كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، يصلّيها بالهجير.
وقال [الإمام] أحمد:
حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا شعبة، حدّثني عمرو بن أبي حكيمٍ، سمعت
الزّبرقان يحدّث عن عروة بن الزّبير، عن زيد بن ثابتٍ قال: كان رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة، ولم يكن يصلّي صلاةً أشدّ
على أصحاب النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم، منها، فنزلت: {حافظوا على
الصّلوات والصّلاة الوسطى} وقال: "إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين"، ورواه
أبو داود في سننه، من حديث شعبة، به.
وقال أحمد أيضًا:
حدّثنا يزيد، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ عن الزّبرقان أنّ رهطًا من قريشٍ مرّ بهم
زيد بن ثابتٍ، وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصّلاة
الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظّهر.
ثمّ انصرفا إلى أسامة بن زيدٍ فسألاه، فقال: هي الظّهر؛ أنّ النّبيّ صلّى
اللّه عليه وسلّم كان يصلّي الظّهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلّا الصّفّ
والصّفّان، والنّاس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل اللّه: {حافظوا على
الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين} قال: فقال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وسلّم: "لينتهينّ رجالٌ أو لأحرّقنّ بيوتهم".
الزّبرقان هو ابن
عمرو بن أمّيّة الضّمريّ، لم يدرك أحدًا من الصّحابة. والصّحيح ما تقدّم من
روايته، عن زهرة بن معبدٍ، وعروة بن الزّبير.
وقال شعبة وهمامٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابتٍ قال: الصّلاة الوسطى: صلاة الظّهر.
وقال أبو داود
الطّيالسيّ وغيره، عن شعبة، أخبرني عمر بن سليمان، من ولد عمر بن الخطّاب
قال: سمعت عبد الرّحمن بن أبان بن عثمان، يحدّث عن أبيه، عن زيد بن ثابتٍ
قال: الصّلاة الوسطى هي الظّهر.
ورواه ابن جريرٍ، عن
زكريّا بن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الصّمد، عن شعبة، عن عمر بن سليمان،
به، عن زيد بن ثابتٍ، في حديثٍ رفعه قال: الصّلاة الوسطى صلاة الظّهر.
وممّن روي عنه أنّها
الظّهر: ابن عمر، وأبو سعيدٍ، وعائشة على اختلافٍ عنهم. وهو قول عروة بن
الزّبير، وعبد اللّه بن شدّاد بن الهاد. وروايةٌ عن أبي حنيفة، رحمهم
اللّه.
وقيل: إنّها صلاة
العصر. قال التّرمذيّ والبغويّ، رحمهما اللّه: وهو قول أكثر علماء الصّحابة
وغيرهم، وقال القاضي الماورديّ: وهو قول جمهور التّابعين. وقال الحافظ أبو
عمر بن عبد البرّ: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمّد بن عطيّة في
تفسيره: هو قول جمهور الناس.
وقال الحافظ أبو
محمّدٍ عبد المؤمن بن خلفٍ الدّمياطيّ في كتابه المسمّى: "كشف المغطّى، في
تبيين الصّلاة الوسطى": وقد نصر فيه أنّها العصر، وحكاه عن عمر، وعليٍّ،
وابن مسعودٍ، وأبي أيوب، وعبد الله ابن عمرٍو، وسمرة بن جندب، وأبي هريرة،
وأبي سعيدٍ، وحفصة، وأمّ حبيبة، وأمّ سلمة. وعن ابن عمر، وابن عبّاسٍ،
وعائشة على الصّحيح عنهم. وبه قال عبيدة، وإبراهيم النّخعيّ، وزرّ بن
حبيشٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وابن سيرين، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والكلبيّ،
ومقاتلٌ، وعبيد بن أبي مريم، وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبلٍ. قال القاضي
الماورديّ: والشّافعيّ. قال ابن المنذر: وهو الصّحيح عن أبي حنيفة، وأبي
يوسف، ومحمّدٍ، واختاره ابن حبيبٍ المالكيّ، رحمهم اللّه.
ذكر الدّليل على ذلك:
قال الإمام أحمد:
حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش عن مسلمٍ، عن شتير بن شكلٍ عن عليٍّ قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصّلاة
الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللّه قلوبهم وبيوتهم نارًا". ثمّ صلّاها بين
العشاءين: المغرب والعشاء.
وكذا رواه مسلمٌ، من
حديث أبي معاوية محمّد بن حازمٍ الضّرير، والنّسائيّ من طريق عيسى بن يونس،
كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيحٍ عن أبي الضّحى، عن شتير بن شكل بن
حميدٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مثله.
وقد رواه مسلمٌ أيضًا، من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزّار، عن عليٍّ، به.
وأخرجه الشّيخان،
وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ، وغير واحدٍ من أصحاب المساند والسّنن،
والصّحاح من طرقٍ يطول ذكرها، عن عبيدة السّلمانيّ، عن عليٍّ، به.
ورواه التّرمذيّ، والنّسائيّ من طريق الحسن البصريّ، عن عليٍّ، به. قال التّرمذيّ: ولا يعرف سماعه منه.
وقال ابن أبي حاتمٍ:
حدّثنا أحمد بن سنانٍ، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن عاصمٍ،
عن زرٍّ: قال قلت لعبيدة: سل عليًّا عن صلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنّا
نراها الفجر -أو الصّبح -حتّى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول
يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ اللّه قبورهم
وأجوافهم -أو بيوتهم -نارًا" ورواه ابن جريرٍ، عن بندارٍ، عن ابن مهدي، به.
وحديث يوم الأحزاب،
وشغل المشركين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وأصحابه عن أداء صلاة
العصر يومئذٍ، مرويٌّ عن جماعةٍ من الصّحابة يطول ذكرهم، وإنّما المقصود
رواية من نصّ منهم في روايته أنّ الصّلاة الوسطى: هي صلاة العصر. وقد رواه
مسلمٌ أيضًا، من حديث ابن مسعودٍ، والبراء بن عازبٍ -رضي اللّه عنهما.
حديثٌ آخر: قال
الإمام أحمد: حدّثنا عفّان، حدّثنا همامٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "صلاة الوسطى: صلاة العصر".
وحدّثنا بهزٌ، وعفّان
قالا حدّثنا أبان، حدّثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أنّ رسول اللّه، صلّى
اللّه عليه وسلّم قال: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} وسمّاها لنا
أنّها هي: صلاة العصر.
وحدّثنا محمّد بن
جعفرٍ، وروحٌ، قالا حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندبٍ:
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "هي العصر". قال ابن جعفرٍ: سئل
عن صلاة الوسطى.
ورواه التّرمذيّ، من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وقال: حسنٌ صحيحٌ: وقد سمع منه.
[حديثٌ آخر]: وقال
ابن جريرٍ: حدّثنا أحمد بن منيعٍ، حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، عن
التّيميّ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلّم: "الصّلاة الوسطى صلاة العصر".
طريقٌ أخرى، بل حديثٌ
آخر: وقال ابن جريرٍ: حدّثني المثنّى، حدّثنا سليمان بن أحمد الجرشيّ
الواسطيّ، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ. قال: أخبرني صدقة بن خالدٍ، حدّثني خالد
بن دهقان، عن خالد بن سبلان، عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن
الصّلاة الوسطى، فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها، ونحن بفناء بيت رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وفينا الرّجل الصالحٍ: أبو هاشم بن عتبة بن
ربيعة بن عبد شمسٍ، فقال: أنا أعلم لكم ذلك: فقام فاستأذن على رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وسلّم، فدخل عليه، ثمّ خرج إلينا فقال: أخبرنا أنّها صلاة
العصر غريبٌ من هذا الوجه جدًّا.
حديثٌ آخر: قال ابن
جريرٍ: حدّثنا أحمد بن إسحاق، حدّثنا أبو أحمد، حدّثنا عبد السّلام، عن
سالمٍ مولى أبي بصيرٍ حدّثني إبراهيم بن يزيد الدّمشقيّ قال: كنت جالسًا
عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان، اذهب إلى فلانٍ فقل له: أيّ شيءٍ
سمعت من رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم. في الصّلاة الوسطى؟ فقال رجلٌ
جالسٌ: أرسلني أبو بكرٍ وعمر -وأنا غلامٌ صغيرٌ -أسأله عن الصّلاة الوسطى،
فأخذ إصبعي الصّغيرة فقال: هذه الفجر، وقبض الّتي تليها، فقال: هذه الظّهر.
ثمّ قبض الإبهام، فقال: هذه المغرب. ثمّ قبض الّتي تليها، فقال: هذه
العشاء. ثمّ قال: أيّ أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى. فقال: أيّ الصّلاة بقيت؟
فقلت: العصر. فقال: هي العصر. غريبٌ أيضًا.
حديثٌ آخر: قال ابن
جريرٍ: حدّثني محمّد بن عوفٍ الطّائيّ، حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن عيّاشٍ
حدّثني أبي، حدّثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيدٍ، عن أبي مالكٍ الأشعريّ
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "الصّلاة الوسطى صلاة العصر".
إسناده لا بأس به.
حديثٌ آخر: قال أبو
حاتم بن حبّان في صحيحه: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زهيرٍ، حدّثنا الجرّاح بن
مخلدٍ، حدّثنا عمرو بن عاصمٍ، حدّثنا همّامٌ عن قتادة عن مورّق العجلي، عن
أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
"صلاة الوسطى صلاة العصر".
وقد روى التّرمذيّ،
من حديث محمّد بن طلحة بن مصرّفٍ، عن زبيدٍ الياميّ، عن مرّة الهمداني، عن
ابن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " صلاة الوسطى صلاة
العصر " ثمّ قال: حسنٌ صحيحٌ.
وأخرجه مسلمٌ في صحيحه، من طريق محمّد بن طلحة، به ولفظه: "شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر" الحديث.
فهذه نصوصٌ في
المسألة لا تحتمل شيئًا، ويؤكّد ذلك الأمر بالمحافظة عليها، وقوله صلّى
اللّه عليه وسلّم في الحديث الصّحيح، من رواية الزّهريّ، عن سالمٍ، عن
أبيه: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "من فاتته صلاة العصر
فكأنّما وتر أهله وماله ". وفي الصّحيح أيضًا، من حديث الأوزاعيّ، عن يحيى
بن أبي كثيرٍ، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب، عن
النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "بكّروا بالصّلاة في يوم الغيم، فإنّه
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" .
وقال الإمام أحمد:
حدّثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللّه بن هبيرة، عن أبي
تميمٍ، عن أبي بصرة الغفاريّ قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلّم في وادٍ من أوديتهم، يقال له: المخمّص صلاة العصر، فقال: "إنّ هذه
الصّلاة صلاة العصر عرضت على الّذين من قبلكم فضيّعوها، ألا ومن صلّاها
ضعّف له أجره مرّتين، ألا ولا صلاة بعدها حتّى تروا الشّاهد".
ثمّ قال: رواه عن يحيى بن إسحاق، عن اللّيث، عن خير بن نعيم، عن عبد اللّه بن هبيرة، به.
وهكذا رواه مسلمٌ
والنّسائيّ جميعًا، عن قتيبة، عن اللّيث. ورواه مسلمٌ أيضًا من حديث محمّد
بن إسحاق، حدّثني يزيد بن أبي حبيبٍ كلاهما عن خير بن نعيمٍ الحضرميّ، عن
عبد اللّه ابن هبيرة السّبائيّ .
فأمّا الحديث الّذي
رواه الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا إسحاق، أخبرني مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن
القعقاع بن حكيمٍ، عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها
مصحفًا، قالت: إذا بلغت هذه الآية: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى}
فآذنّي. فلمّا بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة
الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين" قالت: سمعتها من رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وسلّم وهكذا رواه مسلمٌ، عن يحيى بن يحيى، عن مالكٍ، به.
وقال ابن جريرٍ:
حدّثني المثنّى، حدّثنا الحجّاج، حدّثنا حمّادٌ، عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: كان في مصحف عائشة: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وهي صلاة
العصر". وهكذا رواه من طريق الحسن البصريّ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلّم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالكٌ أيضًا، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن
رافعٍ قال: كنت أكتب مصحفًا لحفصة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم،
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى}
فلمّا بلغتها آذنتها. فأملت عليّ: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى
وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين".
وهكذا رواه محمّد بن
إسحاق بن يسارٍ فقال: حدّثني أبو جعفرٍ محمّد بن علي، ونافع مولى بن عمر:
أنّ عمر بن نافعٍ قال = فذكر مثله، وزاد: كما حفظتها من النّبيّ صلّى الله
عليه وسلم.
طريقٌ أخرى عن حفصة:
قال ابن جريرٍ: حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا
شعبة، عن أبي بشرٍ، عن عبد اللّه بن يزيد الأزديّ، عن سالم بن عبد اللّه:
أنّ حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحفًا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية:
{حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} فآذنّي. فلمّا بلغ آذنها فقالت:
اكتب: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر".
طريقٌ أخرى: قال ابن
جريرٍ: حدّثني ابن المثنّى عبد الوهّاب، حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، أنّ
حفصة أمرت مولًى لها أن يكتب لها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية: "
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى " فلا تكتبها حتّى أمليها عليك كما
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقرأها. فلمّا بلغها أمرته فكتبها:
"حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين".
قال نافعٌ: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه "الواو".
وكذا روى ابن جريرٍ، عن ابن عبّاسٍ وعبيد بن عميرٍ أنّهما قرآ كذلك.
وقال ابن جريرٍ:
حدّثنا أبو كريب، حدّثنا عبدة، حدّثنا محمّد بن عمرٍو، حدّثني أبو سلمة، عن
عمرو بن رافعٍ مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: "حافظوا على الصّلوات
والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين". وتقرير المعارضة أنّه
عطف صلاة العصر على الصّلاة الوسطى بواو العطف الّتي تقتضي المغايرة، فدلّ
ذلك على أنّها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوهٍ: أحدها أنّ هذا إن روي على أنّه
خبرٌ، فحديث عليٍّ أصحّ وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدةً، كما
في قوله: {وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين} [الأنعام:55]،
{وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض وليكون من الموقنين}
[الأنعام:75]، أو تكون لعطف الصّفات لا لعطف الذّوات، كقوله: {ولكن رسول
اللّه وخاتم النّبيّين} [الأحزاب:40]، وكقوله: {سبّح اسم ربّك الأعلى *
الّذي خلق فسوّى * والّذي قدّر فهدى * والّذي أخرج المرعى} [الأعلى 1-4]
وأشباه ذلك كثيرةٌ، وقال الشّاعر:
إلى الملك القرم وابن الهمام = وليث الكتيبة في المزدحم
وقال أبو دؤادٍ الإياديّ:
سلّط الموت والمنون عليهم = فلهم في صدى المقابر هام
والموت هو المنون؛ قال عديّ بن زيدٍ العبّاديّ:
فقدّمت الأديم لراهشيه = فألفى قولها كذبًا ومينا
والكذب: هو المين، وقد نصّ سيبويه شيخ النّحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصّاحب هو الأخ نفسه، واللّه أعلم.
وأمّا إن روي على
أنّه قرآنٌ فإنّه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآنٌ؛ ولهذا لم
يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحدٌ
من القرّاء الّذين تثبت الحجّة بقراءتهم، لا من السّبعة ولا غيرهم. ثمّ قد
روي ما يدلّ على نسخ هذه التّلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلمٌ:
حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا يحيى بن آدم، عن فضيل بن مرزوقٍ، عن شقيق بن
عقبة، عن البراء بن عازبٍ، قال: نزلت: "حافظوا على الصّلوات وصلاة العصر "
فقرأناها على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما شاء اللّه، ثمّ نسخها
اللّه، عزّ وجلّ، فأنزل: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} فقال له
زاهرٌ -رجلٌ كان مع شقيقٍ -: أفهي العصر؟ قال: قد حدّثتك كيف نزلت، وكيف
نسخها اللّه، عزّ وجلّ.
قال مسلمٌ: ورواه الأشجعيّ، عن الثّوريّ، عن الأسود، عن شقيقٍ.
قلت: وشقيقٌ هذا لم
يرو له مسلمٌ سوى هذا الحديث الواحد، واللّه أعلم. فعلى هذا تكون هذه
التّلاوة، وهي تلاوة الجادّة، ناسخةً للفظ رواية عائشة وحفصة، ولمعناها، إن
كانت الواو دالّةً على المغايرة، وإلّا فللفظها فقط، واللّه أعلم.
وقيل: إنّ الصّلاة
الوسطى هي صلاة المغرب. رواه ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبّاسٍ. وفي إسناده
نظرٌ؛ فإنّه رواه عن أبيه، عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن
أبي الخليل، عن عمّه، عن ابن عبّاسٍ قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا
القول ابن جريرٍ عن قبيصة بن ذؤيبٍ وحكي أيضًا عن قتادة على اختلافٍ عنه.
ووجّه هذا القول بعضهم بأنّها: وسطى في العدد بين الرّباعيّة والثّنائيّة،
وبأنّها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة، واللّه أعلم.
وقيل: إنّها العشاء
الآخرة، اختاره عليّ بن أحمد الواحديّ في تفسيره المشهور: وقيل: هي واحدةٌ
من الخمس، لا بعينها، وأبهمت فيهنّ، كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو
الشّهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيّب، وشريحٍ القاضي،
ونافعٍ مولى ابن عمر، والرّبيع بن خيثم، ونقل أيضًا عن زيد بن ثابتٍ،
واختاره إمام الحرمين الجوينيّ في نهايته.
وقيل: بل الصّلاة
الوسطى مجموع الصّلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتمٍ عن ابن عمر، وفي صحّته
أيضًا نظرٌ والعجب أنّ هذا القول اختاره الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ
النّمري، إمام ما وراء البحر، وإنّها لإحدى الكبر، إذ اختاره -مع اطّلاعه
وحفظه -ما لم يقم عليه دليلٌ من كتابٍ ولا سنّةٍ ولا أثرٍ. وقيل: إنّها
صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة.
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى.
وقيل: الوتر. وقيل: الضّحى. وتوقّف فيها آخرون لمّا تعارضت عندهم الأدلّة،
ولم يظهر لهم وجه التّرجيح. ولم يقع الإجماع على قولٍ واحدٍ، بل لم يزل
التّنازع فيها موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن.
قال ابن جريرٍ:
حدّثني محمّد بن بشّارٍ وابن مثنّى، قالا حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا
شعبة قال: سمعت قتادة يحدّث عن سعيد بن المسيّب قال: كان أصحاب رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وسلّم مختلفين في الصّلاة الوسطى هكذا، وشبّك بين أصابعه.
[وقد حكى فخر الدّين
الرّازيّ في تفسيره قولًا عن جمعٍ من العلماء منهم زيد بن ثابت، وربيع ابن
خيثم: أنّها لم يرد بيانها، وإنّما أريد إبهامها، كما أبهمت ليلة القدر في
شهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء اللّه
تعالى، ووقت الموت على المكلّف؛ ليكون في كلّ وقتٍ مستعدًّا، وكذا أبهمت
اللّيلة الّتي ينزل فيها من السّماء وباءٌ ليحذرها النّاس، ويعطوا الأهبة
دائمًا، وكذا وقت السّاعة استأثر اللّه بعلمه؛ فلا تأتي إلّا بغتةً].
وكلّ هذه الأقوال
فيها ضعفٌ بالنّسبة إلى الّتي قبلها، وإنّما المدار ومعترك النّزاع في
الصّبح والعصر. وقد ثبتت السّنّة بأنّها العصر، فتعيّن المصير إليها.
وقد روى الإمام أبو
محمّدٍ عبد الرّحمن بن أبي حاتمٍ الرّازيّ في كتاب "فضائل الشّافعيّ" رحمه
اللّه: حدّثنا أبي، سمعت حرملة بن يحيى التّجيبيّ يقول: قال الشّافعيّ: كلّ
ما قلت فكان عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خلاف قولي ممّا يصحّ، فحديث
النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أولى، ولا تقلّدوني. وكذا روى الرّبيع
والزّعفرانيّ وأحمد بن حنبلٍ، عن الشّافعيّ. وقال موسى أبو الوليد بن أبي
الجارود، عن الشّافعيّ: إذا صحّ الحديث وقلت قولًا فأنا راجعٌ عن قولي
وقائلٌ بذلك. فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمّة، رحمهم
اللّه ورضي عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضي الماورديّ بأنّ مذهب
الشّافعيّ، رحمه اللّه، أنّ صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نصّ في
الجديد وغيره أنّها الصّبح، لصحّة الأحاديث أنّها العصر، وقد وافقه على هذه
الطّريقة جماعةٌ من محدّثي المذهب، وللّه الحمد والمنّة. ومن الفقهاء في
المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهبًا للشّافعيّ، وصمّموا على أنّها
الصّبح قولًا واحدًا. قال الماورديّ: ومنهم من حكى في المسألة قولين،
ولتقرير المعارضات والجوابات موضعٌ آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدةٍ،
وللّه الحمد والمنّة.
وقوله تعالى: {وقوموا
للّه قانتين} أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزمٌ
ترك الكلام في الصّلاة، لمنافاته إيّاها؛ ولهذا لمّا امتنع النّبيّ صلّى
اللّه عليه وسلّم من الرّدّ على ابن مسعودٍ حين سلّم عليه، وهو في الصّلاة،
اعتذر إليه بذلك، وقال. "إنّ في الصّلاة لشغلًا"، وفي صحيح مسلمٍ أنّه
عليه السّلام قال لمعاوية بن الحكم [السّلميّ] حين تكلّم في الصّلاة: "إنّ
هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النّاس، إنما هي التسبيح والتكبير
وذكر الله".
وقال الإمام أحمد،
حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن إسماعيل، حدّثني الحارث بن شبيلٍ، عن أبي عمرٍو
الشّيبانيّ، عن زيد بن أرقم قال: كان الرّجل يكلّم صاحبه في عهد النّبيّ
صلّى اللّه عليه وسلّم، في الحاجة في الصّلاة، حتّى نزلت هذه الآية:
{وقوموا للّه قانتين} فأمرنا بالسّكوت. رواه الجماعة -سوى ابن ماجه، به، من
طرقٍ عن إسماعيل، به.
وقد أشكل هذا الحديث
على جماعةٍ من العلماء، حيث ثبت عندهم أنّ تحريم الكلام في الصّلاة كان
بمكّة، قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دلّ على
ذلك حديث ابن مسعودٍ الّذي في الصّحيح، قال: كنّا نسلّم على النّبيّ صلّى
اللّه عليه وسلّم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصّلاة، فيردّ علينا،
قال: فلمّا قدمنا سلّمت عليه، فلم يردّ عليّ، فأخذني ما قرب وما بعد، فلمّا
سلّم قال: "إنّي لم أردّ عليك إلّا أنّي كنت في الصّلاة، وإنّ اللّه يحدث
من أمره ما يشاء، وإنّ ممّا أحدث ألّا تكلّموا في الصّلاة".
وقد كان ابن مسعودٍ
ممّن أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثمّ قدم منها إلى مكّة مع من قدم،
فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: {وقوموا للّه قانتين} مدنيّةٌ بلا خلافٍ،
فقال قائلون: إنّما أراد زيد بن أرقم بقوله: "كان الرّجل يكلّم أخاه في
حاجته في الصّلاة" الإخبار عن جنس النّاس، واستدلّ على تحريم ذلك بهذه
الآية بحسب ما فهمه منها، واللّه أعلم.
وقال آخرون: إنّما
أراد أنّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك فقد أبيح
مرّتين، وحرّم مرّتين، كما اختار ذلك قومٌ من أصحابنا وغيرهم، والأوّل
أظهر. واللّه أيضًا أعلم.
وقال الحافظ أبو
يعلى: حدّثنا بشر بن الوليد، حدّثنا إسحاق بن يحيى، عن المسيّب، عن ابن
مسعودٍ قال: كنّا يسلّم بعضنا على بعضٍ في الصّلاة، فمررت برسول اللّه صلّى
اللّه عليه وسلّم فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ، فوقع في نفسي أنّه نزل فيّ
شيءٌ، فلمّا قضى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلاته قال: "وعليك السّلام،
أيّها المسلّم، ورحمة اللّه، إنّ اللّه، عزّ وجلّ، يحدث من أمره ما يشاء
فإذا كنتم في الصّلاة فاقنتوا ولا تكلّموا".
[تفسير ابن كثير: 1/645-655]
أمر الله تعالى
بالقيام له في الصلاة بحالة قنوت، وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، وهذا
على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة، ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة
أحيانا، فرخص لعبيده في الصلاة رجالا متصرفين على الأقدام، وركباناً على
الخيل والإبل، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، هذا قول جميع
العلماء وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة
أو من سبع يطلبه أو عدو يتبعه أو سيل يحمله، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على
روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه الآية، وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام
الناس فليس حكمها في هذه الآية، وفرق مالك رحمه الله بين خوف العدو المقاتل
وبين خوف السبع ونحوه بأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع
الأمن، وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء، وقوله تعالى فرجالًا هو
جمع راجل أو رجل من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركب ومشى على
قدميه فهو رجل وراجل ورجل» بضم الجيم وهي لغة أهل الحجاز، يقولون مشى فلان
إلى بيت الله حافيا رجلا، حكاه الطبري وغيره ورجلان ورجيل، ورجل وأنشد ابن
الأعرابي في «رجلان»: [الطويل]
عليّ إذا لاقيت ليلى بخلوة = أن ازدار بيت الله رجلان حافيا
ويجمع على رجال
ورجيلى ورجالى ورجّالى ورجّالة ورجّال ورجالي ورجلان ورجلة ورجلة ورجلة
بفتح الجيم وأرجلة وأراجل وأراجيل، والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضا على
رجال، فهذه الآية وقوله تعالى: يأتوك رجالًا [الحج: 27] هما من لفظ الرجلة
أي عدم المركوب، وقوله تعالى شهيدين من رجالكم [البقرة: 282] فهو جمع اسم
الجنس المعروف، وحكى المهدوي عن عكرمة وأبي مجلز أنهما قرآ «فرجّالا» بضم
الراء وشد الجيم المفتوحة، وعن عكرمة أيضا أنه قرأ «فرجالا» بضم الراء
وتخفيف الجيم، وحكى الطبري عن بعضهم أنه قرأ «فرجّلا» دون ألف على وزن فعل
بضم الفاء وشد العين، وقرأ جمهور القراء «أو ركبانا» وقرأ بديل بن ميسرة
«فرجالا فركبانا» بالفاء، والركبان جمع راكب، وهذه الرخصة في ضمنها بإجماع
من العلماء أن يكون الإنسان حيث ما توجه من السموات، ويتصرف بحسب نظره في
نجاة نفسه. واختلف الناس كم يصلي من الركعات. فمالك رحمه الله وجماعة من
العلماء لا يرون أن ينقص من عدد الركعات شيئا، بل يصلي المسافر ركعتين ولا
بد. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: يصلي ركعة إيماء. وروى مجاهد
عن ابن عباس أنه قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي
السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». وقال الضحاك بن مزاحم: «يصلي صاحب خوف الموت
في المسايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين»، وقال إسحاق بن
راهويه: «فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه»، ذكره ابن المنذر.
واختلف المتأولون في
قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا اللّه الآية، فقالت فرقة: المعنى فإذا زال
خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة في
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات، وهذا
هو الذي لم يكونوا يعلمونه، وقالت فرقة: المعنى فإذا كنتم آمنين قبل أو
بعد، كأنه قال: فمتى كنتم على أمن فاذكروا الله، أي صلوا الصلاة التي قد
علمتموها، أي فصلوا كما علمكم صلاة تامة، حكاه النقاش وغيره.
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وقوله على هذا التأويل ما لم تكونوا بدل من «ما» التي في قوله
كما، وإلا لم يتسق لفظ الآية، وعلى التأويل الأول ما مفعولة ب علّمكم، وقال
مجاهد: «معنى قوله فإذا أمنتم، فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة»،
ورد الطبري على هذا القول، وكذلك فيه تحويم على المعنى كثير، والكاف في
قوله كما للتشبيه بين ذكر الإنسان لله ونعمة الله عليه في أن تعادلا، وكان
الذكر شبيها بالنعمة في القدر وكفاء لها، ومن تأول «اذكروا» بمعنى صلوا على
ما ذكرناه فالكاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي علمه الله). [المحرر الوجيز: 1/602-605]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علّمكم ما لم
تكونوا تعلمون} لمّا أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصّلوات، والقيام
بحدودها، وشدّد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الّتي يشتغل الشّخص فيها عن
أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب فقال: {فإن خفتم
فرجالا أو ركبانًا} أي: فصلّوا على أيّ حالٍ كان، رجالًا أو ركبانا: يعني:
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالكٌ، عن نافعٍ: أنّ ابن عمر كان
إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثمّ قال: فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك صلّوا
رجالًا على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال
نافعٌ: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلّا عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
ورواه البخاريّ -وهذا لفظه -ومسلمٌ ورواه البخاريّ أيضًا من وجهٍ آخر عن
ابن جريجٍ عن موسى بن عقبة عن نافعٍ عن ابن عمر عن النّبيّ، صلّى اللّه
عليه وسلّم: نحوه أو قريبًا منه ولمسلمٍ أيضًا عن ابن عمر قال: فإن كان
خوفٌ أشدّ من ذلك فصلّ راكبًا أو قائمًا تومئ إيماءً.
وفي حديث عبد اللّه
بن أنيسٍ الجهنيّ لمّا بعثه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، إلى خالد بن
سفيان الهذليّ ليقتله وكان نحو عرفة -أو عرفاتٍ-فلمّا واجهه حانت صلاة
العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلّي وأنا أومئ إيماءً. الحديث بطوله
رواه أحمد وأبو داود بإسنادٍ جيّدٍ وهذا من رخص اللّه الّتي رخّص لعباده
ووضعه الآصار والأغلال عنهم.
وقد روى ابن أبي
حاتمٍ من طريق شبيب بن بشرٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية: يصلّي
الرّاكب على دابّته والرّاجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهدٍ
ومكحولٍ والسّدّيّ والحكم ومالكٍ والأوزاعيّ والثّوريّ والحسن بن صالحٍ نحو
ذلك وزادوا: يومئ برأسه أينما توجّه.
ثمّ قال: حدّثنا أبي
حدّثنا أبو غسّان حدّثنا داود -يعني ابن عليّة-عن مطرّفٍ عن عطيّة عن جابر
بن عبد اللّه قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه [إيماءً] حيث كان وجهه
فذلك قوله: {فرجالا أو ركبانًا}
وروي عن الحسن
ومجاهدٍ وسعيد بن جبيرٍ وعطاءٍ وعطيّة والحكم وحمّادٍ وقتادة نحو ذلك. وقد
ذهب الإمام أحمد فيما نصّ عليه، إلى أنّ صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان
ركعةً واحدةً إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الّذي رواه مسلمٌ
وأبو داود والنّسائيّ وابن ماجه وابن جريرٍ من حديث أبي عوانة الوضّاح بن
عبد اللّه اليشكريّ -زاد مسلمٌ والنّسائيّ: وأيّوب بن عائذٍ-كلاهما عن بكير
بن الأخنس الكوفيّ، عن مجاهدٍ عن ابن عبّاسٍ قال: فرض اللّه الصّلاة على
لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه وسلّم في الحضر أربعًا، وفي السّفر ركعتين وفي
الخوف ركعةً وبه قال الحسن البصريّ وقتادة والضّحّاك وغيرهم.
وقال ابن جريرٍ:
حدّثنا ابن بشّارٍ حدّثنا ابن مهديٍّ عن شعبة قال: سألت الحكم وحمّادًا
وقتادة عن صلاة المسايفة، فقالوا: ركعة وهكذا روى الثوري عنهم سواء.
وقال ابن جريرٍ
أيضًا: حدّثني سعيد بن عمرٍو السّكونيّ حدّثنا بقيّة بن الوليد حدّثنا
المسعوديّ حدّثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد اللّه قال: صلاة الخوف. ركعةٌ
واختار هذا القول ابن جريرٍ.
وقال البخاريّ: "باب
الصّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوّ" وقال الأوزاعيّ: إن كان تهيّأ
الفتح، ولم يقدروا على الصّلاة صلّوا إيماءً كلّ امرئٍ لنفسه فإن لم يقدروا
على الإيماء أخّروا الصّلاة حتّى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين
فإن لم يقدروا صلّوا ركعةً وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التّكبير
ويؤخّرونها حتّى يأمنوا. وبه قال مكحولٌ -وقال أنس بن مالكٍ: حضرت مناهضة
حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتدّ اشتعال القتال فلم يقدروا على الصّلاة
فلم نصلّ إلّا بعد ارتفاع النّهار فصلّيناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا.
قال أنسٌ: وما يسرّني بتلك الصّلاة الدّنيا وما فيها.
هذا لفظ البخاريّ ثمّ
استشهد على ذلك بحديث تأخيره، عليه السّلام، صلاة العصر يوم الخندق بعذر
المحاربة إلى غيبوبة الشّمس وبقوله عليه السّلام، بعد ذلك لأصحابه لمّا
جهّزهم إلى بني قريظة: "لا يصلّينّ أحدٌ منكم العصر إلّا في بني قريظة"،
فمنهم من أدركته الصّلاة في الطّريق فصلّوا وقالوا: لم يرد منّا رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وسلّم، إلّا تعجيل السّير ومنهم من أدركته فلم يصلّ إلى
أن غربت الشّمس في بني قريظة فلم يعنّف واحدًا من الفريقين. وهذا يدلّ على
اختيار البخاريّ لهذا القول والجمهور على خلافه ويعوّلون على أنّ صلاة
الخوف على الصّفة الّتي ورد بها القرآن في سورة النّساء ووردت بها الأحاديث
لم تكن مشروعةً في غزوة الخندق، وإنّما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرّحًا
بهذا في حديث أبي سعيدٍ وغيره وأمّا مكحولٌ والأوزاعيّ والبخاريّ فيجيبون
بأنّ مشروعيّة صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك؛ لأنّ هذا حالٌ نادرٌ
خاصٌّ فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصّحابة زمن عمر في فتح تستر وقد
اشتهر ولم ينكر، واللّه أعلم.
وقوله: {فإذا أمنتم
فاذكروا اللّه} أي: أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتمّوا ركوعها وسجودها
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها {كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون} أي: مثل
ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلّمكم ما ينفعكم في الدّنيا والآخرة،
فقابلوه بالشّكر والذّكر، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: {فإذا اطمأننتم
فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}
[النّساء:103] وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة
النّساء عند قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة} الآية
[النساء:102] ). [تفسير ابن كثير: 1/655-657]
الّذين رفع
بالابتداء، والخبر في الجملة التي هي «وصية لأزواجهم»، وقرأ ابن كثير ونافع
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «وصية» بالرفع، وذلك على وجهين: أحدهما
الابتداء والخبر في الظرف الذي هو قوله لأزواجهم، ويحسن الابتداء بنكرة من
حيث هو موضع تخصيص كما حسن أن يرتفع «سلام عليكم»، وخير بين يديك، وأمت في
حجر لا فيك، لأنها مواضع دعاء، والوجه الآخر أن تضمر له خبرا تقدره، فعليهم
وصية لأزواجهم، ويكون قوله لأزواجهم صفة. قال الطبري: «قال بعض النحاة:
المعنى كتبت عليهم وصية»، قال: «وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود»،
وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر «وصية» بالنصب، وذلك حمل على الفعل كأنه
قال: ليوصوا وصية، ولأزواجهم على هذه القراءة صفة أيضا، قال هارون: «وفي
حرف أبي بن كعب «وصية لأزواجهم متاع» بالرفع، وفي حرف ابن مسعود «الوصية
لأزواجهم متاعا»، وحكى الخفاف أن في حرف أبيّ «فمتاع لأزواجهم» بدل وصية.
ومعنى هذه الآية أن
الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك
وصية لها، واختلف العلماء ممن هي هذه الوصية، فقالت فرقة: كانت وصية من
الله تعالى تجب بعد وفاة الزوج، قال قتادة: «كانت المرأة إذا توفي عنها
زوجها فلها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما
في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى
الحول بالأربعة الأشهر والعشر». وقال الربيع وابن عباس والضحاك وعطاء وابن
زيد، وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من الزوج، كانوا ندبوا إلى أن يوصوا
للزوجات بذلك ف يتوفّون على هذا القول معناه يقاربون الوفاة ويحتضرون، لأن
الميت لا يوصي، قال هذا القول قتادة أيضا والسدي. وعليه حمل الآية أبو علي
الفارسي في الحجة، قال السدي: «إلا أن العدة كانت أربعة أشهر وعشرا، وكان
الرجال يوصون بسكنى سنة ونفقتها ما لم تخرج. فلو خرجت بعد انقضاء العدة
الأربعة الأشهر والعشر سقطت الوصية. ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض.
فأخذت ربعها أو ثمنها، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة وصارت الوصايا لمن لا
يرث، وقال الطبري عن مجاهد: «إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت
قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية، منها سكنى سبعة أشهر
وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قوله
تعالى: غير إخراجٍ، فإن خرجن فلا جناح عليكم.
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنها الطبري لا يلزم منها أن
الآية محكمة، ولا نص مجاهد ذلك، بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بالميراث.
ومتاعاً نصب على
المصدر، وكان هذا الأمر إلى الحول من حيث العام معلم من معالم الزمان قد
أخذ بحظ من الطول، وقوله تعالى: غير إخراجٍ معناه ليس لأولياء الميت ووارثي
المنزل إخراجها، وغير نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال: لا إخراجا،
وقيل: نصب على الحال من الموصين. وقيل: هي صفة لقوله متاعاً، وقوله تعالى:
فإن خرجن الآية، معناه أن الخروج إذا كان من قبل الزوجة فلا جناح على أحد
ولي أو حاكم أو غيره فيما فعلن في أنفسهن من تزويج وترك حداد وتزين إذا كان
ذلك من المعروف الذي لا ينكر، وقوله تعالى: واللّه عزيزٌ صفة تقتضي الوعيد
بالنقمة لمن خالف الحد في هذه النازلة فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج.
حكيمٌ أي محكم لما يأمر به عباده، وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه
إلا ما قوّله الطبري مجاهدا رحمه الله، وفي ذلك نظر على الطبري رحمه
الله). [المحرر الوجيز: 1/605-607]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({والّذين
يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا وصيّةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراجٍ
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروفٍ واللّه عزيزٌ
حكيمٌ (240) وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين (241) كذلك
يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تعقلون (242)}
قال الأكثرون: هذه الآية منسوخةٌ بالّتي قبلها وهي قوله: {يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا}
قال البخاريّ: حدّثنا
أميّة حدّثنا يزيد بن زريع عن حبيبٍ عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزّبير:
قلت لعثمان بن عفّان: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا} قد نسختها
الآية الأخرى فلم تكتبها -أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئًا منه من
مكانه.
ومعنى هذا الإشكال
الّذي قاله ابن الزّبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما
الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد الّتي نسختها يوهم
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأنّ هذا أمرٌ توقيفيٌّ، وأنا وجدتها
مثبّتةً في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.
قال ابن أبي حاتمٍ:
حدّثنا الحسن بن محمّد بن الصّبّاح حدّثنا حجّاج بن محمّدٍ عن ابن جريجٍ
وعثمان بن عطاءٍ عن عطاء عن ابن عبّاسٍ في قوله: {والّذين يتوفّون منكم
ويذرون أزواجًا وصيّةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراجٍ} فكان
للمتوفّى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدّار سنةً، فنسختها آية المواريث
فجعل لهنّ الرّبع أو الثّمن ممّا ترك الزّوج. ثمّ قال: وروي عن أبي موسى
الأشعريّ، وابن الزّبير ومجاهدٍ وإبراهيم وعطاءٍ والحسن وعكرمة وقتادة
والضّحّاك وزيد بن أسلم والسّدّيّ ومقاتل بن حيّان، وعطاءٍ الخراسانيّ
والرّبيع بن أنسٍ: أنّها منسوخةٌ.
وروي من طريق عليّ بن
أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قال: كان الرّجل إذا مات وترك امرأته اعتدّت سنةً
في بيته ينفق عليها من ماله ثمّ أنزل اللّه بعد: {والّذين يتوفّون منكم
ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا}
فهذه عدّة المتوفّى
عنها زوجها إلّا أن تكون حاملًا فعدّتها أن تضع ما في بطنها وقال: {ولهنّ
الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن [ممّا
تركتم]} [النّساء:12] فبيّن ميراث المرأة وترك الوصيّة والنّفقة.
قال: وروي عن مجاهدٍ والحسن وعكرمة وقتادة والضّحّاك والرّبيع ومقاتل بن حيّان، قالوا: نسختها {أربعة أشهرٍ وعشرًا}
قال: وروي عن سعيد بن
المسيّب قال: نسختها الّتي في الأحزاب: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات [ثمّ طلّقتموهنّ]} [الأحزاب:49].
قلت: وروي عن [مقاتلٍ و] قتادة: أنها منسوخة بآية الميراث.
وقال البخاري: حدثنا
إسحاق بن راهويه، حدّثنا روحٌ حدّثنا شبلٌ عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ:
{والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا} قال: كانت هذه العدّة، تعتدّ عند
أهل زوجها واجبٌ فأنزل اللّه: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا وصيّةً
لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراجٍ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن
في أنفسهنّ من معروفٍ} قال: جعل اللّه لها تمام السّنة سبعة أشهرٍ وعشرين
ليلةً وصيّةً إن شاءت سكنت في وصيّتها، وإن شاءت خرجت وهو قول اللّه: {غير
إخراجٍ فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدّة كما هي واجبٌ عليها زعم ذلك عن
مجاهدٍ: رحمه اللّه. وقال عطاءٌ: وقال ابن عبّاسٍ: نسخت هذه الآية عدّتها
عند أهلها فتعتدّ حيث شاءت وهو قول اللّه تعالى: {غير إخراجٍ} قال عطاءٌ:
إن شاءت اعتدّت عند أهلها وسكنت في وصيّتها، وإن شاءت خرجت لقول اللّه:
{فلا جناح عليكم فيما فعلن [في أنفسهنّ]} قال عطاءٌ: ثمّ جاء الميراث فنسخ
السّكنى، فتعتدّ حيث شاءت ولا سكنى لها ثمّ أسند البخاريّ عن ابن عبّاسٍ
مثل ما تقدّم عنه.
فهذا القول الّذي
عوّل عليه مجاهدٌ وعطاءٌ من أنّ هذه الآية لم تدلّ على وجوب الاعتداد سنةً
كما زعمه الجمهور حتّى يكون ذلك منسوخًا بالأربعة الأشهر وعشرا، وإنّما
دلّت على أنّ ذلك كان من باب الوصاة بالزّوجات أن يمكنّ من السّكنى في بيوت
أزواجهنّ بعد وفاتهم حولًا كاملًا إن اخترن ذلك ولهذا قال: {وصيّةً
لأزواجهم} أي: يوصيكم اللّه بهنّ وصيّةً كقوله: {يوصيكم اللّه في أولادكم}
الآية [النّساء:11] وقال: {وصيّةً من اللّه} [النّساء:12] وقيل: إنّما
انتصب على معنى: فلتوصوا بهنّ وصيّةً. وقرأ آخرون بالرّفع "وصيّةٌ" على
معنى: كتب عليكم وصيّةٌ واختارها ابن جريرٍ ولا يمنعن من ذلك لقوله: {غير
إخراجٍ} فأمّا إذا انقضت عدّتهنّ بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل،
واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنّهنّ لا يمنعن من ذلك لقوله {فإن
خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروفٍ} وهذا القول له
اتّجاهٌ، وفي اللّفظ مساعدةٌ له، وقد اختاره جماعةٌ منهم: الإمام أبو
العباس بن تيميّة وردّه آخرون منهم: الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ.
وقول عطاءٍ ومن تابعه
على أنّ ذلك منسوخٌ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهرٍ
والعشر فمسلّمٌ، وإن أرادوا أنّ سكنى الأربعة الأشهر وعشرٍ لا تجب في تركة
الميّت فهذا محلّ خلافٍ بين الأئمّة، وهما قولان للشّافعيّ رحمه اللّه، وقد
استدلّوا على وجوب السّكنى في منزل الزّوج بما رواه مالكٌ في موطّئه عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة: أنّ الفريعة
بنت مالك بن سنانٍ وهي أخت أبي سعيدٍ الخدريّ رضي اللّه عنهما أخبرتها:
أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تسأله أن ترجع إلى أهلها
في بني خدرة، فإنّ زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أبقوا، حتّى إذا كان بطرف
القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن
أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإنّ زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقةٍ
قالت: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "نعم" قالت: فانصرفت، حتّى
إذا كنت في الحجرة ناداني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم -أو أمر بي
فنوديت له-فقال: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصّة الّتي ذكرت له من شأن زوجي.
فقال: "امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة
أشهرٍ وعشرًا. قالت: فلمّا كان عثمان بن عفّان أرسل إليّ فسألني عن ذلك
فأخبرته، فاتّبعه وقضى به.
وكذا رواه أبو داود
والتّرمذيّ والنّسائيّ من حديث مالكٍ به،ورواه النّسائيّ أيضًا وابن ماجه
من طرقٍ عن سعد بن إسحاق به،وقال التّرمذيّ: حسنٌ صحيحٌ). [تفسير ابن كثير: 1/658-660]
اختلف الناس في هذه
الآية، فقال أبو ثور: «هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة دخل بها أو لم يدخل،
فرض لها أو لم يفرض، بهذه الآية»، وقال الزهري: «لكل مطلقة متعة، وللأمة
يطلقها زوجها».
وقال سعيد بن جبير:
«لكل مطلقة متعة». وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة: «جعل الله
تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض
لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها».
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: ففر ابن القاسم رحمه الله من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء،
والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم.
وإذا التزم ابن القاسم أن قوله وللمطلّقات عمّ كل مطلقة لزمه القول بالنسخ
ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في الثيب اللواتي قد جومعن
إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في هذا العموم.
فهذا يجيء قوله على
أن قوله تعالى: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ [البقرة: 237] مخصصة
لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل إن العموم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص، وقال
ابن زيد: «هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة، لأنه نزل قبل حقًّا على
المحسنين [البقرة: 236] فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت:
حقًّا على المتّقين فوجب ذلك عليهم».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: هذا الإيجاب هو من تقويل الطبري لا من لفظ ابن زيد.
وقوله تعالى: حقًّا نصب على المصدر، والمتّقين هنا ظاهره أن المراد من تلبس بتقوى الله تعالى). [المحرر الوجيز: 1/607-609]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} قال عبد الرّحمن بن زيد
بن أسلم: لمّا نزل قوله: {متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين}
[البقرة:236] قال رجلٌ: إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل. فأنزل اللّه
هذه الآية: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} وقد استدلّ
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكلّ مطلّقةٍ، سواءٌ كانت
مفوّضةً أو مفروضًا لها أو مطلّقًا قبل المسيس أو مدخولًا بها، وهو قولٌ عن
الشّافعيّ، رحمه اللّه. وإليه ذهب سعيد بن جبيرٍ. وغيره من السّلف واختاره
ابن جريرٍ. ومن لم يوجبها مطلقًا يخصّص من هذا العموم بمفهوم قوله: {لا
جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً
ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على
المحسنين} وأجاب الأوّلون: بأنّ هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص
على المشهور المنصور، واللّه أعلم). [تفسير ابن كثير: 1/660]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{كذلك يبيّن اللّه لكم آياته} أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما
أمركم به ونهاكم عنه بيّنه ووضّحه وفسّره ولم يتركه مجملًا في وقت احتياجكم
إليه {لعلّكم تعقلون} أي: تفهمون وتتدبّرون). [تفسير ابن كثير: 1/660]
* للاستزادة ينظر: هنا