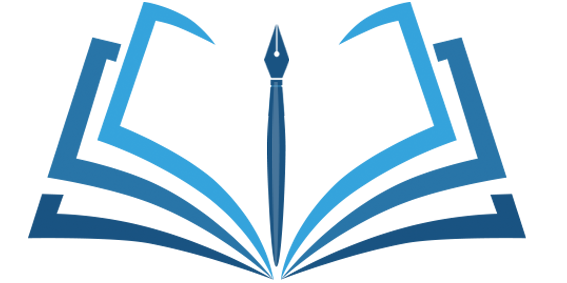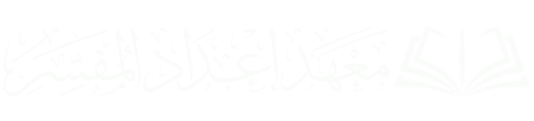تفسير سورة البقرة
القسم السابع عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (243) إلى الآية (245) ]

تفسير سورة البقرة
القسم السابع عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (243) إلى الآية (245) ]
17 Sep 2014
تفسير قول الله تعالى: {أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
(243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) }
تفسير
قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ
أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ أحياهم إنّ اللّه لذو فضل على النّاس ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون}
معنى {ألم تر}: ألم تعلم، أي ألم ينته علمك إلى خبر هؤلاء وهذه الألف ألف التوقيف، و {تر} متروكة الهمزة، وأصله ألم ترء إلى الذين.
والعرب مجمعة على ترك الهمزة في هذا.
ونصب {حذر الموت} على أنه مفعول له والمعنى خرجوا لحذر الموت، فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له وجاز أن يكون نصبه على المصدر، لأن خروجهم يدل على حذر الموت حذرا.
وقيل في تفسير الآية: إنهم كانوا ثمانية ألوف، أمروا في أيام بني إسرائيل إسرائيل أن يجاهدوا العدوّ، فاعتلوا بأن الموضع الذي ندبوا إليه ذو طاعون.
{فقال لهم اللّه موتوا} معناه: فأماتهم اللّه، ويقال إنهم أميتوا ثمانية أيام ثم أحيوا، وفي ذكر هذه الآية للنبي - صلى الله عليه وسلم - احتجاج على مشركي العرب وعلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنه أنبأ أهل الكتاب بما لا يدفعون صحته، وهو لم يقرأ كتابا - صلى الله عليه وسلم -.
فالذين تلا عليهم يعلمون إنّه لم يقرأ كتابا وأنه أمي، فلا يعلم هذه الأقاصيص إلا بوحي، إذ كانت لم تعلم من كتاب فعلم مشركو العرب أن كل من قرأ الكتب يصدقه - صلى الله عليه وسلم - في إخباره أنها كانت في كتبهم، ويعلم العرب الذين نشأ معهم مثل ذلك وأنه ما غاب غيبة يعلّم في مثلها أقاصيص الأمم وأخبارها على حقيقة وصحة، وفي هذه الآية أيضا معنى الحث على الجهاد وأن الموت لا يدفع بالهرب منه.
وقوله عزّ وجلّ: {إنّ اللّه لذو فضل على النّاس} أي: تفضل على هؤلاء بأن أحياهم بعد موتهم فأراهم البصيرة التي لا غاية بعدها.
وقوله عزّ وجلّ: يعقب هذه الآية:
{وقاتلوا في سبيل اللّه واعلموا أنّ اللّه سميع عليم}). [معاني القرآن: 1/322-323]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله
عز وجل: ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم
اللّه موتوا ثمّ أحياهم إنّ اللّه لذو فضلٍ على النّاس ولكنّ أكثر النّاس
لا يشكرون (243) تفسير قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244)} قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): ( {وقاتلوا في سبيل اللّه واعلموا أنّ اللّه سميع عليم}أي: لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء الذين سمعتم خبرهم، فلا ينفعكم الهرب. ومعنى قوله عزّ وجلّ مع ذكر القتال: {واعلموا أنّ اللّه سميع عليم}أي: إن قلتم كما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت سمع قولكم وعلم ما تريدون). [معاني القرآن: 1/323-324] تفسير
قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {من ذا الّذي يقرض اللّه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللّه يقبض ويبسط وإليه ترجعون} معنى القرض في اللغة: البلاء
السيئ، والبلاء الحسن، والعرب تقول: لك عندي قرض حسن وقرض سيئ، وأصله ما
يعطيه الرجل أو يعمله ليجازى عليه، واللّه عزّ وجلّ: لا يستقرض من عوز
ولكنه يبلو الأخبار، فالقرض كما وصفنا، قال أمية بن أبي الصلت: لا تخلطن خبيثات بطيبة... وأخلع ثيابك منها وانج عريانا كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا... أو سيئا أو مدينا كالذي دانا وقال الشاعر: وإذا جوزيت قرضا فاجزه... إنما يجزي الفتى ليس الجمل فمعنى القرض ما ذكرناه. فأعلم اللّه أن ما يعمل وينفق يراد به الجزاء فاللّه يضاعفه أضعافا كثيرة. والقراءة
فيضاعفه، و(قرأوا): فيضاعفه، بالنّصب والرفع فمن رفع عطف على يقرض، ومن
عطف نصب على جواب الاستفهام وقد بينا الجواب بالفاء - ولو كان قرضا ههنا
مصدرا لكان إقراضا، ولكن قرضا ههنا اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. فأما قرضته أقرضه قرضا: فجاوزته، وأصل القرض في اللغة القطع. والقراض من هذا أخذ، فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازى عليها. وقوله عزّ وجلّ: {واللّه يقبض ويبسط}قيل في هذا غير قول: 1-قال بعضهم: معناه يقتر ويوسع، 2- وقال بعضهم يسلب قوما ما أنعم عليهم ويوسع على آخرين (وقيل معنى - يقبض) أي يقبض الصدقات ويخلفها، وإخلافها: -جائز أن يكون ما يعطي من الثواب في الآخرة، -وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا). [معاني القرآن: 1/324-325]
هذه رؤية القلب
بمعنى: ألم تعلم، والكلام عند سيبويه بمعنى تنبه إلى أمر الذين، ولا تحتاج
هذه الرؤية إلى مفعولين، وقصة هؤلاء فيما قال الضحاك هي أنهم قوم من بني
إسرائيل أمروا بالجهاد، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد، فخرجوا من ديارهم
فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم
وأمرهم بالجهاد بقوله وقاتلوا في سبيل اللّه [البقرة: 190- 244] الآية،
وحكى قوم من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من بني إسرائيل
وقع فيهم الوباء، فخرجوا من ديارهم فرارا منه، فأماتهم الله، فبنى عليهم
سائر بني إسرائيل حائطا، حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل النبي عليه
السلام، فدعا الله فأحياهم له، وقال السدي: «هم أمة كانت قبل واسط في قرية
يقال لها داوردان، وقع بها الطاعون فهربوا منه وهم بضعة وثلاثون ألفا». في
حديث طويل، ففيهم نزلت الآية.
وقال إنهم فروا من
الطاعون: الحسن وعمرو بن دينار. وحكى النقاش أنهم فروا من الحمى. وحكى فيهم
مجاهد أنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرفون. لكن سحنة الموت على وجوههم.
ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت
لهم، وروى ابن جريج عن ابن عباس أنهم كانوا من بني إسرائيل، وأنهم كانوا
أربعين ألفا وثمانية آلاف، وأنهم أميتوا ثم أحيوا وبقيت الرائحة على ذلك
السبط من بني إسرائيل إلى اليوم، فأمرهم الله بالجهاد ثانية فذلك قوله
وقاتلوا في سبيل اللّه [البقرة: 190- 244].
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله
تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أخبارا في عبارة التنبيه
والتوقيف، عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فأماتهم الله
تعالى ثم أحياهم، ليرواهم وكل من خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا
بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولاغترار مغتر، وجعل الله تعالى هذه الآية
مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد. هذا قول الطبري، وهو
ظاهر رصف الآية، ولموردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها.
واختلف الناس في لفظ ألوفٌ. فقال الجمهور: هي جمع ألف. وقال بعضهم: كانوا
ثمانين ألفا. وقال ابن عباس: «كانوا أربعين ألفا». وقيل: كانوا ثلاثين
ألفا. وهذا كله يجري مع ألوفٌ إذا هو جمع الكثير، وقال ابن عباس أيضا:
«كانوا ثمانية آلاف»، وقال أيضا: أربعة آلاف، وهذا يضعفه لفظ ألوفٌ لأنه
جمع الكثير. وقال ابن زيد في لفظ ألوفٌ: «إنما معناها وهم مؤتلفون» أي لم
تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم. إنما كانوا مؤتلفين، فخالفت هذه الفرقة
فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة، فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم.
وقوله تعالى: فقال
لهم اللّه موتوا الآية، إنما هي مبالغة في العبارة عن فعله بهم. كأن ذلك
الذي نزل بهم فعل من قيل له: مت، فمات، وحكي أن ملكين صاحا بهم: موتوا،
فماتوا. فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين. وهذا الموت ظاهر الآية، وما
روي في قصصها أنه موت حقيقي فارقت فيه الأرواح الأجساد، وإذا كان ذلك فليس
بموت آجالهم، بل جعله الله في هؤلاء كمرض حادث مما يحدث على البشر. وقوله
تعالى: إنّ اللّه لذو فضلٍ على النّاس الآية، تنبيه على فضل الله على هؤلاء
القوم الذين تفضل عليهم بالنعم وأمرهم بالجهاد، وأمرهم بأن لا يجعلوا
الحول والقوة إلّا له، حسبما أمر جميع العالم بذلك، فلم يشكروا نعمته في
جميع هذا، بل استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم. وهذه الآية تحذير
لسائر الناس من مثل هذا الفعل، أي فيجب أن يشكر الناس فضل الله في إيجاده
لهم ورزقه إياهم وهدايته بالأوامر والنواهي، فيكون منهم الجري إلى امتثالها
لا طلب الخروج عنها، وتخصيصه تعالى الأكثر دلالة على الأقل الشاكر). [المحرر الوجيز: 1/609-611]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({ألم
تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا
ثمّ أحياهم إنّ اللّه لذو فضلٍ على النّاس ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون
(243) وقاتلوا في سبيل اللّه واعلموا أنّ اللّه سميعٌ عليمٌ (244) من ذا
الّذي يقرض اللّه قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً واللّه يقبض ويبسط
وإليه ترجعون (245)}
روي عن ابن عبّاسٍ
أنّهم كانوا أربعة آلافٍ وعنه: كانوا ثمانية آلافٍ. وقال أبو صالحٍ: تسعة
آلافٍ وعن ابن عبّاسٍ: أربعون ألفًا وقال وهب بن منبّهٍ وأبو مالكٍ: كانوا
بضعةً وثلاثين ألفًا وروى ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبّاسٍ قال: كانوا أهل
قريةٍ يقال لها: داوردان. وكذا قال السّدّيّ وأبو صالحٍ وزاد: من قبل
واسطٍ. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعاتٍ، وقال ابن جريجٍ عن
عطاءٍ قال: هذا مثلٌ. وقال عليّ بن عاصمٍ: كانوا: من أهل داوردان: قريةٌ
على فرسخٍ من واسطٍ.
وقال وكيع بن الجرّاح
في تفسيره: حدّثنا سفيان عن ميسرة بن حبيبٍ النّهديّ، عن المنهال بن عمرٍو
الأسديّ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: {ألم تر إلى الّذين خرجوا من
ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت} قال: كانوا أربعة آلافٍ خرجوا فرارًا من
الطّاعون قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موتٌ حتّى إذا كانوا بموضع كذا وكذا
قال اللّه لهم موتوا فماتوا فمرّ عليهم نبيٌّ من الأنبياء فدعا ربّه أن
يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عزّ وجلّ: {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم
وهم ألوفٌ حذر الموت} الآية.
وذكر غير واحدٍ من
السّلف أنّ هؤلاء القوم كانوا أهل بلدةٍ في زمان بني إسرائيل استوخموا
أرضهم وأصابهم بها وباءٌ شديدٌ فخرجوا فرارًا من الموت إلى البرّيّة،
فنزلوا واديًا أفيح، فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل اللّه إليهم ملكين أحدهما
من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحةً واحدةً فماتوا عن آخرهم
موتة رجلٍ واحدٍ فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبورٌ [وفنوا]
وتمزّقوا وتفرّقوا فلمّا كان بعد دهرٍ مرّ بهم نبيٌّ من أنبياء بني إسرائيل
يقال له: حزقيل فسأل اللّه أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن
يقول: أيّتها العظام البالية إنّ اللّه يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كلّ
جسدٍ بعضها إلى بعضٍ، ثمّ أمره فنادى: أيّتها العظام إنّ اللّه يأمرك بأن
تكتسي لحمًا وعصبًا وجلدًا. فكان ذلك، وهو يشاهده ثمّ أمره فنادى: أيّتها
الأرواح إنّ اللّه يأمرك أن ترجع كلّ روحٍ إلى الجسد الّذي كانت تعمره.
فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم اللّه بعد رقدتهم الطّويلة، وهم يقولون:
سبحانك [اللّهمّ ربّنا وبحمدك] لا إله إلّا أنت.
وكان في إحيائهم
عبرةٌ ودليلٌ قاطعٌ على وقوع المعاد الجسمانيّ يوم القيامة ولهذا قال: {إنّ
اللّه لذو فضلٍ على النّاس} أي: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج
القاطعة والدّلالات الدّامغة، {ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون} أي: لا يقومون
بشكر ما أنعم اللّه به عليهم في دينهم ودنياهم.
وفي هذه القصّة عبرةٌ
ودليلٌ على أنّه لن يغني حذرٌ من قدرٍ وأنّه، لا ملجأ من اللّه إلّا إليه،
فإنّ هؤلاء فرّوا من الوباء طلبًا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم
الموت سريعًا في آنٍ واحدٍ.
ومن هذا القبيل
الحديث الصّحيح الّذي رواه الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالكٌ
وعبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ كلاهما عن الزّهريّ عن عبد الحميد بن عبد
الرّحمن بن زيد [ابن أسلم] بن الخطّاب عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفلٍ عن
عبد اللّه بن عباس: أن عمر بن الخطّاب خرج إلى الشّام حتّى إذا كان بسرغٍ
لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه فأخبروه أنّ الوباء قد
وقع بالشّام فذكر الحديث فجاءه عبد الرّحمن بن عوفٍ وكان متغيّبًا لبعض
حاجته فقال: إنّ عندي من هذا علمًا، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم
يقول: "إذا كان بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه، وإذا سمعتم به
بأرضٍ فلا تقدموا عليه" فحمد اللّه عمر ثمّ انصرف.
وأخرجاه في الصّحيحين من حديث الزّهريّ به.
طريقٌ أخرى لبعضه:
قال أحمد: حدّثنا حجّاجٌ ويزيد العمّي قالا أخبرنا ابن أبي ذئبٍ عن
الزّهريّ عن سالمٍ عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة: أنّ عبد الرّحمن بن عوفٍ
أخبر عمر، وهو في الشّام عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "أنّ هذا
السّقم عذّب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرضٍ فلا تدخلوها وإذا وقع
بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه" قال: فرجع عمر من الشّام.
وأخرجاه في الصّحيحين من حديث مالكٍ عن الزّهريّ بنحوه). [تفسير ابن كثير: 1/660-662]
الواو في هذه الآية
عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم، هذا قول الجمهور إن هذه الآية هي مخاطبة
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله، وهو الذي ينوى به أن
تكون كلمة الله هي العليا حسب الحديث، وقال ابن عباس والضحاك: الأمر
بالقتال هو للذين أحيوا من بني إسرائيل، فالواو على هذا عاطفة على الأمر
المتقدم، المعنى وقال لهم قاتلوا، قال الطبري رحمه الله: «ولا وجه لقول من
قال إن الأمر بالقتال هو للذين أحيوا»، وسميعٌ معناه للأقوال، عليمٌ
بالنيات). [المحرر الوجيز: 1/611]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{وقاتلوا في سبيل اللّه واعلموا أنّ اللّه سميعٌ عليمٌ} أي: كما أنّ الحذر
لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنّبه لا يقرّب أجلًا ولا
يباعده، بل الأجل المحتوم والرّزق المقسوم مقدّرٌ مقنّنٌ لا يزاد فيه ولا
ينقص منه كما قال تعالى: {الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما
قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين} [آل عمران:168] وقال
تعالى: {وقالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لولا أخّرتنا إلى أجلٍ قريبٍ قل
متاع الدّنيا قليلٌ والآخرة خيرٌ لمن اتّقى ولا تظلمون فتيلا * أينما
تكونوا يدرككّم الموت ولو كنتم في بروجٍ مشيّدةٍ} [النّساء:77، 78] وروّينا
عن أمير الجيوش ومقدّم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف اللّه المسلول على
أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي اللّه عنه، أنّه قال:-وهو في سياق
الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفًا وما من عضوٍ من أعضائي إلّا وفيه رميةٌ أو
طعنةٌ أو ضربةٌ وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير!! فلا نامت أعين
الجبناء يعني: أنّه يتألّم لكونه ما مات قتيلًا في الحرب ويتأسّف على ذلك
ويتألّم أن يموت على فراشه). [تفسير ابن كثير: 1/662]
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: ويقال فيه ابن الدحداحة، واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو
تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه من شبه القرض بالعمل للثواب، والله هو
الغني الحميد، لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في
الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع
والشراء، وقد ذهبت اليهود في مدة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخليط على
المؤمنين بظاهر الاستقراض وقالوا إلهكم محتاج يستقرض، وهذا بين الفساد،
وقوله حسناً معناه تطيب فيه النية، ويشبه أيضا أن تكون إشارة إلى كثرته
وجودته، واختلف القراء في تشديد العين وتخفيفها ورفع الفاء ونصبها وإسقاط
الألف وإثباتها من قوله تعالى: فيضاعفه فقرأ ابن كثير «فيضعّفه» برفع الفاء
من غير ألف وتشديد العين في جميع القرآن، وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه نصب
الفاء في جميع القرآن، ووافقه عاصم على نصب الفاء إلا أنه أثبت الألف في
«فيضاعفه» في جميع القرآن، وكان أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك كله إلا من
سورة الأحزاب. قوله تعالى: يضاعف لها العذاب [الأحزاب: 30]، فإنه بغير ألف
كان يقرأه، وقرأ حمزة والكسائي ونافع ذلك كله بالألف ورفع الفاء، فالرفع في
الفاء يتخرج على وجهين: أحدهما العطف على ما في الصلة. وهو يقرض، والآخر
أن يستأنف الفعل ويقطعه، قال أبو علي: «والرفع في هذا الفعل أحسن».
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب الاستفهام، وذلك إنما يترتب
إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفا له. تقول:
أتقرضني فأشكرك، وهاهنا إنما الاستفهام عن الذي يقرض لا عن الإقراض، ولكن
تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في النصب على المعنى، لأنه لم يستفهم عن فاعل
الإقراض إلا من أجل الإقراض، فكأن الكلام أيقرض أحد الله فيضاعفه له، ونظير
هذا في الحمل على المعنى قراءة من قرأ من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم
[الأعراف: 186]
بجزم نذرهم، لما كان
معنى قوله فلا هادي له [الأعراف: 186] فلا يهد وهذه الأضعاف الكثيرة هي إلى
السبعمائة التي رويت ويعطيها مثال السنبلة، وقرأ ابن كثير «يبسط» بالسين،
ونافع بالصاد في المشهور عنه، وقال الحلواني عن قالون عن نافع: إنه لا
يبالي كيف قرأ بسطة ويبسط بالسين أو بالصاد، وروى أبو قرة عن نافع يبسط
بالسين، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسعر بسبب غلاء خيف
على المدينة، فقال: «إن الله هو الباسط القابض، وإني لأرجو أن ألقى الله
ولا يتبعني أحد بمظلمة في نفس ولا مال»). [المحرر الوجيز: 1/612-614]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله:
{من ذا الّذي يقرض اللّه قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً} يحثّ
تعالى عباده على الإنفاق في سبيله، وقد كرّر تعالى هذه الآية في كتابه
العزيز في غير موضعٍ. وفي حديث النّزول [أنّه يقول تعالى] "من يقرض غير
عديمٍ ولا ظلومٍ" وقد قال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا الحسن بن عرفة حدّثنا خلف
بن خليفة عن حميدٍ الأعرج عن عبد اللّه بن الحارث عن عبد اللّه بن مسعودٍ
قال: لمّا نزلت: {من ذا الّذي يقرض اللّه قرضًا حسنًا فيضاعفه له} قال أبو
الدّحداح الأنصاريّ: يا رسول اللّه وإنّ اللّه ليريد منّا القرض؟ قال: "نعم
يا أبا الدّحداح" قال: أرني يدك يا رسول اللّه. قال: فناوله يده قال:
فإنّي قد أقرضت ربّي حائطي. قال: وحائطٌ له فيه ستّمائة نخلةٍ وأمّ
الدّحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدّحداح فناداها: يا أمّ الدّحداح.
قالت: لبّيك قال: اخرجي فقد أقرضته ربّي عزّ وجلّ. وقد رواه ابن مردويه من
حديث عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعًا بنحوه.
وقوله: {قرضًا حسنًا} روي عن عمر وغيره من السّلف: هو النّفقة في سبيل اللّه. وقيل: هو النّفقة على العيال.
وقيل: هو التّسبيح
والتّقديس وقوله: {فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً} كما قال: {مثل الّذين ينفقون
أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبّةٍ أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلةٍ مائة
حبّةٍ} الآية [البقرة:261]. وسيأتي الكلام عليها.
وقال الإمام أحمد:
حدّثنا يزيد أخبرنا مبارك بن فضالة عن عليّ بن زيدٍ عن أبي عثمان النّهديّ،
قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنّه بلغني أنّك تقول: إنّ الحسنة تضاعف ألف
ألف حسنةٍ. فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النّبيّ صلّى اللّه عليه
وسلّم يقول: "إنّ اللّه يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنةٍ".
هذا حديثٌ غريبٌ، وعليّ بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتمٍ من وجهٍ آخر فقال:
حدّثنا أبو خلّادٍ
سليمان بن خلّادٍ المؤدّب، حدّثنا يونس بن محمّدٍ المؤدّب، حدّثنا محمّد بن
عقبة الرّباعيّ عن زيادٍ الجصّاص عن أبي عثمان النّهديّ، قال: لم يكن أحدٌ
أكثر مجالسةً لأبي هريرة منّي فقدم قبلي حاجًّا قال: وقدمت بعده فإذا أهل
البصرة يأثرون عنه أنّه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول:
إن اللّه يضاعف الحسنة ألف ألف حسنةٍ" فقلت: ويحكم، واللّه ما كان أحدٌ
أكثر مجالسةً لأبي هريرة منّي، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحمّلت أريد أنّ
ألحقه فوجدته قد انطلق حاجًّا فانطلقت إلى الحجّ أن ألقاه في هذا الحديث،
فلقيته لهذا فقلت: يا أبا هريرة ما حديثٌ سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال:
ما هو؟ قلت: زعموا أنّك تقول: إنّ اللّه يضاعف الحسنة ألف ألف حسنةٍ. قال:
يا أبا عثمان وما تعجب من ذا واللّه يقول: {من ذا الّذي يقرض اللّه قرضًا
حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً} ويقول: {فما متاع الحياة الدّنيا في
الآخرة إلا قليلٌ} [التّوبة:38] والّذي نفسي بيده لقد سمعت رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وسلّم يقول: "إنّ اللّه يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنةٍ".
وفي معنى هذا الحديث
ما رواه التّرمذيّ وغيره من طريق عمرو بن دينارٍ عن سالمٍ عن عبد اللّه بن
عمر بن الخطّاب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "من دخل سوقًا
من الأسواق فقال: لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ كتب اللّه له ألف ألف حسنةٍ ومحا عنه ألف ألف
سيّئةٍ" الحديث.
وقال ابن أبي حاتمٍ:
حدّثنا أبو زرعة حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسّامٍ حدّثنا أبو إسماعيل
المؤدّب، عن عيسى بن المسيب عن نافعٍ عن ابن عمر قال: لمّا نزلت {مثل
الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبّةٍ أنبتت سبع سنابل}
[البقرة:261] إلى آخرها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ربّ زد
أمّتي" فنزلت: {من ذا الّذي يقرض اللّه قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا
كثيرةً} قال: ربّ زد أمّتي. فنزل: {إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير
حسابٍ} [الزّمر:10]..
وروى ابن أبي حاتمٍ
أيضًا عن كعب الأحبار: أنّه جاءه رجلٌ فقال: إنّي سمعت رجلًا يقول: من قرأ:
{قل هو اللّه أحدٌ} [الإخلاص:1] مرّةً واحدةً بنى اللّه له عشرة آلاف ألف
غرفةٍ من درٍّ وياقوتٍ في الجنّة أفأصدق بذلك؟ قال: نعم، أو عجبت من ذلك؟
قال: نعم وعشرين ألف ألفٍ وثلاثين ألف ألفٍ وما يحصي ذلك إلّا اللّه ثمّ
قرأ {من ذا الّذي يقرض اللّه قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً}
فالكثير من اللّه لا يحصى.
وقوله: {واللّه يقبض
ويبسط} أي: أنفقوا ولا تبالوا فاللّه هو الرّزّاق يضيّق على من يشاء من
عباده في الرّزق ويوسّعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك {وإليه
ترجعون} أي: يوم القيامة). [تفسير ابن كثير: 1/662-664]
* للاستزادة ينظر: هنا