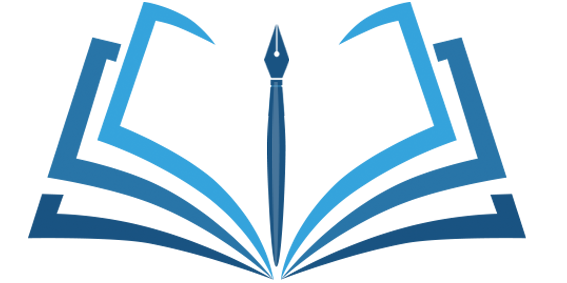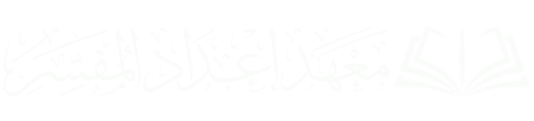تفسير سورة البقرة
القسم الثامن عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (246) إلى الآية (248) ]

تفسير سورة البقرة
القسم الثامن عشر
تفسير سورة البقرة [من الآية (246) إلى الآية (248) ]
17 Sep 2014
تفسير قول الله تعالى: {أَلَمْ
تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ
قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ
آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (248) }
تفسير
قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا
نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا
نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألّا تقاتلوا قالوا وما لنا ألّا نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلّا قليلا منهم واللّه عليم بالظّالمين}
{الملأ}: أشراف القوم ووجوههم، ويروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا من الأنصار وقد رجعوا من بدر يقول: ما قتلنا إلا عجائز ضلعا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أولئك الملاء من قريش، لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك))،
والملأ في اللغة: الخلق، يقال أحسنوا ملأكم، أي: أخلاقكم قال الشاعر:
تنادوا يآل بهثة إذ رأونا... فقلنا أحسني ملأ جهينا
أي: خلقا، ويقال: أحسني ممالأة أي معاونة، ويقال رجل مليء - مهموز - أي: بين الملآء يا هذا - وأصل هذا كله في اللغة من شيء واحد.
فالملأ الرؤساء إنما سمّوا بذلك لأنهم ملء بما يحتاج إليه منهم. والملأ الذي في الخلق، إنما هو الخلق المليء بما يحتاج إليه، والملا: المتسع من الأرض غير مهموز، يكتب بالألف - والياء في قول قوم - وأما البصريون فيكتبون بالألف، قال الشاعر في الملا المقصور الذي يدل على المتسع من الأرض:
ألا غنياني وارفعا الصوت بالملا... فإن الملا عندي يزيد المدى بعدا
وقوله عزّ وجلّ: {ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه}.
الجزم في {نقاتل في سبيل اللّه} الوجه على الجواب للمسألة الّتي في لفظ الأمر، أي: ابعث لنا - ملكا نقاتل، أي: إن تبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ومن قرأ " ملكا يقاتل " بالياء، فهو على صفة الملك ولكن نقاتل هو الوجه الذي عليه القراء، والرفع فيه بعيد، يجوز على معنى فإنا نقاتل في سبيل الله، وكثير من النّحوّيين، لا يجيز الرفع في نقاتل. -
وقوله عزّ وجلّ: {قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألّا تقاتلوا} أي: لعلكم أن تجبنبوا عن القتال،
وقرأ بعضهم: هل عسيتم بكسر السين إن كتب عليكم القتال، وهي قراءة نافع،
وأهل اللغة كلهم يقولون عسيت أن أفعل ويختارونه، وموضع {ألّا تقاتلوا} نصب أعني موضع " أن " لأن (أنّ) وما عملت فيه كالمصدر، إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت عسيت فعل ذلك.
وقوله عزّ وجلّ: {قالوا وما لنا ألّا نقاتل في سبيل اللّه}.
زعم - أبو الحسن الأخفش أن " أن " ههنا زائدة - قال: المعنى وما لنا لا نقاتل في سبيل اللّه،
وقال غيره: وما لنا في ألا نقاتل في سبيل اللّه وأسقط " في "
وقال بعض النحويين: إنما دخلت " أن" لأنّ " ما " معناه ما يمنعنا فلذلك دخلت " أن " لأن الكلام ما لك تفعل كذا وكذا.
والقول الصحيح عندي: أنّ " أن " لا تلغى ههنا، وأن المعنى وأي شي لنا في أن لا نقاتل في سبيل اللّه، أي: أي شيء لنا في ترك القتال.
{وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا}
ومعني{وأبنائنا}أي: سبيت ذرارينا.
ولكنّ " في " سقطت مع " أن " لأن الفعل مستعمل مع أن دالا على وقت معلوم،
فيجوز مع " أن " يحذف حرف الجر كما تقول: هربت أن أقول لك كذا وكذا، تريد هربت أن أقول لك كذا وكذا.
وقوله عزّ وجلّ؛ {تولّوا إلّا قليلا منهم}
{قليلا} منصوب على الاستثناء، فأما - من روى " تولوا إلا قليل منهم " فلا أعرف هذه القراءة، ولا لها عندي وجه، لأن المصحف على النصب والنحو يوجبها، لأن الاستثناء - إذا كان أول الكلام إيجابا - نحو قولك جاءني القوم إلا زيدا - فليس في زيد المستثنى إلا النصب - والمعنى تولوا أستثني قليلا منهم - وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روى " فشربوا منه إلا قليل منهم " وهذا عندي ما لا وجه له). [معاني القرآن: 1/325-327]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله
عز وجل: ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيٍّ لهم
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل اللّه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال
ألاّ تقاتلوا
هذه الآية خبر عن قوم
من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو، فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا
به، فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل، فنصرهم الله، وفي هذا كله مثال
للمؤمنين يحذر المكروه منه ويقتدى بالحسن، والملإ في هذه الآية جميع القوم،
لأن المعنى يقتضيه، وهذا هو أصل اللفظة.
ويسمى الأشراف الملأ
تشبيها، وقوله من بعد موسى معناه من بعد موته وانقضاء مدته، واختلف
المتأولون في النبي الذي قيل له ابعث، فقال ابن إسحاق وغيره عن وهب بن
منبه: هو سمويل بن بالي.
وقال السدي: هو شمعون وقال قتادة: هو يوشع بن نون.
قال القاضي أبو محمد
رحمه الله: وهذا قول ضعيف، لأن مدة داود هي بعد مدة موسى بقرون من الناس،
ويوشع هو فتى موسى، وكانت بنو إسرائيل تغلب من حاربها، وروي أنها كانت تضع
التابوت الذي فيه السكينة والبقية في مأزق الحرب، فلا تزال تغلب حتى عصوا
وظهرت فيهم الأحداث. وخالف ملوكهم الأنبياء، واتبعوا الشهوات، وقد كان الله
تعالى أقام أمورهم بأن يكون أنبياؤهم يسددون ملوكهم، فلما فعلوا ما ذكرناه
سلط الله عليهم أمما من الكفرة فغلبوهم وأخذ لهم التابوت في بعض الحروب
فذل أمرهم. وقال السدي: «كان الغالب لهم جالوت وهو من العمالقة، فلما رأوا
أنه الاصطلام وذهاب الذكر أنف بعضهم وتكلموا في أمرهم. حتى اجتمع ملأهم على
أن قالوا لنبي الوقت: ابعث لنا ملكاً الآية، وإنما طلبوا ملكا يقوم بأمر
القتال، وكانت المملكة في سبط من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: «بنو يهوذا»،
فعلم النبي بالوحي أنه ليس في بيت المملكة من يقوم بأمر الحرب، ويسر الله
لذلك طالوت.
وقرأ جمهور الناس
«نقاتل» بالنون وجزم اللام على جواب الأمر، وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة
«يقاتل» بالياء ورفع الفعل، فهو في موضع الصفة للملك. وأراد النبي المذكور
عليه السلام أن يتوثق منهم فوقفهم على جهة التقرير وسبر ما عندهم بقوله هل
عسيتم وقرأ نافع «عسيتم» بكسر العين في الموضعين، وفتح الباقون السين، قال
أبو علي: «الأكثر فتح السين وهو المشهور»، ووجه الكسر قول العرب هو عس بذلك
مثل حر وشج، وقد جاء فعل وفعل في نحو نقم ونقم، فكذلك عسيت وعسيت، فإن
أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال عسي زيد مثل رضي، فإن قيل فهو
القياس، وإن لم يقل فسائغ أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع الأخرى
كما فعل ذلك في غيره، ومعنى هذه المقالة:
هل أنتم قريب من التولي والفرار. إن كتب عليكم القتال؟.
قوله عز وجل: ......
قالوا وما لنا ألاّ نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلاّ قليلاً منهم واللّه عليمٌ بالظّالمين
(246)
المعنى وأي شيء
يجعلنا ألا نقاتل وقد وترنا وأخرجنا من ديارنا؟ وقالوا هذه المقالة وإن كان
القائل لم يخرج من حيث قد أخرج من هو مثله وفي حكمه، ثم أخبر الله تعالى
عنهم أنهم لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة
الحرب تولوا، أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم المتنعمة
المائلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت
لطبعها، وعن هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا تتمنوا
لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا»، ثم أخبر الله
تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى واستمرت عزيمتهم على
القتال في سبيل الله، ثم توعد الظالمين في لفظ الخبر الذي هو قوله واللّه
عليمٌ بالظّالمين، وقرأ أبي بن كعب «تولوا إلا أن يكون قليل منهم»). [المحرر الوجيز: 1/614-616]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({ألم
تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيٍّ لهم ابعث لنا
ملكًا نقاتل في سبيل اللّه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلا منهم واللّه عليمٌ بالظّالمين
(246)}
قال عبد الرّزّاق عن
معمر عن قتادة: هذا النّبيّ هو يوشع بن نون. قال ابن جريرٍ: يعني ابن
أفراثيم بن يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيدٌ؛ لأنّ هذا كان بعد موسى بدهر
طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السّلام، كما هو مصرّحٌ به في القصّة وقد
كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنةٍ واللّه أعلم.
وقال السّدّيّ: هو
شمعون وقال مجاهدٌ: هو شمويل عليه السّلام. وكذا قال محمّد بن إسحاق عن وهب
بن منبّهٍ وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن إليهو بن تهو بن صوف
بن علقمة بن ماحث بن عمرصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن أبي ياسف بن
قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه
السّلام.
وقال وهب بن منبّهٍ
وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السّلام على طريق الاستقامة مدّة
الزّمان، ثمّ أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من
الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التّوراة
إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلّط اللّه عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلةً
عظيمةً، وأسروا خلقًا كثيرًا وأخذوا منهم بلادًا كثيرةً، ولم يكن أحدٌ
يقاتلهم إلّا غلبوه وذلك أنّهم كان عندهم التّوراة والتّابوت الّذي كان في
قديم الزّمان وكان ذلك موروثًا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه
الصّلاة والسّلام فلم يزل بهم تماديهم على الضّلال حتّى استلبه منهم بعض
الملوك في بعض الحروب وأخذ التّوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلّا
القليل وانقطعت النّبوّة من أسباطهم ولم يبق من سبط لاوي الّذي يكون فيه
الأنبياء إلّا امرأةٌ حاملٌ من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها في بيتٍ
واحتفظوا بها لعلّ اللّه يرزقها غلامًا يكون نبيًّا لهم ولم تزل [تلك]
المرأة تدعو اللّه عزّ وجلّ أن يرزقها غلامًا فسمع اللّه لها ووهبها
غلامًا، فسمّته شمويل: أي: سمع اللّه. ومنهم من يقول: شمعون وهو بمعناه
فشبّ ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته اللّه نباتًا حسنًا فلمّا بلغ سنّ
الأنبياء أوحى اللّه إليه وأمره بالدّعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل
فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكًا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضًا قد باد
فيهم فقال لهم النّبيّ: فهل عسيتم إن أقام اللّه لكم ملكًا ألّا تفوا بما
التزمتم من القتال معه {قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا
من ديارنا وأبنائنا} أي: وقد أخذت منّا البلاد وسبيت الأولاد؟ قال اللّه
تعالى: {فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلا منهم واللّه عليمٌ
بالظّالمين} أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم واللّه عليمٌ
بهم). [تفسير ابن كثير: 1/664-665]
تفسير قوله تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ:{وقال لهم نبيّهم إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إنّ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم}أي: قد أجابكم إلى ما سألتم. من بعث ملك يقاتل، وتقاتلون معه وطالوت وجالوت وداود. لا تنصرف لأنها أسماء أعجمية، وهي معارف فاجتمع فيها شيئان - التعريف والعجمة، وأما جاموس فلو سميت به رجلا لانصرف، وإن كان عجميا لأنه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام، فتقول الجاموس والراقود.
فعلى هذا (قياس جميع) الباب.
وقوله عزّ وجلّ: {أنّى يكون له الملك علينا} أي: من أي جهة يكون ذلك.
{ولم يؤت سعة من المال}أي: لم يؤت ما تتملّك به الملوك.
فأعلمهم اللّه أنه {اصطفاه} ومعناه: اختاره، وهو " افتعل " من الصفوة.
والأصل: اصتفاه فالتاء إذا وقعت بعد الصاد أبدلت طاء لأن التاء من مخرج الطاء، والطاء مطبقة، كما أن الصاد مطبقة، فأبدلوا الطاء من التاء، ليسهل النطق بما بعد الصاد، وكذلك افتعل من الضرب: اضطرب، ومن الظلم اظطلم، ويجوز في اظطلم وجهان آخران:
1- يجوز اطّلم بطاء مشددة غير معجمة
2- واظّلم بظاء مشددة قال زهير:
هو الجواد الذي يعطيك نائله... عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم
و " فيطّلم " و " فيظّلم ".
أعلمهم الله أنه اختاره، وأنه قد زيد في العلم والجسم بسطة، وأعلمهم أن العلم أهو، الذي به يجب أن يقع الاختيار ليس أن اللّه - جلّ وعزّ -:
لا يملك إلا ذا مال، وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يهب به العدو، وأعلمهم أنه يؤتي ملكه من يشاء، وهو جلّ وعزّ لا يشاء إلا ما هو الحكمة والعدل.
وقوله عزّ وجلّ: {واللّه واسع عليم}أي: يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة). [معاني القرآن: 1/327-329]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: وقال لهم نبيّهم إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال قال إنّ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والجسمقال وهب بن منبه: «إنه لما قال الملأ من بني إسرائيل لسمويل بن بالي ما قالوا، سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا ويدله عليه، فقال الله تعالى له: انظر إلى القرن الذي فيه الدهن في بيتك، فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل، فادهن رأسه منه وملكه عليهم، قال: وكان طالوت رجلا دباغا، وكان من سبط بنيامين بن يعقوب، وكان سبطا لا نبوة فيه ولا ملك، فخرج طالوت في بغاء دابة له أضلها، فقصد سمويل عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو يجد عنده فرجا، فنش الدهن».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهو دهن القدس فيما يزعمون، قال: فقام إليه سمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت، وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله بتقديمه، ثم قال لبني إسرائيل «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا»، وطالوت اسم أعجمي معرب ولذلك لم ينصرف، وقال السدي: «إن الله أرسل إلى شمعون عصا وقال له: من دخل عليك من بني إسرائيل فكان على طول هذه العصا فهو ملكهم، فقيس بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم حتى مربهم طالوت في بغاء حماره الذي كان يسقي عليه، وكان رجلا سقاء، فدعوه فقاسوه بالعصا فكان مثلها، فقال لهم نبيهم ما قال،
[المحرر الوجيز: 2/5]
ثم إن بني إسرائيل تعنتوا وحادوا عن أمر الله تعالى، وجروا على سننهم فقالوا: أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه، أي لأنه ليس في بيت ملك ولا سبقت له فيه سابقة. ولم يؤت مالا واسعا يجمع به نفوس الرجال حتى يغلب أهل الأنفة بماله.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وترك القوم السبب الأقوى وهو قدر الله وقضاؤه السابق، وأنه مالك الملك، فاحتج عليهم نبيهم عليه السلام بالحجة القاطعة، وبيّن لهم مع ذلك تعليل اصطفائه طالوت، وأنه زاده بسطة في العلم وهو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء، قال ابن عباس: «كان في بني إسرائيل سبطان أحدهما للنبوة والآخر للملك، فلا يبعث نبي إلا من الواحد ولا ملك إلا من الآخر، فلما بعث طالوت من غير ذلك قالوا مقالتهم»، قال مجاهد: معنى الملك في هذه الآية الإمرة على الجيش.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولكنهم قلقوا لأن من عادة من تولى الحرب وغلب أن يستمر ملكا، و «اصطفى» افتعل، مأخوذ من الصفوة، وقرأ نافع «بصطة» بالصاد، وقرأ أبو عمرو وابن كثير «بسطة» بالسين، والجمهور على أن العلم في هذه الآية يراد به العموم في المعارف، وقال بعض المتأولين: المراد علم الحرب، وأما جسمه فقال وهب بن منبه: إن أطول رجل في بني إسرائيل كان يبلغ منكب طالوت.
قوله عز وجل: ... واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسعٌ عليمٌ (247) وقال لهم نبيّهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التّابوت
لما علم نبيهم عليه السلام تعنتهم وجدالهم في الحجج تمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه، وهو قوله: واللّه يؤتي ملكه من يشاء، وظاهر اللفظ أنه من قول النبي لهم، وقد ذهب بعض المتأولين إلى أنه من قول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وأضيف ملك الدنيا إلى الله تعالى، إضافة مملوك إلى مالك، وواسعٌ معناه وسعت قدرته وعلمه كل شيء). [المحرر الوجيز: 2/5-7]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({وقال لهم نبيّهم إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكًا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال قال إنّ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسعٌ عليمٌ (247)}
أي: لمّا طلبوا من نبيّهم أن يعيّن لهم ملكًا منهم فعيّن لهم طالوت وكان رجلًا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ لأنّ الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السّبط فلهذا قالوا: {أنّى يكون له الملك علينا} أي: كيف يكون ملكًا علينا {ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال} أي: ثمّ هو مع هذا فقيرٌ لا مال له يقوم بالملك، وقد ذكر بعضهم أنّه كان سقّاءً وقيل: دبّاغًا. وهذا اعتراضٌ منهم على نبيّهم وتعنّتٌ وكان الأولى بهم طاعةً وقول معروفٍ ثمّ قد أجابهم النّبيّ قائلًا {إنّ اللّه اصطفاه عليكم} أي: اختاره لكم من بينكم واللّه أعلم به منكم. يقول: لست أنا الّذي عيّنته من تلقاء نفسي بل اللّه أمرني به لمّا طلبتم منّي ذلك {وزاده بسطةً في العلم والجسم} أي: وهو مع هذا أعلم منكم، وأنبل وأشكل منكم وأشدّ قوّةً وصبرًا في الحرب ومعرفةً بها أي: أتمّ علمًا وقامةً منكم. ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علمٍ وشكلٍ حسنٍ وقوّةٍ شديدةٍ في بدنه ونفسه ثمّ قال: {واللّه يؤتي ملكه من يشاء} أي: هو الحاكم الّذي ما شاء فعل ولا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون لعلمه [وحكمته] ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: {واللّه واسعٌ عليمٌ} أي: هو واسع الفضل يختصّ برحمته من يشاء عليمٌ بمن يستحقّ الملك ممّن لا يستحقّه). [تفسير ابن كثير: 1/666]
تفسير قوله تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {وقال لهم نبيّهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التّابوت فيه سكينة من ربّكم وبقيّة ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين}أي: علامة تمليك اللّه إياه {أن يأتيكم التّابوت}.
وموضع (أن) رفع المعنى: إن آية ملكه إتيان التابوت أتاكم.
وقوله عزّ وجلّ: {فيه سكينة من ربّكم}أي: فيه ما تسكنون به إذا أتاكم، وقيل في التفسير إن السكينة لها رأس كرأس الهر من زبرجد أو ياقوت، ولها جناحان.
وقوله عزّ وجلّ: {وبقيّة ممّا ترك آل موسى وآل هارون}.
قيل في تفسيره: البقية رضاض الألواح وأن التوراة فيه وكتاب آخر جمع التوراة وعصا موسى. فهذا ما روي مما فيه، والظاهر، أن فيه (بقية) جائز أن يكون بقية من شيء من علامات الأنبياء، وجائز أن يكون البقية من العلم، وجائز أن يتضمنها جميعا.
والفائدة - كانت - في هذا التابوت أن الأنبياء - صلوات اللّه عليهم - كانت تستفتح به في الحروب، فكان التابوت يكون بين أيديهم فإذا سمع من جوفه أنين دف التابوت أي سار والجميع خلفه - واللّه أعلم بحقيقة ذلك.
وروي في التفسير: أنه كان من خشب الشمشار وكان قد غلب جالوت وأصحابه عليه فنزلهم بسببه داء، قيل هو الناسور الذي يكون في العنب فعلموا أن الآفة بسببه نزلت، فوضعوه على ثورين فيما يقال،
وقيل معنى {تحمله الملائكة}: إنها كانت تسوق الثورين.
وجائز أن يقال في اللغة: تحمله الملائكة، وإنما كانت تسوق ما يحمله، كما تقول حملت متاعي إلى مكة، أي كنت سببا لحمله إلى مكة.
ومعنى {إنّ في ذلك لآية لكم}أي: في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله ملك طالوت عليكم إذ أنبأكم في قصته بغيب.
{إن كنتم مؤمنين}أي: إن كنتم مصدقين). [معاني القرآن: 1/329-330]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وأما قول النبي لهم: إنّ آية ملكه فإن الطبري ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنتوا وقالوا لنبيهم: وما آية ملك طالوت؟ وذلك على جهة سؤال الدلالة على صدقه في قوله إن الله قد بعث.قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويحتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على جهة التغبيط والتنبيه على هذه النعمة التي قرنها الله بملك طالوت وجعلها آية له دون أن تعن بنو إسرائيل لتكذيب نبيهم، وهذا عندي أظهر من لفظ الآية، وتأويل الطبري أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة، فإنهم أهل تكذيب وتعنت واعوجاج، وقد حكى الطبري معناه عن ابن عباس وابن زيد والسدي.
واختلف المفسرون في كيفية إتيان التّابوت وكيف كان بدء أمره، فقال وهب بن منبه: كان التابوت عند بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت، وصار التابوت عند القوم الذين غلبوا، فوضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام، فكانت الأصنام تصبح منكسة، فجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم، وقيل: جعل في مخراة قوم فكانوا يصيبهم الناسور، فلما عظم بلاؤهم كيف كان، قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت فلنرده إلى بلاد بني إسرائيل، فأخذوا عجلة فجعلوا التابوت عليها وربطوها ببقرتين فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل، فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا به على بني إسرائيل، وهم في أمر طالوت، فأيقنوا بالنصر. وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. وقال قتادة والربيع: بل كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع بن نون، فجعله يوشع في البرية، ومرت عليه الدهور حتى جاء وقت طالوت. وكان أمر التابوت مشهورا عندهم في تركة موسى، فجعل الله الإتيان به آية لملك طالوت، وبعث الله ملائكة حملته إلى بني إسرائيل، فيروى أنهم رأوا التابوت في الهواء يأتي حتى نزل بينهم، وروي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في دار طالوت، فاستوسقت بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت، وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين، وقرأ زيد بن ثابت «التابوه»، وهي لغته، والناس على قراءته بالتاء.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وكثر الرواة في قصص التابوت وصورة حمله بما لم أر لإثباته وجها للين إسناده.
قوله عز وجل: ... فيه سكينةٌ من ربّكم وبقيّةٌ ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إنّ في ذلك لآيةً لكم إن كنتم مؤمنين (248)
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وروي عنه أنه قال: هي ريح خجوج ولها رأسان، وقال مجاهد: السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان وذنب، وقال:
أقبلت السكينة والصرد وجبريل مع إبراهيم من الشام. وقال وهب بن منبه عن بعض علماء بني إسرائيل:
السكينة رأس هرة ميتة كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ الهر أيقنوا بالنصر. وقال ابن عباس: السكينة طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء، وقاله السدي. وقال وهب بن منبه: السكينة روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء أخبرهم ببيان ما يريدون. وقال عطاء بن أبي رباح: السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها. وقال الربيع بن أنس: سكينةٌ من ربّكم أي رحمة من ربكم، وقال قتادة:
سكينةٌ من ربّكم أي وقار لكم من ربكم.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى، فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده، والسكينة على هذا فعيلة مأخوذة من السكون، كما يقال عزم عزيمة وقطع قطيعة.
واختلف المفسرون في البقية ما هي؟: فقال ابن عباس: هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقال الربيع: هي عصا موسى وأمور من التوراة. وقال عكرمة: هي التوراة والعصا ورضاض الألواح.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هذا ما روي من أن موسى عليه السلام لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل ألقى الألواح غضبا فتكسرت. فنزع منها ما بقي صحيحا وأخذ رضاض ما تكسر فجعل في التابوت. وقال أبو صالح: البقية عصا موسى وعصا هارون ولوحان من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض الألواح. وقال الثوري: من الناس من يقول البقية قفيز منّ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصا والنعلان. وقال الضحّاك: البقية الجهاد وقتال الأعداء.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: أي الأمر بذلك في التابوت، إما أنه مكتوب فيه، وإما أن نفس الإتيان به هو كالأمر بذلك، وأسند الترك إلى آل موسى وهارون من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى قوم، وكلهم آل لموسى وهارون، وآل الرجل قرابته وأتباعه، وقال ابن عباس والسدي وابن زيد: حمل الملائكة هو سوقها التابوت دون شيء يحمله سواها حتى وضعته بين يدي بني إسرائيل وهم ينظرون إليه بين السماء والأرض، وقال وهب بن منبه والثوري عن بعض أشياخهم: حملها إياه هو سوقها الثورين أو البقرتين اللتين جرتا العجلة به، ثم قرر تعالى أن مجيء التابوت آية لهم إن كانوا ممن يؤمن ويبصر بعين حقيقة). [المحرر الوجيز: 2/7-10]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({وقال لهم نبيّهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التّابوت فيه سكينةٌ من ربّكم وبقيّةٌ ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إنّ في ذلك لآيةً لكم إن كنتم مؤمنين (248)}
يقول نبيّهم لهم: إنّ علّامة بركة ملك طالوت عليكم أن يردّ اللّه عليكم التّابوت الّذي كان أخذ منكم.
{فيه سكينةٌ من ربّكم} قيل: معناه فيه وقارٌ، وجلالةٌ.
قال عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة {فيه سكينةٌ} أي: وقارٌ. وقال الرّبيع: رحمةٌ. وكذا روي عن العوفيّ عن ابن عبّاسٍ وقال ابن جريجٍ: سألت عطاءً عن قوله: {فيه سكينةٌ [من ربّكم]} قال: ما يعرفون من آيات اللّه فيسكنون إليه.
وقيل: السّكينة طستٌ من ذهبٍ كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء، أعطاها اللّه موسى عليه السّلام فوضع فيها الألواح. ورواه السّدّيّ عن أبي مالكٍ عن ابن عبّاسٍ.
وقال سفيان الثّوريّ: عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عليٍّ قال: السّكينة لها وجهٌ كوجه الإنسان ثمّ هي روحٌ هفّافةٌ.
وقال ابن جريرٍ: حدّثني [ابن] المثنّى حدّثنا أبو داود حدّثنا شعبة وحمّاد بن سلمة، وأبو الأحوص كلّهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن عليٍّ قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان.
وقال مجاهدٌ: لها جناحان وذنبٌ. وقال محمّد بن إسحاق عن وهب بن منبّهٍ: السّكينة رأس هرّةٍ ميّتةٍ إذا صرخت في التّابوت بصراخ هرٍّ، أيقنوا بالنّصر وجاءهم الفتح.
وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا بكّار بن عبد اللّه أنّه سمع وهب بن منبّهٍ يقول: السّكينة روحٌ من اللّه تتكلّم إذا اختلفوا في شيءٍ تكلّم فأخبرهم ببيان ما يريدون.
وقوله: {وبقيّةٌ ممّا ترك آل موسى وآل هارون} قال ابن جريرٍ: أخبرنا ابن المثنّى حدّثنا أبو الوليد حدّثنا حمّادٌ عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ في هذه الآية: {وبقيّةٌ ممّا ترك آل موسى وآل هارون} قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة والسّدّيّ والرّبيع بن أنسٍ وعكرمة وزاد: والتّوراة.
وقال أبو صالحٍ {وبقيّةٌ} يعني: عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التّوراة والمنّ.
وقال عطيّة بن سعدٍ: عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح.
وقال عبد الرّزّاق: سألت الثّوريّ عن قوله: {وبقيّةٌ ممّا ترك آل موسى وآل هارون} فقال: منهم من يقول قفيزٌ من منٍّ، ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصا والنّعلان.
وقوله: {تحمله الملائكة} قال ابن جريجٍ: قال ابن عبّاسٍ: جاءت الملائكة تحمل التّابوت بين السّماء والأرض حتّى وضعته بين يدي طالوت، والنّاس ينظرون.
وقال السّدّيّ: أصبح التّابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوّة شمعون وأطاعوا طالوت.
وقال عبد الرّزّاق عن الثّوريّ عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلةٍ على بقرةٍ وقيل: على بقرتين.
وذكر غيره أنّ التّابوت كان بأريحا وكان المشركون لمّا أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير، فأصبح التّابوت على رأس الصّنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمّروه تحته فأصبح الصّنم مكسور القوائم ملقًى بعيدًا، فعلموا أنّ هذا أمرٌ من اللّه لا قبل لهم به فأخرجوا التّابوت من بلدهم، فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها داءً في رقابهم فأمرتهم جاريةٌ من سبي بني إسرائيل أنّ يردّوه إلى بني إسرائيل حتّى يخلّصوا من هذا الدّاء، فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحدٌ إلّا مات، حتّى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النّيّرين ورجعتا وجاء بنو إسرائيل فأخذوه فقيل: إنّه تسلّمه داود عليه السّلام وأنّه لمّا قام إليهما حجل من فرحه بذلك. وقيل: شابّان منهم فاللّه أعلم. وقيل: كان التّابوت بقريةٍ من قرى فلسطين يقال لها: أزدرد.
وقوله: {إنّ في ذلك لآيةً لكم} أي: على صدقي فيما جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت: {إن كنتم مؤمنين} أي: باللّه واليوم الآخر). [تفسير ابن كثير: 1/666-668]
* للاستزادة ينظر: هنا