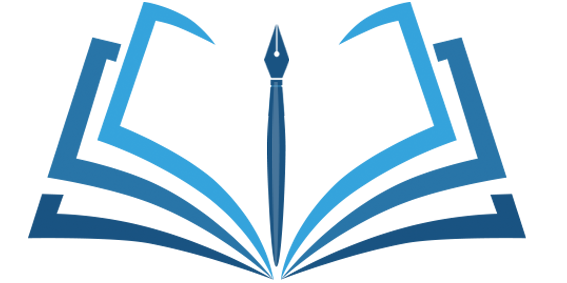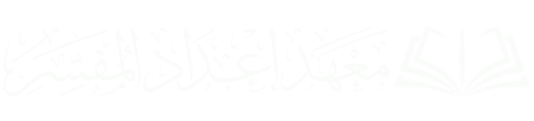أصول التفسير البياني
القسم الأول
الدرس الثالث: دلالة المراد بالمفردات

أصول التفسير البياني
القسم الأول
الدرس الثالث: دلالة المراد بالمفردات
2 May 2020
الدرس الثالث: دلالة المراد بالمفردات
عناصر الدرس:
● دلالة المراد بالمفردات في الآية.
- المثال الأول: المراد بالذكر في قول الله تعالى: {ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب}.
- المثال الثاني: المراد بأسفل سافلين في قول الله تعالى: {ثمّ رددناه أسفل سافلين}.
- المثال الثالث: المراد بالوالد والولد في قول الله تعالى: {ووالدٍ وما ولد}.
● أمثلة من أقوال المفسّرين في بيان المراد ببعض المفردات القرآنية:
-
المثال الأول: المراد بالقلب السليم في قول الله تعالى: {يَوْمَ لَا
يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ (89)}.
-
المثال الثاني: المراد بالأمانة في قول الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)}.
- المثال الثالث: المراد بالشاهد والمشهود في قول الله تعالى: {وشاهدٍ ومشهود}.
● التطبيقات.
عبد العزيز بن داخل المطيري
دلالة المراد بالمفردات في الآية
من
الدلالات التي عني بها المفسّرون عناية بالغة دلالة المراد بالمفردات
القرآنية، وقد تكون المفردة ليست معدودة من المفردات الغريبة أو التي تدلّ
بالوضع اللغوي على معانٍ متعددة، لكنّها تحمل معنى عاماً يحتمل مُراداتٍ عدة؛ بدلالة النص أو أقوال السلف أو السياق.
وتأمُّل المعاني التي تحتملها المفردات في الآية، ويصلح أن تفسّر بها،
يفتح للمتدبّر باباً عظيم النفع من أبواب فهم القرآن، ويزيل عنه إشكالات
قد ترد على بعض أقوال المفسرين.
والفرق
بين مسائل هذا الدرس ومسائل الدرس السابق أنّ المفردات في الدرس السابق
تدلّ بوضعها اللغوي على معانٍ متعددة، ومسائل هذا الدرس لا تعرف دلالة
المفردات على المعاني المفسّرة بها بالوضع اللغوي أصالة، وإنما باستجلاء
المراد بها بما تقدّكم ذكرُه.
وسأذكر أمثلة توضّح المعنى باختصار يكفي عن الشرح الكثير بإذن الله.
عبد العزيز بن داخل المطيري
لفظ الذكر عامّ يحتمل أن يُراد به في هذه الآية معانٍ متعددة لا تعارض بينها، ولذلك اختلف المفسرون في المراد بالذكر في هذه الآية على أقوال:
فقيل: الذكر: هو القرآن.
وقيل: الذكر هو ذكر العبد ربَّه بلسانه.
وقيل: الذكر هو ذكر العبد ربَّه في نفسه.
وقيل: الذكر هو التذكر الذي ينتفع به العبد من تفكره في آيات الله ومخلوقاته.
وكل هذه المعاني صحيحة، وهي من مدلول معنى ذكر الله جلَّ وعلا، وبها تحصل طمأنينة القلب.
عبد العزيز بن داخل المطيري
التقويم هو التعديل، يقال: قوّمت الشيء إذا عدّلته، وهو وصف يصلح للأمور الحسية والمعنوية:
فالأول: تعديل خلقة الإنسان وجعله منتصب القامة سميعاً بصيراً عاقلاً، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7)}
{فعدلك} قرئت بالتشديد والتخفيف، وهما قراءتان صحيحتان.
والثاني: تقويمه بخلقه على فطرة التوحيد والإيمان بالله، كما قال الله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} فأمر أن يقيم وجهه مخلصاً لله كما أقام الله فطرته على الدين القويم.
وقول الله تعالى: {ثمّ رددناه أسفل سافلين}
يصدق هذا الردّ على معانٍ:
أحدها: ردّ الجسد بعد اعتدال خلقته إلى أرذل العمر، وهو قول ابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، وقتادة.
ووجهه: أنّ التقدّم في العمر بعد تناهي الخلقة واعتدالها ينتهي بالعبد إلى غاية الضعف والوهن، وأرذل العمر هو أسفل مراحل حياته الدنيوية وأدناها، ليس بعده إلا الفناء.
كما قال النمر بن تولب في وصف المشيب وما يقاسيه الكبير:
يودّ الفتى طول السلامة والغنى ... فكيف يرى طولُ السلامة يفعل
يُردّ الفتى بعد اعتدال وصحّة ... ينوءُ إذا رام القيام ويُحمل
والمعنى الثاني: النار، وهو قول أبي العالية الرياحي، ومجاهد، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
والنار هي أسفل موضع يردّ إليه الإنسان مطلقاً.
والمعنى الثالث: الضلال، وهذا القول ذكره أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة، وقال بموجبه ابن عاشور في تفسيره وشرحه شرحاً حسناً.
وهذه الأقوال تتكامل ولا تتعارض، وتدلّ بمعانيها وبديع تركيبها على
الإحكام البليغ لهذه السورة الجليلة التي جعلها الله من دلائل إحكامه
لكتابه؛ إذ ختمها بقوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين}
فالمعنى الأول في المراد بأسفل سافلين مقابلٌ لما في ذكر في الآية التي قبلها: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} باعتبار أن التقويم هو اعتدال خلقة الإنسان.
كما قال تعالى: { وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) } ، وقال تعالى: { ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً}.
فيكون استثناء المؤمنين على هذا القول في قوله تعالى: { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)} استثناءً حُكميّاً يقوم مقام الاستثناء الحقيقي.
وذلك أنّ المؤمن إذا بلغ به الكبر مبلغاً ضعفت فيه قواه وكلّ ذهنه فلم
يعد يقوى على ما كان يعمل؛ فإنه يجرى له مثل ما كان يعمل وهو صحيح
كرامةً من الله تعالى للمؤمن، فلا ينقص أجره ولا ينقطع، ومن كان هذا حاله
فلا يصحّ وصف ما هو فيه من الكبر بالسفل، بل هو في علوّ بما يجري له من
الأعمال الصالحة التي ترتفع بها درجاته.
فهو وإن كان جسده آخذا في الضعف لكبر سنّه وشيخوخته إلا أنّ حاله آخذٌ في الارتفاع والترقي.
وهذا بخلاف الكافر الذي ليس له من الإيمان والعمل الصالح ما يرتفع به؛
فإذا خارت قواه من الكبر سفل حاله حتى يصير إلى أسفل سافلين في هذه
الحياة.
فإن مات ردّ إلى أسفل سافلين في النار والعياذ بالله؛ فأصحاب النار هم أسافل الخلق.
وعلى ذلك فلا يصحّ اعتراض من يقول: نرى من الكفار من يموت وهو شابّ، ومن المؤمنين من يردّ إلى أرذل العمر.
لأن من أثار الإشكال ظنّ أن اللفظ المفسَّر به يقوم مقام اللفظ المفسَّر، فكان تقدير الكلام عنده: ثم رددناه إلى أرذل العمر
ولفظ "أرذل العمر" لفظ منقسم فمنه ما هو داخل في معنى الآية وهو ما
يخصّ الكفار ، ومنه ما لا يدخل في معنى الآية وهو ما يخصّ المؤمنين.
لكن التفسير مبني على تقريب المعنى؛ فإذا ما عُرف المعنى استبان للناظر ما يدخل في معنى الآية مما لا يدخل.
فهذا وجه، ووجه آخر: أن الكافر مردود إلى
أسفل سافلين لا مناص له من ذلك؛ فإن لم يردّ في الدنيا إلى أرذلِ العمر؛
فهو مردود في دينه إلى أسفل سافلين، ومردود في الآخرة إلى النار والعياذ
بالله.
وأما المؤمن فلا يسفل بأيّ حال من الأحوال؛ بل هو في علوّ وعزّة قد
كتبهما الله لأهل الإيمان، فإنْ ضعف جسده لهرمٍ أو مرض لم ينقص عملُه ولم
تنحطّ درجته عند الله لذلك.
وأما المعنى الثالث وهو أن الرد إلى أسفل سافلين أي إلى الضلال بعد الهدى، فهو كما في قول الله تعالى: {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات}.
وهذا القول له وجهه، وهو أنّ الإنسان قد خلقه الله في أحسن تقويم على
الفطرة الصحيحة القويمة، ثم إنه من حين تكليفه فهو إمّا مؤمن آخذ في طريق
العلوّ والعزة، وإما كافر آخذ في طريق السفل والباطل حتى يبلغ أسفل
سافلين.
وكلّ دين غير دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده فهو دين سافل من وضع
البشر؛ فدين الله تعالى أعلى الأديان، قد أظهره الله تعالى على الدين
كلّه، وكلّ دين سوى الإسلام فهو أسفل منه، بل الكفار أسفل حالاً من
الحيوانات البهيمة ومن الجمادات؛ فهم شرّ البرية، وهم أسفل السافلين في
دينهم وأحوالهم.
وهذا وصف لا مناص للكفار منه ما داموا مقيمين على كفرهم، {ذلك بأن الله هو الحقّ وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل وأنّ الله هو العلي الكبير}
فالله تعالى هو العليّ بذاته، ودينه أعلى الأديان، وعباده المؤمنون هم الأعلون، كما قال الله تعالى: {وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} وهذا يدلّ بمفهوم المخالفة على أنّ الكفار هم الأسفلون.
والمقصود من هذا المثال أن كلمة "أسفل سافلين" دلّت على معانٍ عظيمة
ووصفت أحوالاً جسيمة، وعواقب وخيمة لأهل الكفر، وهي لم تدلّ بوضعها اللغوي
على أرذل العمر ولا على النار ولا على الضلال؛ لكنها وصف يحتمل هذه
المعاني.
والمعاني التي تحتملها المفردات يجتهد المفسّر في تعيين المراد منها،
فقد يصحّ أن يُراد بها معنى واحد وقد يصحّ أن يُراد بها أكثر من معنى.
وإذا أمكن الجمع بين المعاني التي تحتملها المفردة، وكان لكل معنى وجهه الصحيح تعيّن الأخذ بالمعاني كلها.
وتكملةً للفائدة فإنّ هذه السورة المحكمة تضمنت أمثلة أخرى على هذا النسق:
فقوله تعالى:{ممنون} له معنيان في اللغة: الانقطاع والنقص، ولكل معنى شواهده المبثوثة في كتب اللغة، وقد قال بكل معنى منهما جماعة من المفسرين.
ومعنى الآية يحتملهما من غير تعارض؛ فهو أجرٌ غير مقطوع ولا منقوص، بل هو دائمٌ لا ينقضي، ووافرٌ لا ينقص.
لكن مفردة {ممنون} تدلّ على المعنيين بالوضع اللغوي فهي من نظائر الأمثلة المذكورة في الدرس السابق.
وقول الله تعالى:{أليس الله بأحكم الحاكمين} يجمع معانٍ جليلة فهو أحكمُ حُكْماً، وأحكم حكمةً، وأحكم إحكاماً في خلقه وأمره.
فانظر كيف دلّت هذه السورة المحكمة على معانٍ كثيرة بديعة بألفاظ وجيزة في غاية الإحكام في المفردات والتركيب.
عبد العزيز بن داخل المطيري
اختلف المفسرون في المراد بالوالد وما ولد على أقوال:
القول الأول: الوالد: آدم، وما ولد: ذريته، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وأبي صالح مولى أمّ هانئ، والضحاك، وسفيان الثوري.
القول الثاني: الوالد أي الذي يلد ، وما ولد: العاقر الذي لا يولد له، وهو رواية عن ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير.
القول الثالث: الوالد إبراهيم عليه السلام، وهو قول أبي عمران الجوني.
القول الرابع: الوالد اسم جنس فيعمّ كلّ والدٍ من إنس وجنّ وحيوان وما ولد ، الإتيان بما فيه إشارة إلى العموم ليعمّ العاقل وغير العاقل.
وهذا القول الخامس قال بأصله ابن جرير في تفسيره ورجّحه، وهو أجمع الأقوال.
عبد العزيز بن داخل المطيري
أمثلة من أقوال المفسّرين في بيان المراد ببعض المفردات القرآنية
قال محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم: (هو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره، ولا معارضة لخبره. المثال الثاني: المراد بالأمانة في قول الله تعالى: {إِنَّا
عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)} المثال الثالث: المراد بالشاهد والمشهود في قول الله تعالى: {وشاهدٍ ومشهود}
فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله، ولا يفعل إلا ما أمره
الله؛ فالله وحده غايته، وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة
تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمرّ عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا
قرار لها فيه، ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه.
ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك، وسليم من البدع، وسليم من
الغيّ، وسليم من الباطل، وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره؛ فذلك يتضمنها.
وحقيقته أنه القلب الذي قد سَلِمَ لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا
ورجاء؛ ففنيَ بحبّه عن حب ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء
ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقاً وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضائه
وقدره؛ فلم يتّهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره؛ فأسلم لربه انقيادا
وخضوعا وذلا وعبودية، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده
ظاهرا وباطنا من مشاركة رسوله، وعرض ما جاء من سواها عليه؛ فما وافقها
قبله، وما خالفها رده، وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره
وأرجأه الى أن يتبين له.
وسالم أولياءَه وحزبه المفلحين، الذابّين عن دينه وسنة نبيه،
القائمين بها، وعادى أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما
الداعين الى خلافهما).
قال: يا رب، وما فيها؟
قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} .
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، الأمانة: الفرائض،
عرضها الله على السموات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم. وإن ضيعوها
عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا
بها، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} يعني: غرا بأمر الله.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها} قال: عرضت
على آدم فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك، وإن عصيت عذبتك. قال:
قبلت، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم، حتى أصاب
الخطيئة.
وقد روى الضحاك، عن ابن عباس، قريبا من هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه، والله أعلم.
وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن البصري، وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض.
وقال آخرون: هي الطاعة.
وقال الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.
وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود.
وقال بعضهم: الغسل من الجنابة.
وقال مالك، عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة، والصوم، والاغتسال من الجنابة.
وكل
هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف،
وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها
عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفق الله، وبالله
المستعان)ا.هـ.
- قال محمد بن صالح العثيمين: ({وشاهد ومشهود} ذكر علماء التفسير في الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود.
والشهود كثيرون:
منهم: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيداً علينا، كما قال الله تعالى: {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً}
ومنهم: هذه الأمة شهداء على الناس {وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.
وأعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر كما قال تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
ومنهم: الملائكة يشهدون يوم القيامة، فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله {وشاهد} وأما {المشهود} فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة كما قال تعالى: {ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود}
فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود).
عبد العزيز بن داخل المطيري
التطبيقات
بيّن المراد بالمفردات التاليات:
(1) المحروم في قول الله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم}
(2) الباقيات الصالحات
(3) ناشئة الليل
(4) الحبل في قول الله تعالى: {إلا بحبل من الله وحبل من الناس}
(5) السيما في قول الله تعالى: {سيماههم في وجوههم}